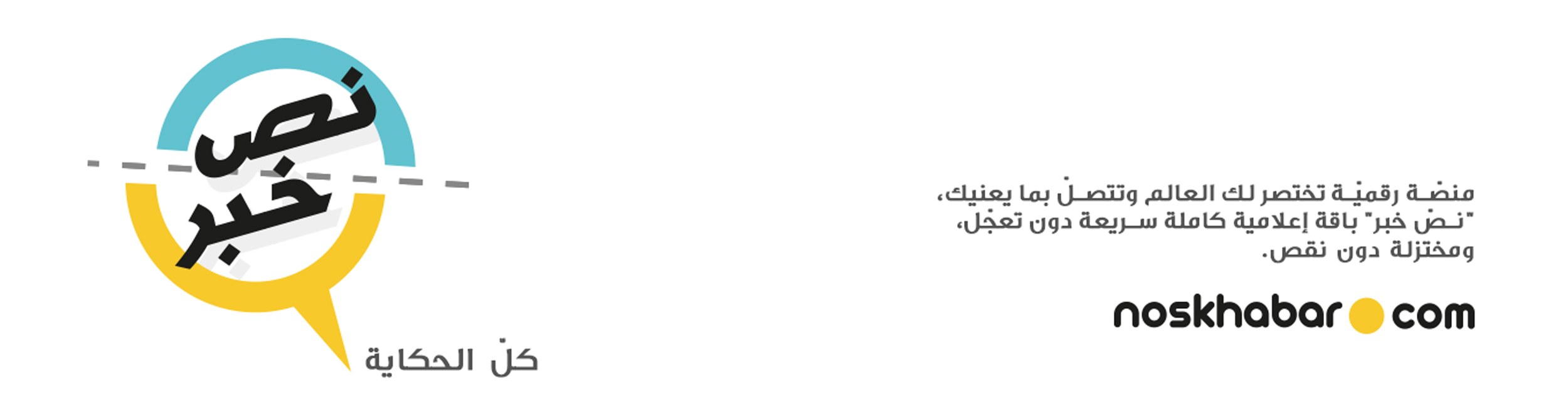شحاتة العريان – كاتب وروائي مصري
جامع “ابن طولون” تحفة حقيقية تتربع على قمة (قلعة الكبش) بالسيدة زينب وتتيح الحفاظ على كل هذا البراح المقدس منذ الدولة المصرية القديمة.. و”طرق الكباش” من متلازمات معابد آمون إله طيبة الذي صعد ليجاور في المكانة (رع) و(بتاح) و(حور) آلهة الدولة القديمة.. وقصة الذهب الذي بنى به أحمد بن طولون جامعه هذا تؤكد أنه كان خرائب أثر مصري قديم قيل إن فرسه تعثرت وعلقت ساقها بين حجرين به ونزل ليحرره فعثر على كنز ذهبي هائل كان خبيئة مصرية قديمة دون شك فقد كانوا يتداولون نقود الرومان والبيزنطيين والفرس في ذلك الوقت ولو أن اللقية الذهبية من أي منها لذكر المؤرخون ذلك وعددها وقيمتها غير أن ما وجده لا شك كان مشغولات وأقنعة وتيجان وحلي من نذور المعبد القديم الذي كان على الأرجح من معابد آمون -كون (خنوم) والذي يمثل (الكبش )أيضًا أيقونته لم يكن مشهورًا بالشمال كشهرته بالصعيد الأعلى ومقره بأسوان- بينما عمم رمسيس الثاني معابد (آمون/رع) بعد دمج الإلهية رب الشمال ورب الجنوب معًا في إله واحد أعظم ربًّا للأرباب هو (الظاهر/الخفي) أو (الظاهر الباطن) بالتعبيرات الفقهية ..
ويعتقد العامة -في رواية المقريزي- ببركة صلاة الجمعة فيه عن غيره من المساجد الجامعة كونه في اعتقادهم (بني بمال حلال) كنز عثروا عليه ومال غير مسلوب من الناس ولا فرض عليهم الحكام بسببه جبايات او اختطفهم الجنود من الطريق للعمل سخرة لإتمامه كما كانت تجري الأمور لبناء مساجد الولاة والخلفاء والسلاطين..
ولعله أقدم ما تبقى من معابد المسلمين كافة في كل الارض قائمًا على حال بنائه الأصلي منذ 1200 عام لم تزد عليه فيها سوى إضافات وزيادات للتوسعة أضيفت خارج جدرانه فلم تهدم لأجلها أيٌّ من أروقته أو معالمه الأصلية وأقام الظاهر بيبرس بباحة صحنه الميضأة التي بالصورة فيما كانت تلك المنارة (القرطاسية) أولى مآذن معابد المسلمين قاطبة على الإطلاق وأنشئت على غير أمثلة سبقتها لمنارات للمساجد وهي ملاصقة لجداره الغربي ابتدعها لابن طولون المعماريون الأقباط على غرار أبراج أجراس كنائسهم مع الاعتبار اللازم لمراعاة صعود وهبوط المؤذن خمس مرات كل يوم لم يكونوا يتحسبون لها في أبراجهم ، فالجرس عندهم يؤدي وظيفة المؤذنين، وشد الحبل ليدق عند اللزوم لا يحتاج صعود أو هبوط أحد .. وألفت القصص العديدة وتناقلها المؤرخون عن أصول تلك المئذنة وأن ابن طولون كان في مجلسه بيده صفحة من ورق وسرح بفكره فصاغتها يده قرطاسا ولكونه لا يحب أن ينقل عنه ما يدل على اللهو أو اللعب فحين انتبه ووجد بيده القرطاس والمحيطون به يحدقون مندهشين قال لهم أن كان يفكر في شكل لمنارة جامعه ويريدها بهذا الشكل وأعطى القرطاس لمهندس ضمن حاشيته لينفذ منارة على هيئته .. تلك قصة وقصص أخرى أقل معقولية.
تتحدث مطوية سومرية أو بابلية شاهدها بالعراق وتذكرها بمصر وكلها روايات مطعونة بمخالفة قواعد بديهية تنسبها لشواهد لا وجود لها وتشبهها بما فيما بين النهرين وما في سمراء متجاهلة للشبه الهائل بينها وبين أبراج كنائس ماري جرجس في حصن بابليون على بعد عدة مئات من الخطوات جنوب الجامع أو ابراج كنائس المطرية وعين شمس وأون بعده بعشرات قليلة من مئات الخطوات كذلك.
وأيضا استخدم بنّاؤه مواد البناء من الطوب المحروق والملاط من “القصرمل” الذي ينتج من احتراق المحروقات بالمستوقدات التي تدفئ مياه الحمامات العمومية وتدمس الفول المدمس وتتخلص من الزبالة والمهملت وتنتج مادة شديدة النعومة كالإسمنت يضاف إليها الجبس والجير وبعض العناصر لتكون ملاطا يقاوم الزمن ..
ولعله كذلك أقدم المباني المصرية (بالطوب الأحمر ) أو (اللبن المحروق) وبنيت بالطوب أعمدته القائمة للآن
وكان المصريون القدماء -وحتى ملوكهم- يرفضون حرق الطين سوى للفخار والفخارين اللذين أذن لهم (خنوم) رب أسوان بذلك التكريم وحدهم فقط.. ويتشآمون كذلك من الإقامة في جدران ثقيلة كجدران المقابر ولا يرتاحون لغير الحياة في جدان (حية) من الطوب الاخضر اللبن التي تحيلها زخات المطر الخفيفة لسطوح معشبة أحيانًا.
وقد يكون في ذلك المعتقد التليد السر في ألا تصلنا أية مساكن أو قصور خاصة بالفراعين أو الأعيان من مصر القديمة!! فيما وصلتنا مقابرهم وجثامينهم ..
فلم يكن يبنى بالحجر شيء بخلاف معابد الآلهة والمقابر والتحصينات الحكومية كجسور النيل وسدوده والابنية الادارية المستديمة كالمحاكم والحبوس ومقارات الحراسة وثكنات الجند الدائمة أما بيوتهم كبارا وصغار فبيوت ريفية كبيوت الفلاحين التي أدركناها تلائم تقلبات المناخ عندنا وتؤول حين يفنى سكانها وتخرب لمصير كنه بداية جديدة فتأكل الارض البيت الخاوي ويعود ارضا تُزرع من جديد .. فلم نر اي بيت مصري قديم يخص عائلة ولا شخص !! بخلاف بيت واحد هو البيت الاعلى الذي بناه الفرعون مينا عقب توحيد الوجهين بأحجار (الجدار الأبيض) الذي كان هو خط الحدود بين مملكتي الشمال والجنوب وبني على نفس موضع الجدار ليكون مقرا دائما للحكم لا يعطى لقب حاكم مصر لسوى لمن سكنه وحاز مفتاحة وظل كذلك حتى نهاية عصر البطالمة بعد ثلاثة آلاف عام من بنائه.. وعلى نحو رمزي ادت كليوباترا السابعة -اخر من حكم مصر طبقا للتقاليد المصرية- تلك الرحلة لمنف وحصلت على مفتاح البيت ودارت حول بقايا الجدر الابيض من الجهتين لتأكيد حيازتها لرتبة الحاكم ولتسبق اخيها المنافس لها.
ومن اسمه الـ(بر_اون) جاءت كلمة (فرعون) التي أطلقها الأجانب -ومنهم (اليهود العبرانيين) على كل الحكام المصريين ومنهم انتقلت تسمية مقر الحكم لتكون ذاتها اسم الحاكم الذي لا يعلم اسمه الغرباء فصار كل حكامنا هم (فرعون) واحد خالد ممتد لا ينتهي أبدًا بل ويطاول في رواياتهم الإله الاعظم رب العالمين (أي الوجهين)
ولم تنهب لأجل جامع ابن طولون أية أعمدة أو حليات وأعتاب وأفاريز من أبنية اخرى فرعونية أو بطلمية وهلّينية مما في محيط القاهرة كما اعتاد حكام ذلك الزمن -وغيره من ازمان- ان يهدموا الاثار لإقامة منشآت تخّلد أسمائهم.. ولكن افهام الناس منشئة الحقوق هي من حفظت لابن طولون تلك الكرامة وواصلوا عمارة جامعه بمدوامة الصلاة به واستحبابه ..
يقول المقريزي إنه الجامع الوحيد بمصر الذي لم تنقطع صلاة الجمعة به أبدا ولا أوقفت في أي زمن منذ بنائه حتى زمن المقريزي في القرن الثامن الهجري أي لقرابة الستة قرون ولم نعلم أن الصلاة أوقفت به بعد ذلك.
على العكس من جامع “عمروبن العاص” الذي ارتد بخراب الفسطاط خرابا وساحة لألعاب الحواة وسكنا للقرداتية! والبناء الحالي له نُهبت أعمدته من خرائب منف وسقارة وعين شمس ولم يَعد المصريين لاقامة الصلاة منذ أيام الأمويين سوى في بدايات القرن العشرين عقب إقامة على مبارك بنائه.. ولاستعماله لقرون طويلة باحة العاب وسكن حواة وغجر وحلب ونوّر ودخول أجزاء منه في نطاق قرافة المسلمين المجاورة له.. وامتداد القبور والشواهد حتى صحن الجامع الحالي فتخلف عنها ضريح مقبب لولي من الأولياء موجود حاليا يقع خلف منبر الجامع تماما !! وكانت تقام له ليلة مولد بالمراجيح والمنشدين والغوازي والحشيش والاذكار والتواشيح حتى وقت قريب.
ومنذ السبعينات دأب الاخوان على صلاة الجمعة به كمعقل تجمع لهم وإعلان تواجد ويشيعون استحباب الصلاة به بدعاوى ضمنها أنه: (مسجد لا قبر فيه) والقبر في القبلة خلف منبر الخطيب!