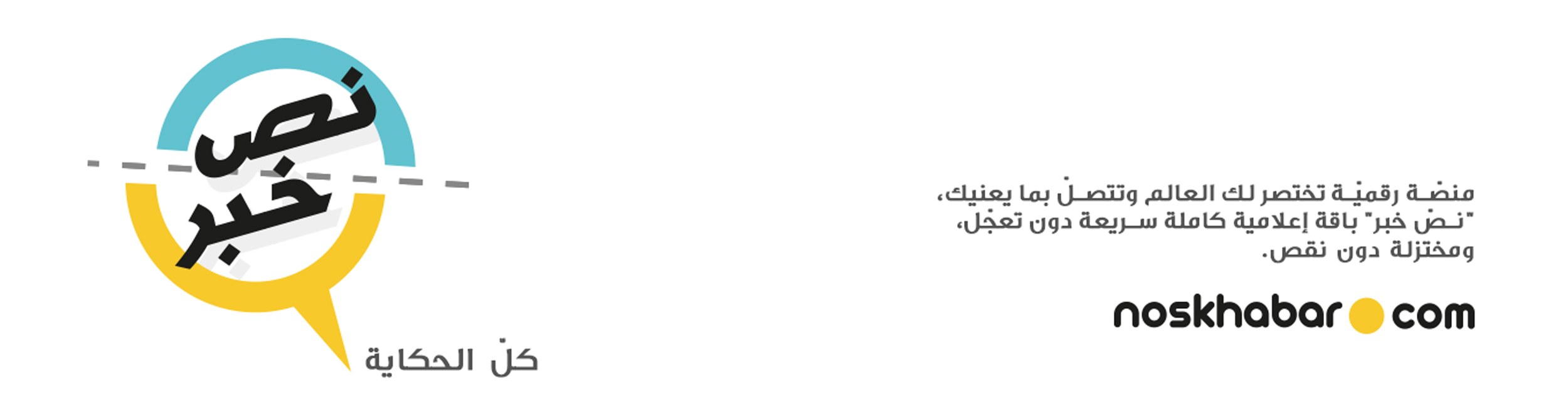5 أغسطس 2023
حاوره: هاني نديم
عرفت سفيان رجب من الشعر، من ديوانه الجميل “ساعي بريد الهواء”، لأقراه مجدداً قاصاً وروائياً. وفي كل ما كتب كان سفياناً مختلفاً عن الآخر، محققاَ شروط الفن الذي يكتب به، مقدماً ما يثير الدهشة والإعجاب على الدوام.
كتب العديد من الروايات والمجموعات القصصية التي أشاد بها النقاد، مثل رواية “مصنع الأحذية الأمريكية” ورواية “قارئة نهج الدباغين” وغيرها. في روايته “اليوم الجمعة وغداً الخميس”، يفتح سفيان ملفات يهود سوسة، بجرأة ووعي وضمن سردية هائلة، حيث تشتبك الرواية والتاريخ والوثيقة والخيال في مزيج بديع. كذلك في مجموعته القصصية “أهل الكتاب الأحمر”، تنقل بين مجموعة من الحوادث والقصص بأصوات مختلفة وبكل اقتدار. إنه كاتب حقيقي وجاد وأحد الأصوات البارزة اليوم في القصة والرواية. حاز على العديد من الجوائز وترشح للعديد منها أيضاً. سألته:
- أبدأ من أهل الكتاب الأحمر، المجموعة القصصيّة التي نالت التقدير الكبير عربيّا، ما هي كواليس هذا الكتاب بالذّات، وهل وطأ ما جاء بعده من كتب. هل تفصل بين أعمالك فنّيّا وزمنيّا؟
– أنت تشير إلى أكثر الكتب المعبّرة عن تجربتي الأدبيّة، الكتاب الذي كتبته في سنّ الأربعين، كنت أيّامها في عزلتي في بيتي الرّيفيّ، وبدأتُ أكتب رسالة إلى كارل يونغ، بعد قراءتي لكتابه “الكتاب الأحمر”، وقد كانت تلك المرّة الثالثة التي أعيد فيها قراءة ذلك الكتاب العظيم. وكانت الرّسالة على شكل قصص قصيرة مترابطة، ثمّ تجاوز العمل فكرة الرّسالة إلى كارل يونغ، ليكون محاكمة للآلهة وجرّهم إلى عيادة يونغ لمعالجتهم نفسيّا. لا أخفي عليك أنّ هذا الكتاب أثّر كثيرا على الكتابين الذين كتبتهما بعده، وهما كتاب “ماذا تفعل أنجلينا جولي في بيتي؟”، وكتاب “اليوم جمعة وغدا خميس”، لكن لكلّ كتاب منهما خصوصيّته وفرادته، فالكتاب الأوّل جاء في قالب متتالية قصصيّة، أو رواية مفكّكة، أتحدّث فيه عن رجل مريض يتوهّم أنّه يعيش مع أنجلينا جولي، وهذا النّصّ يحاول مسك الخيط الفاصل بين الواقع والخيال في حياة الإنسان، ويحاول تفكيك نفسيّة إنسان مسجون في مؤسّسة اجتماعيّة اسمها الزّواج.

أمّا الكتاب الثاني فقد جاء في قالب رواية طويلة نسبيّا، تتحدّث عن آخر اليهود في مدينة سوسة التونسيّة، بعيدا عن التجاذبات الأديولوجيّة، تركّز الرواية على فتاة تونسيّة يهوديّة، درست المسرح في باريس، تحاول تحرير عائلتها المتديّنة من إرث اللّاهوت. فالنّصان لا يبتعدان عن روح “أهل الكتاب الأحمر”، كما لا يبتعد هذا النّصّ عن النّصوص التي كُتبت قبله، وخاصّة السرديّة منها، وأقصد “القرد اللّيبرالي” و”الساعة الأخيرة” و”مصنع الأحذية الأمريكيّة”، وهذا النصّ الأخير نُشر بعد سنتين من أهل الكتاب الأحمر، رغم أنّه يسبقه في تاريخ كتابته. حين أرفع رأسي الآن، وأنظر إلى ركام النّصوص التي كتبتها منذ عشرين سنة تقريبا، والتي نشر منها إلى حدّ الآن اثنا عشر كتابا، ولا تزال بعض الكتب معلّقة بعقود نشر تكاد تنتهي آجال بعضها دون أن تخرج تلك الأعمال من أقبية دور النشر، وبعض النصوص الأخرى التي لا تزال قيد الاشتغال، أُشفق على هذا الجسد المرهق الذي أفنى عمره في الكتابة، وفي الآن ذاته أغبطه على حياته بين الأفكار وأطياف الفلاسفة والشعراء والروائيين.
في المشهد الثقافي التونسي الأصوات الحرّة تقاوم وسط عاصفة النشاز والأبواق
- المشهد الثقافي التونسي اليوم يشهد اضطرابات وتكتّلات أكثر من غيره، لعلّي أكون مخطئا، كيف تصف المشهد اليوم؟
– لا لست مخطئا، هذا هو الوصف المناسب للمشهد الثقافي في تونس، سأتحدّث عن المشهد الأدبي تحديدا، والذي أعرفه جيّدا، وأتابعه يوميّا، من خلال ما يُنشر من نصوص ومقالات، ومن خلال متابعتي لبعض الملتقيات الأدبيّة، رغم أنّها أصبحت نادرة جدّا. في بداية هذه الألفيّة كانت توجد بوادر نهضة أدبيّة، ويوجد تنوّع وثراء إبداعي يعد بمشهد أدبيّ ثريّ، لكن نرجسيّة بعض الكتّاب الماسكين بالمنابر الثقافية أفسدت كلّ شيء، وخنقت الكثير من الأصوات المتميّزة، وفُسح المجال للأبواق التي تردّد نصوص تلك الآلهة، وتُعلي أسماءها. فسكتت بعض الأصوات المتميّزة، وتشوّه البعض الآخر منها، وظلّت بعض الأصوات الحرّة تقاوم وسط عاصفة النشاز والأبواق، حتّى وصلنا الآن إلى مشهد ممسوخ، وباستيلاء المدرّسين الجامعيين عليه انتهى كلّ شيء تقريبا، لم يبق من ضوء المشهد الأدبي في تونس سوى بعض النّصوص المارقة التي تُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتُنقل في المنصّات الإلكترونيّة الجادّة، وبعض الكتب المتميّزة التي يحتفي بها القرّاء.

- بعيدا عن الأدب قريبا منك، كيف يعيش سفيان رجب؟ ما هي مباهجه ومسرّاته؟ وما يسعده ويحزنه؟
– لن تكون بعيداً عن الأدب، إن حدّثتك عن حياتي الخاصّة. فأنا أعيش بين الكتب والأفكار ومجادلة أطياف الفلاسفة والشعراء والروائيين.. أعيش في بيتي الريفيّ، الذي شيّدته بنفسي، وسيّجته بأشجار الزيتون واللوز والليمون، وحفرت له طريقا في أرض قاسية تكسوها الحجارة الحمراء. أتمتّع بعزلتي، وبالتسكّع في مسارب الشوك في الليالي المقمرة، وأتحدّث مع الخنازير البريّة ومع الطيور الرماديّة الجارحة التي تبني أعشاشها في أشجار الشوك، أمشي طويلا بين الهضاب وأحدّث نفسي، وأضع مخطّطات كتبي الجديدة، وحين تجهز تلك المخطّطات، أنكبّ على العمل عليها بطاقة جبّارة، لا أزال أمتلك داخلي طاقة العدّاء الريفي في الجيش التونسي، لقد كنت عدّاء متميزا، وأمتلك روحا جبّارة، كما يقول لي المدرّبون الذين أشرفوا على تدريبي. بتلك الرّوح أكتب الآن. قد تتصوّر صديقي الشاعر أنّني أكتب الآن نصّا أدبيّا، لكن الحقيقة أنّني أنقل لك حياتي اليوميّة.

ما يحزنني وما يفرحني؟ هذا هو الجزء الصعب من سؤالك، كرّرت السؤال على نفسي أكثر من مرّة: ما يحزنني وما يفرحني؟ أنا الكائن الغامض الذي لا يحضر جنائز أو أعراس منذ زمن بعيد. وكنت كلّما حضرت جنازة أخاف أن أضحك، وإن حضرت عرسا أخاف أن أبكي. ربّما يسعدني نصّ عظيم، أعيد قراءته مرّات كثيرة، لكن المشاعر التي يبثّها فيّ تتداخل بين الفرح والحزن. تزوّجت وطلّقتُ بعد شهرين، تلك المرأة المسكينة لم تطق الحياة مع رجل صامت ومُضجر، ورأفة بها وبنفسي طلّقتها، حاولت مرّة أخرى بناء أسرة، وبكثير من الكوميديا اجتزت بعض الحواجز، وخسرت الكثير منّي في مشروع مجانيّ. أصبحت الآن مسكونا بهذا السؤال القاسي: متى ينتهي هذا العبث؟