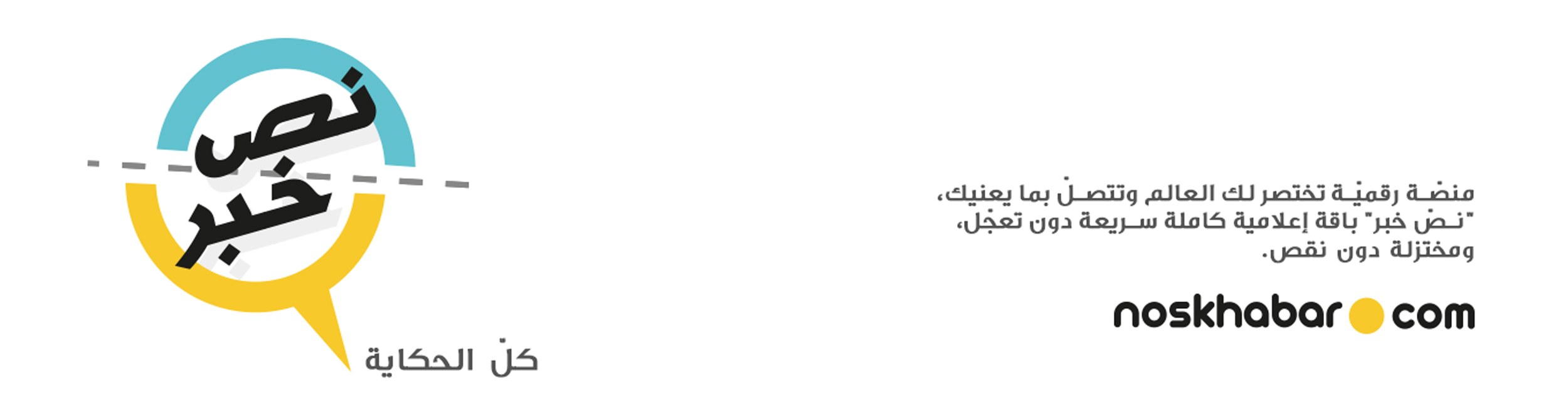ضيف حمزة ضيف: يا رجل؛ الرأسمالية حولت رسم كوردا للثائر الأممي تشي غيفارا إلى ماركة تجاريّة!
17 مايو 2023
حاوره: هاني نديم
ضيف حمزة ضيف، هذا الاسم اللامع في عالم الكتابة والصحافة والمشهد الثقافي العربي. يساري من الطراز الرفيع وحقوقي أكاديمي في علوم القانون الدولية. كان لا بد لي أن أسأله عن اليسار واليمين وما بينهما، عن الصحافة اليوم والعالم الجديد. سألته:
* ماذا بقي من اليسار؟ ماذا ظل من العالم بتقسيماته القديمة اليوم في ظل أصبحت الشركات فيه أقوى من الدول؟
– في الواقع يعيش اليسار في كل العالم أزمات عدّة، لا تتراجع حتى تعاود المثول من جديد وبقوّة ساحرة أحياناً. لم تعد الشركات الكبرى التي صارت أقوى من الدول، وتمثل كيانات لوحدها خارج النطاقات الدولتيّة (الاعتماد القانوني للشركات داخل الدول غالباً ما يكون مشروطاً بنوع القانون المطبّق وأشكال الإجراءات والتصفيّات حالَ الإفلاس)، هي السبب الوحيد في إحداث أزمة بنيويّة في اليسار، ولكنّها وبكل تأكيد السبب الأكبر والامتحان الأشدّ قتامةً في قراءة العمر الافتراضي لأهليّة اليسار في مطاولة العصر ومواجهة إحدى أهم معضلاته وترسّباته.
دعني أقول جديداً في ظل انتشار متكرّر لقراءات وتصوّرات عدّة لأزمات اليسار في العالم، في جلّها عبارة عن تأبيّن مدبّج أو مرثيّات تخلو من عقلٍ متأثر؛ أقول عقل متأثر لأنّه في مُكنة العقل أن يتأثر وليس للقلب وحده أن يستولي على هذه الصفة، بيد أنّ القلب يتفجّع فيما العقل عندما يتأثر؛ يفكر. للإسلاميين تصوّر لطيف عن “مركز العقل”، فهم يعتقدون استناداً على الآية “لهم قلوب لا يعقلون بها” بأنّ القلب هو الذي يفكر عندما يتأثر والعقل هو الذي يتأوّه عندما يفشل القلب في حسم الخيارات المستحيلة المطروحة أمامه. يبدو هذا التصوّر ملفتاً لا يخلو من ظُرف ومساعداً على رؤية أخرى من خارج المسار الاعتيادي لمرور الأشياء وتطوّرها عندنا.
هذا العقل المتأثر والقلب المُفكر يدفعنا للبحث عن أنّ المشكلة في اليسار ليست في مقاصده وأهدافه فحسب، بل في شخوصه وأدواته أيضاً. لقد استعارت الرأسماليّة الجديدة التي جاءت وئيداً بعد الأزمة الماليّة 2008 شيئاً من المبادئ العريضة لليسار، وسلكت طريقها نحو مراجعات شتّى، فيما لم ينتبه اليسار إلى أنّها تستخلص منهُ أسباباً كثيرة، قامَ هو نفسه (اليسار) عليها، وحوّلها تبعاً لأخطاء الممارسة إلى حيزٍ سائل لا تستقيم لها واقعة؛ أهمّها العدالة الاجتماعيّة. أجرت هذه الرأسماليّة الجديدة تعديلاً ليبرالياً على عدالة اليسار، فـ “شفطت” تلك العدالة إلى أعلى مثلما فتحت للشركات الكبرى نوعاً من الماركسيّة القسريّة. ّ
كيف ذلك؟
يعتقد كارل ماركس بأنّ الأجور يجب أن تتناسب مع القيمة والجهد، وفي حال لم يتناسبا معاً يحدث شكلٌ مريع من الاغتراب، يدفع العامل نحو الانتقام من وسائل الانتاج بدلاً من القيام بثورة ضد الدوافع المؤدّية بالضرورة. أخذت الشركات الكبرى (الشخصيّات المعنويّة كما تسمّى في القانون) مبدأ الأجور المرتفعة بحسب الأرباح المتوقّعة، فيما جمدتْ الدول ككيانات دستوريّة عند مقايضة العامل بالتثبيت مقابل الأجر الزهيد، على عكس الشركات التي تمنح لربّ العمل سلطة أوسع في الفصل (غالباً ما يكون تعسفياً) والترقيّة بحسب السلطة التقديريّة وثمار الاجتهاد الشخصي.
لا أدري بالضبط ما الذي يدفع عالم اقتصاد بحجم بول كروغمان (نوبل: 2008) في كتابه (The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008) إلى اعتبار كتاب رأس المال بعد الأزمة العالميّة الأخيرة كتاباً خطيراً، هل هي صدمة الأزمة الماليّة التي هزّت أركان العالم في 2008 أمّ أنّها تأثيرات التضامن العقاري الذي حدثَ في أزمة العقارات في فلوريدا في الثمانينات عندما حمت واشنطن فلوريدا بمنحها ديوناً بدون ضمانات قويّة!
يختلف ماركس مع اليساريين الذين جاؤوا من بعده حول فكرة الانتقال في حدّ ذاتها، فهي يعتقد في كتابه/ الوثيقة نقد برنامج غوته بأنّ الانتقال السياسي في انجلترا والولايات المتحدة ينبغي أن يكون سلمياً تماماً. وأنّ مهمة البروليتاريا تحطيم “آلة الدولة البرجوازيّة” بتؤدة بناءً على ما لاحظه رفقة انجلز في الفترة الممتدّة من 1852 إلى 1891، أيّ خلال الأربعين سنة الفاصلة بين التاريخين المذكورين، واعتبرا أنّ فيها كفاية لتوجيه نوعٍ من النقد لأفكار الانتقال العنيفة، ناهيك عن تجربة ثورات 1848 (ربيع الشعوب) حتى ثورة 1871(توحيد ألمانيا بفضل رجل الدولة الاستثنائي أتو فون بسمارك).
مع ذلك، يحب الشيوعيون بوصفهم “ورثة” غير وحيدين لتراث ماركس الاتّجاه إلى أفكار العنف الثوري أو على الأقل لا يرون غضاضة في صرف النظر عن الوسائل طالما تؤدّي إلى مقاصد نبيلة! يثبت التاريخ دوماً بأنّ للوسائل دوراً كبيراً في حرّف الأهداف الساميّة، وأحياناً ترث الغاية جزءاً من أخطاء الوسيلة، وقد تتحوّل الموانع السابقة إلى تصحيحات لاحقة.
لكارل ماركس في نفس الوثيقة (نقد برنامج غوته) تصوّر ملفت: فهو يعتبر بأنّ هنالك مرحلة تقع بين تحوّل المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الشيوعي، هذه المرحلة تتناسبُ طردياً مع فترة قد تكون الدولة فيها متمظهرة في شكل ديكتاتوريّة ثوريّة ضد البروليتاريا. قد يُفهم هذا الرأي بأنّ ماركس يؤيّد الديكتاتوريّة كخيار انتقالي تمارسه الدولة ضد البروليتاريا كما فهم كاوتسكي ذلك بخفة جعلهُ محطّ نقدٍ عنيف من طرف لينين في كتابه الثورة البروليتاريّة والمرتد كاوتسكي (وقع اليساريون العرب في خطأ كاوتسكي من دون قصد (ربما)، فأيّدوا الأنظمة الاستبداديّة من دون تبرير انتقالي، وفقاً لمقايضة غير اختياريّة بين السيّء والأسوأ).
كلّا، ليس هذا قصد ماركس. كان كارل ماركس حاسماً في اعتبار مهمة البروليتاريا هي تحطيم الآلة البرجوازيّة، ويسبّب تلك المهمة بتشنيع الديكتاتوريّة بوصفها آلة برجوازيّة كما سبق الحديث.
يعتقد كارل ماركس بأنّ الأجور يجب أن تتناسب مع القيمة والجهد، وفي حال لم يتناسبا معاً يحدث شكلٌ مريع من الاغتراب، يدفع العامل نحو الانتقام من وسائل الانتاج
تجاوزت الرأسماليّة حين منحت الشركات الكبرى امتيازات اقتصاديّة واسعة مقابل فرض ضرائب كبرى، لكن كان ضمور الدولة مقابل ضخامة هذه الشركات واضحاً وبيّناً، قياساً بالأٍرباح الطائلة التي تحقّقها وضآلة الضرائب المفروضة عليها، علاوةً على تجاوز هذه الشركات بلدانها، وتحوّلها إلى شركات عابرة للقارات.
من نهاية الثمانينات إلى أواسط التسعينات، كان العالم برمته أمام تحوّلات ضخمة. كان المخاض عسيراً وحاسماً ومكلّفاً أيضاً، خذ مثلاً ما كانت تحتكره الشقيقات السبع وهي شركات ضخّمة متخصصة في الطاقة قبل أن تنضمّ إليها شركات أخرى لاحقاً، الشركات السبع وقتذاك في جلّها أميركيّة (خمسة أميركيّة والسادسة (SHELL) هولنديّة/ بريطانيّة والسابعة بريتش بتروليوم (BP) بريطانيّة، ثم انضمت لهم الشركة الفرنسيّة (CFP) قبل يتحوّل اسمها إلى توتال)، كانت وقتذاك تحتكر ما نسبته 80 في المئة من النفط العالمي، وتسيطر على 70 في المئة من التكرير وتمتلك 50 في المئة من ناقلات النفط، ومع ذلك يصرّ العرب على اعتبار ذلك الزمن زمناً جميلاً. أؤيّد ماركس في اعتبار أيّ صراعٍ يحدثُ مهما كان نوعهُ يخفي صراعاً طبقياً قائماً على سيطرة طبقة (أو طموح في السيطرة) على أخرى، ويمكن سحب ذلك على الدول أيضاً، أليست الدول في القانون الدولي العام اسمها أشخاص القانون الدولي!
دعنا نكون أكثر وضوحاً في وضع اليسار أمام معضلة الشركات المتعدّدة الجنسيّات، فنقول الحقيقة التاليّة: حالياً تسيطر هذه الشركات على 80 في المئة من إجمالي مبيّعات العالم. يا رجل لقد حوّلوا رسم ألبرتو كوردا للثائر الأممي تشي غيفارا إلى ماركة تجاريّة عالميّة! هذه الشركات مستعدّة لتسويق ما تحب أنت وتكره هي من أجل الربح طالما لا يتعارض مع مصالحها الحيويّة في بلدك. يصل عدد هذه الشركات إلى 65 ألف شركة، تتبعها بشكل ذيليّ ومصيريّ حوالي مليون شركة! في الثمانينات كانت تصرّح بأرباحها التي تبلغ من دون احتساب غير المصرّح به: كل دولار يأتي بدولارين ونصف. الآن لم تعد هنالك إحصائيّات معلنة لأرباحها الفلكيّة.
ربما حان الوقت لليسار أنّ يعيّ بأنّ تطوير خطابه لا يكون إلا بالتركيز على الشأن الاقتصادي بدلاً عن الانخراط طويلاً في الشأن الاجتماعي. كما يجب أنّ يعيّ بأنّ هنالك فرّق بين رجال الأعمال (محطّ نقدهم) والاقتصاد الوطني والدولي (محلّ النقد وموضوعه الأساس) كما هنالك فرق بين الشركات المتعدّدة الجنسيّات التي تسيطر على مداخل المال ومخارجه وبين القطاع الخاص داخل الدول. إنّ الرأسماليّة في الزمن الحالي هي رأسماليّة الدول. أما رأسماليّة الأفراد ففي الغالب الأعمّ سلطة متنفّذين يمكن السيطرة عليهم بمحايثة القوانين (تعديلها) وتحيينها وتحقيق حكم ديمقراطي يضمن شفافيّة القضاء وسلطته في المتابعة.. وهي المكاسب التي وإنْ تحقّقت داخلياً، ربما من الصعب عليها أن تقاوم هذا الزحف المالي الاحتكاري الخارجي إلا بتحالف دول من أجل تحقيق استقلاها الوطني، بشرط أن تحقّق ديمقراطيّتها الداخليّة. لا تنميّة بلا ديمقراطيّة مهما كانت هذه التنميّة جيّدة ومريحة، فإنّها في النهاية إذا لم تكن مشفوعة بالديمقراطيّة تحوّل الأفراد إلى استهلاكييّن يمكن شراء ذممهم بالمال وتحويلهم إلى وسائل بدلاً من اعتبارهم غايات بحدّ ذاتها، وهذا تماماً عمل هذه الشركات بطبعة مزيدة ومنقّحة فقط.
يجب نعرف التالي؟
المأزق مع هذه الشركات التي باتت تملي سياساتها على الدول، هو قانوني وليس إيديولوجي بالضرورة. لقد قامت بعض المنظمات الإقليميّة الدوليّة بوضع قواعد قانونيّة للحدّ من تفلّت السلوك الاقتصادي لهذه الشركات، ولعل أهم “محاولة” وضعتها مجموعة دول الأنديز (CAN) اللاتينيّة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدوليّة (لاحظ المفارقة: أنشئت منظمة العمل الدوليّة قبل الأمم المتحدة بـ 26 عاماً بغرض الدفاع عن العمّال بينما أنشئت الأمم المتحدة للحدّ من الحروب وتكريس احترام القانون، الدلالة أنّ حقوق العمال كانت سابقة عن الحق في الأمن. يذكّر ذلك بشكل طريف بأحقيّة المثل المحلي بدلالة هذا السند التاريخي الدولي القوي: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق). فضلاً عن القيود القانونيّة التي وضعها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميّة..إلخ.
لكن جلّ ما سبق أو قلّ كلّ ما سبق ولا تخشَ العواذل والنوازل لا يتعدّى في كل أوجهه: توصيّات سلوكيّة غير ملزمة! حتى الاتفاق الدولي المتعلّق بالاستثمارات في مفاوضات 1997 بقي كل حياته مجرد حبر على ورق. يذكّر هذا بنكتة سمجة، أقصّها عليك بعد أن ينام القرّاء.
* هل المقاومة حكرٌ على اليساريين في العالم؟ ألا يوجد محاولات لتحديث الخطاب الأحمر القديم؟
– بالتأكيد لا. لكن حتى الحركات الليبراليّة والإسلاميّة على حدّ سواء، بمجرد حديثها عن حيثيّات المقاومة وأسبابها وضروراتها تجد نفسها تتبنّى خطاباً يسارياً دون أن تشعر. دعني أقول لك بأنّ اليسار ليس ديناً إنّه الوريث الأكثر انفتاحاً وتصحيحاً للشيوعيّة والمحتوى الأكثر حدّيّة للاشتراكيّة وأحياناً الأكثر تجديداً. حتى الأحزاب الليبراليّة عندما تتحدّث عن احتياجاتها للعمّال كما هو الحال على سبيل المثال حزب الرئيس (بمعناه الأوروبي طبعاً) في فرنسا الجمهوريّة إلى الأمام، لا يختلف خطابها عن قيمة العمل (في مواجهة المظاهرات الرافضة لرفع سن التقاعد) عن كتلة فرنسا المتمرّدة اليساريّة المعارضة بقيادة جان لوك ميلانشون. قد يقول سائل نابه: إذا كنّا هكذا، لماذا نحن بحاجة إلى تقسيمات ايديولوجيّة تنتهي إلى تقسيمات مجتمعيّة؟ لا. هنالك اختلافات بنيويّة ليس في الخطاب وحده، يمكن أن نتبنّى خطاباً موحّداً نتفق عليه كلنا، طالما أنّ هذا الخطاب جاء كخلاصة لتراكم تجارب البشر وتتابع خبراتهم، لكن ثمّة اختلاف في وسائل التعبير والتغيير والممارسة لتجسيد هذا الخطاب. والوسيلة بتقديري لا تختلف البتة عن الغاية مثلما هنالك قيمة ماديّة ومعنويّة للأسلوب لا يختلف لناحيّة التأثير عن الهدف/ القصد.
حتى الحركات الليبراليّة والإسلاميّة على حدّ سواء، بمجرد حديثها عن حيثيّات المقاومة وأسبابها وضروراتها تجد نفسها تتبنّى خطاباً يسارياً دون أن تشعر
هنالك تقسيمات أراها مهمّة من الواجب معرفتها: ثمّة أخلاقٌ مطلقة جامعة يتّفق البشر حولها، مثل اعتبار الكذب منقصة والصدق مكرمة. الظلم مذمّة والعدل محمدة.. هذه عناوين عريضة للوجود وبفضلها استوى البشر واستتبّ العيش ولم يشوّه وجه الزمان. وهناك أخلاقٌ نسبيّة يمكن اعتبارها أخلاقٌ محليّة ناشئة عن اعتبارات تقليديّة جاءت من الفلكلور والعادات والتقاليد، لا يضيرها شيّء ما لم تتعارض مع الحقوق الإنسانيّة التي عبّرت عنها الأخلاق المطلقة.
هذان الفرقان للقيمة أراهما في غاية الأهميّة في إصلاح الخلل الناجم عن الخلافات حول الأسس المكوّنة للاجتماع البشري.
كذلك هنالك فرقٌ مهمّ ليس بدعاً من المعنى: وهو الفارق الجهير بين الموقف والمبدأ. المبدأ هو الأساس النموذجي للأخلاق المطلقة، فيما الموقف هو السبيل التعبيري عنه. لذلك يجب أن يكون الاختلاف المفضيّ إلى الحوار وربما إلى التشارك، حول الموقف المختلف عنهُ المنطلق من المبدأ المتّفق حوله.
لهذا أجد دوماً أنّ حوار الأديان على سبيل المثال (لاحظ أنّ الأخلاق المطلقة في الأديان واحدة وإن اختلفت في الأخلاق النسبيّة: الخيانة فعل مجرّم في كل الأديان/ الفلسفات في حين الإخلاص خصيصة محمودة، الاختلاف حول: نوعيّة العلاقات بين الأفراد التي تعتبر شرعيّة في مكان وغير شرعيّة في آخر..). في المقابل ما هو الحلّ لصراع أشخاص الدين مع أشخاص دين آخر؟
ببساطة أرضيّة قانونيّة سواءً كانت عرفيّة غير مدوّنة يصطلح عليه المجتمع وتتواتر على ممارستها مقتضيات العادة، أو مدوّنة في نصوصٍ رسميّة تقضي بعدم التعرّض وفهم الاختلاف البشري عن قصة الله.
لا أتصوّر أنّ الناس تختلف حول المقاومة، لكن هنالك من يختلف حول نوعها: سلميّة على نمط غاندي (Satyagraha) أو عنفيّة. وفي الغالب يبدو أنّ كلاهما بتلازم اليدين، لا يقوم توازنٌ منسجم إلا بوجودهما معاً.
دعنا نتفق أنّ الزمن الذي بدأ من سنة 1914 (الحرب العالميّة الأولى) وانتهى بـ 1991 (سقوط الاتحاد السوفيتي)، هو الزمن الأكثر حرجاً كما وصفه المؤرّخ الماركسي إريك هوبسباوم. وهو الزمن الطويل كما عدّه فيرنان بروديل، وفي الغالب ما نعيشه سياسياً لا يفهم إلا من خلاله.
وفي غضون هذا الزمن الطويل حدثت نكبة فلسطين وهي القصة التي لم تُحلّ إلى اليوم، وفيه صارت احتلالات تقليديّة تبعتها استقلالات ناقصة وغالباً مشوّهة، لكن الساخر فيها، أنّ من كانوا في المعارضة في السابق البعيد صاروا حكّاماً بعد ذلك، مارسوا ما مُورس عليهم ثم ثار الناس ضدهم وجاءوا بغيرهم لم يختلفوا عنهم (عندما سُجن جورج طرابيشي لفترة مؤقتة حين كان شاباً وجد المعارضين في المعتقل يفكرون بنفس عقليّة النظام! فرأى أنّ المشكلة في مكان آخر). هنالك نوعٌ من الملحميّة المعكوسة تشبه الإيتيهاسا (Itihasa) عند الهندوس، عندما تنقلب الأدوار وتبقى الممارسات نفسها والمخازي ذاتها.
عندما بدأت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في المقاومة.. لم يكن الإسلاميون قد حسموا أمرهم بعد. لكن هذا لا يعني احتكار اليسار للمقاومة بالتأكيد لا سيما أنّ نجاح المقاومة الإسلاميّة في لبنان مثلاً كان على أنقاض فشل المشروع اليساري المقاوم. أعتقد أنّ الأمر يشبه الأخلاق المطلقة التي حدّثتك عنها (فكرة رفض الظلم) تتبعها أخلاقٌ نسبيّة (الأيديولوجيّات المعبّرة عن مقاومة الظلم)، وهو أيضاً يشبه المبدأ (الحق في الحريّة) تختلف أوجه المواقف الساعيّة لهُ (وسائل التحرّر).
ثمّة أخطاء كبيرة حصلت ومراجعات صغرى كُتبت، وكذلك هجرات كبرى نحو نفس الأخطاء التي حدثت، وبراءات عجيبة من مراجعات لتجارب خلت.. الحديث عنها في الغالب الأعمّ يُوجع القلب أكثر ممّا يوقظ العقل. علاوةً على أنّنا ما دمنا على ما اصطلح عليها ابن خلدون بـ الولاء العصباني يبدو الحديث فيها غير نافع في بلادنا، هي منشورة على كل حال.
أما عن التجديد في الخطاب الأحمر؟
لنتكلم عن اليسار العربي بما أنّ اليسار العالمي قد مرّ بتجديد كبير، أوجزها لك في العناصر التاليّة:
أولاً: أوّل خطوة نحو تجديد الخطاب اليساري، هو اعتماد مراجعات صريحة للتجارب اليساريّة العربيّة وتجنّب الأخطاء ذاتها، وتلافي أيّ خطأ جديد، مراجعاتٌ جادّة على نحو ما كتبه منيف الرزّاز (التجربة المرّة) على سبيل المثال لا الحصر.
ثانياً: الانتقال من التركيز على المجتمع المدني إلى سياسة التمثيل الحزبي: كان هنالك كتابٌ مهمّ لرالف غوادمان عنوانه من الحرب إلى سياسة الأحزاب يمكن الاستعانة به في تأكيد قوّة وجود الحزب، رغم أنّ هنالك دراسات حديثة تحاول إثبات فشل الأحزاب وتدعو إلى ضرورة تأكيد الديمقراطيّات التشاركيّة وتقويّة دور المجتمع المدني. دعنا من التكاذب، منظمات المجتمع المدني في عمومها في بلادنا تخلو من التنظيم والحصانة، فهي إمّا مصبّ أموال مشبوهة من هنا وهناك، تمهيداً لتحويلها إلى أدوات ضغط، أو هي مجموعات متذرّرة تستعملها السلطات لتنتقم من الأحزاب المعارضة بحجّة انتهاء العصر الحزبي.
ثالثاً: ضرورة خروج الأحزاب من المناطق الحضريّة إلى القرى والمداشر، بحيث يكون المنطلق هو العمل ريفي/ مدني.
أنظر إلى أخطاءنا في العمل الحزبي: كان حزب البعث الذي أسسه ميشيل عفلق حزباً مدينياً ثمّ اعتمد على الأرياف، من خلال تقويّة وجود الطبقة الوسطى من الريف والمدينة في الحزب فكان أبرز المنتمين لهُ أبناء الطبقة البرجوازيّة/ والوسطى الريفيّة ممّن درسوا في المدينة، فكان هنالك طبقة مثقفة تشكّلت من المدرّسين والمعلمين والطلاب، وكان يقدّم طرحاً متفوّقاً عن الكتلة الوطنيّة السوريّة التي تحالف ضدها الاستعمار لاحقاً. كان هنالك اندماج ثقافي وسياسي ملفت. هنالك أيضاً الحزب العربي الاشتراكي وحركة الشباب وهما تشكيلان مدنيان مدينيّان بقواعد واسعة من العمّال والفلاحين (قواعدهُ فلاحيّة وقياداته متمدّنة)، وباندماج الجميع في بعضهما أسّسا حزب البعث (الكثير من الناس انتمى لحزب البعث وقتها لأنّهم لم يحبوا إلحاد الشيوعيين وكرهوا استحواذ الإخوان المسلمين على الإسلام، فوجدوا ضالتهم في البعث). أتصوّر أنّه التحالف العربي الناجح داخل الوطن الواحد الذي مثّل نجاحاً رائعاً لحوار المدينة والريف. على عكس ما حدث في مصر عندما انشقّ عن حزب الوفد الليبرالي (حزب الأعيان) حركة يمينيّة محافظة استعانت بلفظ الحريّة ولم تعمل بها، أقصد حركة الأحرار الدستوريين. هنالك أيضاً حزب الاستقلال الفلسطيني الذي لم يكتب له النجاح رغم أنّ مساهمات عوني الهادي وأكرم زعيتر ومحمد عزّة دروزة فيه كانت ملفتة.
كذلك هنالك أيضاً من التجارب المشرّفة: الحزب الوطني في العراق بقيادة كامل الجادرجي، كان نموذجياً في التأليف بين اليسار واليمين، قبل أن ينتهي إلى ما انتهى إليه من انقسامات مؤسفة.
هنالك أيضاً جبهة التحرير الوطني الجزائريّة (في طورها الجنيني)، التي انتقلت من التحرير أيّ النضال من أجل التخلص من الاستعمار، إلى الحكم والاستحواذ على السياسة برمتها في البلاد. في بداياتها كانت تجربتها ممتازة ثم انتهت إلى تحوّل الثورييّن إلى ثرويين (الأنقياء منهم اختاروا الظل)..
على العموم هنالك تجارب عربيّة كثيرة، لكن التجربة الأفضل والأكمل بالنسبة ليّ هي حزب البعث السوريّ قبل أن تتمّ عسكرته عندما انتقلت قياداته إلى ولاء ناصريّ غير محفوف بأيّ تحفظٍ يفرّق بين الخصوصيّة السوريّة والعموميّة المصريّة.
رابعاً: التخليّ (كأحزاب) عن منابذة الناس في عقائدهم لا يعني ذلك التنازل عن الحقّ في النقد والكتابة والمراجعة. دائماً ما كان يلفتني الحدث المؤسف الذي نالَ من ميشيل عفلق عندما أراد أن يغازل الإسلاميين حينما قدّم محاضرة في مدرّج الجامعة في دمشق في 5 نيسان/ أفريل 1943 تحت عنوان ذكرى الرسول العربي وحدث أنّه قدّم نقداً خفيفاً، ثارت ثائرة الكثير من الدمشقيين؛ كيف يتكلّم نصراني في الإسلام. كان ميشيل عفلق حالماً أكثر من اللزوم.
خامساً: التأكيد على العلمانيّة كإرث ثقافي عربي ضروري وليس مستورداً. في السجال التاريخي بين فرح أنطون الاشتراكي المتأثر بأرنست رينان ومحمد عبده، كان أنطون علمانياً مشرّفاً غير مصادمٍ لقناعات الناس. أقول دائماً إنّ العلمانيّة شأنٌ عام والإلحاد شأنٌ شخصي. على العموم موضوع العلمانيّة موضوع مطوّل جداً، لا يسع المقال لتلخصيه.
سادساً: تأكيد المساواة بين الجنسيين من دون تنازل لصالح المجتمع، والعمل على شرحه بهدوء ودون صدام أو نبذ.
سابعاً: التأكيد على حقّ الشعب الفلسطيني في التحرّر من الاحتلال من دون التهوين بقيمة هذه القضية المهمّة جداً.
ثامناً: اعتبار الديمقراطيّة حقّ أنساني بالدرجة الأولى قبل أن تكون أداة إجرائيّة للحكم.
تاسعاً: استحداث لجان تثقيفيّة حزبيّة والتركيز على قيمة الثقافة والمعرفة كأسلوب حياة في الحزب والمجتمع. كان راسل يقول “الحياة الجيدة تلك التي يلهمها الحب وتقودها المعرفة“.
عاشراً: الإيمان بأنّ اليسار موقف أخلاقي بالدرجة الأولى من الخطأ الفردي والجماعي وليس مذهباً سياسياً دوغمائياً عائماً أو ديانة جديدة.
* ما هو مشروع ضيف.. إلا تطمح وإلى أين تريد أن تصل؟
– الإجابة على سؤالك غاية في الصعوبة في تقديري. أؤمن كثيراً بإعجاز فيكتور هيغو التخييلي “يحتاج المرء إلى حياتين: واحدة يقرأ فيها فقط والثانية يؤلف فيها وحسب”. عندما أعاين الكتب الكثيرة في شتّى الفنون هنا وهناك، يساورني الظنّ الممزوج بنوعٍ من التمنّي العسير: هل يكفي العمر حقاً حتى نقرأ كل هذا؟ ونستمر في الحصول على متعٍ أكبر ودهشة أكثر؟ رغم أنّي أقرأ كل الوقت. غالباً ما أجيب حين يسألني الأصدقاء كم ساعة تقرأ؟ بالقول: الأصحّ: كم ساعة لا أقرأ. أقطع قراءاتي بالمشي أو الركض فقط. وأحياناً مجالسة بعض الأصدقاء، وهم قلّة على أيّ حال..
لديّ أربعة كتب إلى الآن، منذ فترة توقّفت عن مزاولة إكمال كتابين جديدين، أحدهما يحتاج كل الوقت يتناول مفهوم الهيمنة وأشكال المقاومة البشريّة والثاني يحتاج ذات الوقت أحاول فيه تطوير نظريّة قانونيّة جديدة في العلاقات الدوليّة، لكن توقّفت في المنتصف، بسبب شعوري باليأس وصعوبة استمرار حياتي بهذا العسر الماديّ الذي أعيشه. كنت ضحيّة الشلليّة المحبطة بين المحامين في بلدي. بعد ذلك انضممت إلى صيغة معيّنة تلتزم فيها الدولة بمنح حوالي 75 دولاراً ومن المزمع أن يتمّ طردي قريباً. لا أدري لماذا لا ترغب الدولة في توظيفي! علاقاتي الاجتماعيّة تتجّه لأن تكون صفراً كبيراً. لا علاقة ليّ بمحيطي تقريباً في ما عدا أنّني حيّ فيه.
أرغب في الهجرة كثيراً، ولا أدري كيف أصبحت متعذّرة عليّ فيما هي سهلة عند البعض.. ولكن كما تقول جديت بتلر “لا يمكنُ المقاومة من دون قدرة على الهشاشة“.