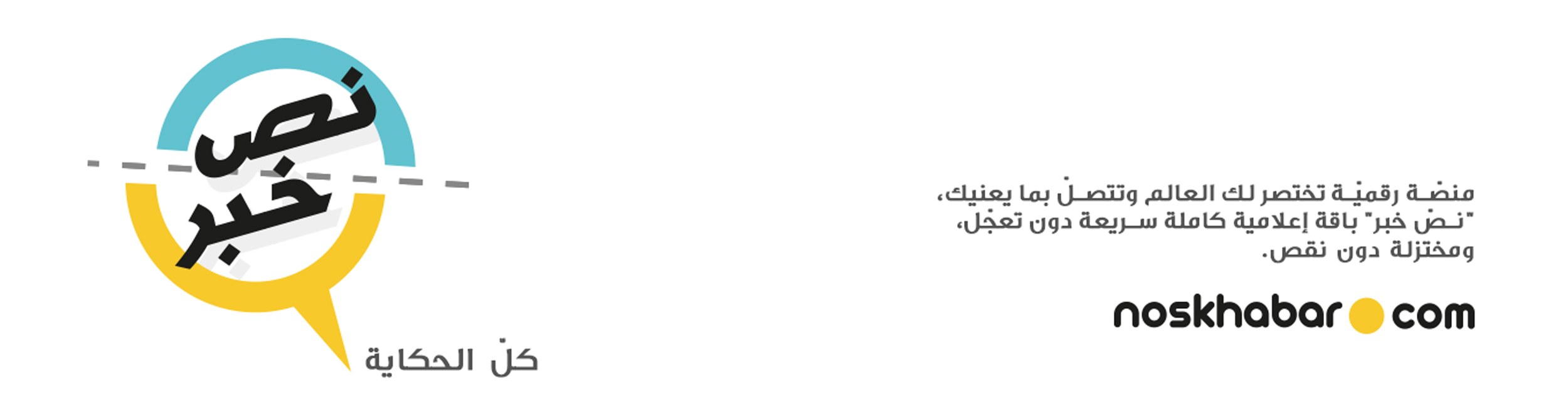20 يونيو – 2023
حاوره؛ هاني نديم
بالنسبة لي؛ لا يمكن أن تذكر حمص إلا وأذكر عبدالكريم عمرين، الأديب والمسرحي الحمصي الذي كان ينقل لنا يوميا حوادث المكان في السنوات الدامية السورية وكتب خلال هذه المرحلة كتابين من أجمل ما يكون، “حمص التي لم نعد نعرفها” وهو وثيقة شعرية للمكان، وذكريات حمص، ويستعيد فيه حمص المتوهجة بالثقافة والفنون مع مقارنات تمر هنا وهناك بما يحدث اليوم.
عبدالكريم عمرين، كاتب وممثل سوري، نراه في المسلسلات والمسرحيات السورية كثيرا، ولكم من لم يقرأ ما يكتب سيفوته الكثير من جوانب هذه الشخصية الفذة، التقيته في هذه الدردشة:
- في حمص، ومن حمص.. ماذا تبقى من ذكرياتنا عبدالكريم؟ حدثني عن كتابك وعما تصنعه الآن بعد كل ما جرى
– لم يبقَ لنا سِوى الذكريات نلُمُّها, نُرَتِّبُها, نُسّتِّفُها والبعضُ يدسُّ فيها النفتالين وبعضٌ يُرتِّقها ويُدثِّرُها بالحنين أو بالأنين, وفئةٌ تُطلقُ النار عليها وفَصيلٌ يَهِبُها السبع المثاني وهي مسجَّاة في برزخها وقد ضَيَّعَ الصراطَ المستقيم, لكنه ببلادة يلهج: “الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم مالك…..” آمين!
لم تعد حمص تلك المدينة النابضة بالحيوية والحب والطيبة, العاصي فيها حزين, وعقيقها الأسود بازلتها يئن, لقد غيرتها الحرب الملعونة, فيحدث في الحرب المجنونة أن يذهب عقلك إلى فردوس الجنون يحدث أن يقتلعوك من بيتك وتنهال عليك القذائف والسب واللعن و التخوين والتكفير. في حرب الأوغاد والأوباش ممن يقولون أنهم يدافعون عنك, ويجسدون حلمك لذا فعليك أن تخسر كل شيء كل شيء, بيتك, زوجك, أولادك قلبك وروحك.
في الحرب المجنونة يحق للحاجز البغيض أن يعتقلك بسبب شعرة بيضاء في عانتك ويحق للثورجي أن يقتلك لأن قميصك مشجّر. في الحرب المجنونة يتكاثر المهرجون والبهاليل الوعّاظ والأبطال واللصوص يجأرون بالفضيلة والوطنية والخلافة.
في الحرب المجنونة الكل يتحدث باسم الله وأنبيائه يُحاضرون بك ويتفيهقون يريدونك بيدقاً في لعبة شطرنج عقائدهم. في الحرب المجنونة ليس ثمة معيار للقيم, كل شيء مباح كل شيء مشروع, كل شيء مُحَرَّم. في الحرب المجنونة لأمة من المجانين لا مفر.. لا مفر من الجنون.

اليوم وقد انتهت الحرب أو كادت, صار الجوع حصاناً مطلق الرغبات, وصار للسلم أمراؤه كما للحرب, لا يشبعون من قهر الناس وابتزازهم وسحقهم بالغلاء, نحن في عيش لاإنساني حقاً ففقدان الوقود والطاقة والكهرباء وكل مايساعدنا على الحياة أصبح شحيحاً, عدا عن فقد الأحبة الذي يسحق أرواحنا, فهناك من فقدناه قتلاً أو غرقاً أو هجرة, وخصوصاً أولادنا وأهلنا وأحبتنا, لكن الأمل مازال فيه مضغة تنبض, نقول: لعل القادم أجمل.
عن كتابي “ذكريات حمص” وهو سيرة ذاتية, حكيت ببساطة شديدة ويانعة, عن حمص وحاراتها وشوارعها وأهلها, أسرتي, الأقرباء والأصدقاء, عن تجربتي الشخصية ومعاناتي لاستحواذ الحقيقة, والعمل على تجسيد العدالة الاجتماعية, تجربتي مع التصوف والسياسة, انتمائي للتيار الناصري, الاتحاد الاشتراكي, ومن ثم لليسار السوري, وعملي في المسرح, كل ذلك تم بنزق الشباب, وقبله نزق الطفولة حيث كنت أرفض الظلم والأعراف والعادات والتقاليد, فهربت من بيت الأسرة ولي من العمر 13 سنة, إلى بيروت, ولبيروت حكاياها بعيني الطفل الذي تعرض للعنصرية والاذلال والجوع, حتى صار يأكل من نفايات سوق الخضرة, وينام في الحدائق, وثمة في الذكريات أحاديث عن علاقتي بالمرأة, الأم والصديقة والحبيبة, ودهشتي الأولى في رؤية النساء عاريات في حمام النسوان.. ثم دراستي بدمشق والتحاقي بالخدمة الإلزامية والسفر إلى كييف وقبلها عن عيشي في القاهرة رغبة مني في دراسة الإخراج المسرحي, وطرد السادات وأجهزته لي بسبب مواقفي السياسية, ومعارضتي للصلح مع إسرائيل, حيث كانت قد بدأت محادثات الكيلومتر 101 بين ضباط من مصر والعدو الصهيوني. وغير ذلك كثير.

ماذا أصنع الآن؟ لا شيء!.. أعد الأيام أحياناً, وأتشهى لملمس أولادي في بلاد الاغتراب, أكتب وأقرأ, ويضيع الوقت أحياناً في تحصيل الخبز ومخصصاتي من البطاقة الذكية, وأشرب لأنسى, وأنتظر رحيلي..
أشعر أنا وغيري بالعطالة وسط جيش من المنافقين وعديمي الأخلاق والفكر والضمير وعديمي الموهبة الذين يحتلون مكان الصدارة والفعالية في الوسط الدرامي.
- الدراما السورية تبدلت كثيرا.. كيف تقرأها اليوم وما هي مشاريعك وتحدياتك وهمومك معها؟
– الدراما في جوهرها هي صراع الأضداد, ومنذ نشأتها كتراجيديات إغريقية, عكست صور المجتمعات الإنسانية بتجلياتها المناطقية, وعرفت شعوبنا العربية الدراما المسرحية في نهاية القرن التاسع عشر, واشتد عودها في القرن العشرين, إنها فن وافد, كما الرواية والفن التشكيلي, لكن الرواية استطاعت أن تكوّن ملامحها وأن تنفذ إلى قلوب الناس بفضل تراث القص والروي العربيين, ألف ليلة وليلة مثلاً.
أما المسرح فلم يستطع أن يكوّن سماته وملامحه وخصوصيته, وبقي فناً نخبوياً, ولا أتحدث هنا عن المسرح الشعبي والتجاري لابتذالهما رغم الجماهيرية التي يحظيان بها, وكذا الأمر ينطبق على الفن التشكيلي النخبوي جداً, والضائع في الانتماءات والتائه في المدارس التعبيرية الغربية, أما الشعر ديوان العرب , فعاد القهقري ولم يستطع أن يكون رصيف العرب, أستثني هنا محمود درويش ونزار القباني, وبعض الأصوات الشعرية التي لم تأخذ حقها, فشعراء المنابر والمناسبات وشعراء وشاعرات الصالونات ثم الفيس بوك, وإسهالات النشر لمن هب ودب, أضاع الجهود الإبداعية لبعض الشعراء المجلّين.

نجحت الدراما التلفزيونية المصرية أولاً ببعض مسلسلاتها الجادة, ومن ثم بزغت الدراما السورية, ونجحت أيما نجاح على المستويين السوري والعربي بجهدين أوليين للمخرجين هيثم حقي وحاتم علي ثم الليث حجو وغيرهم, لكن توقف إنتاج هذه الدرامات أو يكاد في الحرب السورية لأسباب كثيرة, ودخلت الدراما اللبنانية والخليجية لتأخد بعض المساحة التي شغلته الدراما السورية, والأهم تأثرت الدراما العربية كلها تقريباً ومنها الدراما السورية بشروط الشركات المنتجة, وشروط الأقنية التلفزيونية التي في النهاية تفرض شروطها من حيث محتوى الدراما ونجومها.
أما عن الدراما المسرحية, وبعد فشل المشاريع الأيديولوجية الدينية والقومية واليسارية العربية والسورية فقد انكفأت على نفسها, ولم تعد تعبر عن المستقبل الحلم, ولا تقدم أبطالاً, ولا قصة ولا حبكة, كل ما تقدمه بعض الشجن الضبابي, لكنه متخم بالتزويق والتنميق والحرفية, ولم يعد يهمها ما تقدمه للجمهور, صارت تلهو بالتقنيات وباختراع مسرح ما بعد الحداثة المضلل, وهي بالأصل لم تعرف الحداثة لافي المسرح ولا في المستويين الفكري والمعرفي, وكل إبداع في المسرح والأدب والفن لا يزهر ولا يشمخ ويعبر تعبيرياً جمالياً مالم يتوفر له شرط الحرية, والحرية غائبة أو تكاد والرقابة مقيدة للمبدع بنسب متفاوتة على الساحة العربية. لذلك كله أشعر أنا وغيري بالعطالة وسط جيش من المنافقين وعديمي الأخلاق والفكر والضمير وعديمي الموهبة الذين يحتلون مكان الصدارة والفعالية في الوسط الدرامي.

أصبحنا غرباء عن هويتنا التي لم ننجزها بعد أصلاً
- ماذا عن البلاد، كيف سنعبر كل ما جرى وإلى أي مكان سنصل؟
– التغيير بحاجة لمعجزة حقيقية, فنحن عجزة, لم نفلح في استلهام تراثنا, ولم نستطع أن نواكب حداثتنا نحن لا الحداثة الأوروبية, ولم نستطع أن نتفلسف في كليات الفلسفة, بقينا نقلد وننعق, ونردد عبارات ومواقف الآخر ونتحيز لخطاب الغرب ومنطوقه, استغربنا تماماً, وأصبحنا غرباء عن هويتنا التي لم ننجزها بعد أصلاً, لكن بعضنا يحلم بها, والبعض قدم مشاريع نهضوية مهمة لم يلتفت إليها أحد, كمشروع الجابري وأركون وجورج طرابيشي وطيب تيزيني وغيرهم.. وللأسف أن النخبة منا مازالت تسأل سؤال الهوية لا سؤال المعرفة.