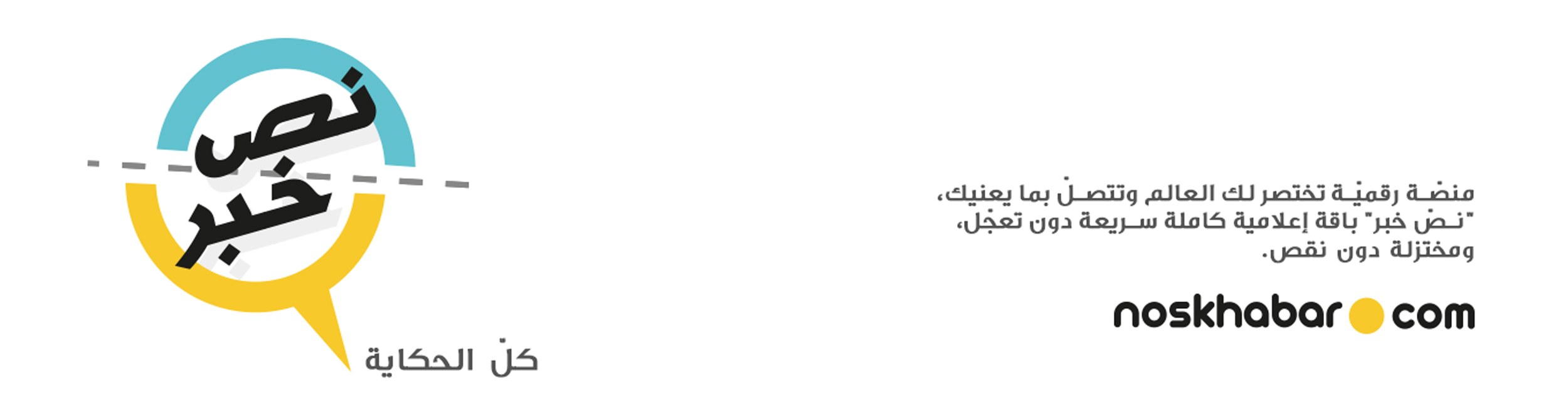13 أغسطس 2023
حاورها؛ هاني نديم
عبير الديب من شاعرات سوريا المكرسات واللاتي أثبتن علو كعبهن في زحمة المشهد الشعري العربي، مثلت سوريا في أكثر من مهرجان وملتقى وحازت على أكثر من جائزة، إلا أن ما يميزها – حسب وجهي نظري – إصرارها على كتابة نص موزون يحمل الحداثة في كل مشهد. إنها تعامل الشعر بجدية واحترام وتضع كل مكتسباتها في ما تصنعه من نصوص.
التقيتها في حوار سريع عن الشعر عموماً وعن سوريا والبلاد. سألتها:
- بداية من المشهد الشعري في سوريا، ماذا اختلف علينا خلال هذا العقد؟ كيف ترين المشهد اليوم؟
– ليس من السهل على أي سوري أن يعود بالذاكرة عقداً من الزمن، فالحسرة وحدها رفيقة درب عودته، مهما كان مجال عمله أو إبداعه، ومهما كان اختصاصه أو نشاطه، لأن سنوات الحرب -أية حرب- لها أثرها الجلي على الشعوب التي تمر بها، ومنها الجانب الإبداعي عموماً، والحركة الشعرية على وجه الخصوص، ولربما يعتبر البعض أن الفترة الماضية كانت مصدر إلهام للكثير من الشعراء والمبدعين، وانعكست في كتاباتهم، بل وكانت شرارة لمعظم أعمالهم الجديدة، فالشاعر ابن البيئة التي يكتب فيها وليس من المألوف أن ينفصل عن الواقع ويغرد خارجه.
ومن ناحية أخرى فإنها -أي سنوات الأزمة كما نسميها- فتحت الباب أمام آخرين اكتشفوا في أنفسهم نفحات إبداعية فعملوا على إذكائها، بالتزامن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتسخيرها كمنصة مفتوحة للجميع، دون حسيب أو رقيب، وهنا -برأيي- تكمن المشكلة التي جعلت المشهد الشعري مشهداً عشوائياً، تتراكم ألوانه دون تجانس أو اتساق، وتعوم على سطحه الفقاعات التي يصفق لها الجمهور جهلاً أو مجاملة، نتيجة التسويق الذي لا يقوم على أسس موضوعية، والذي دعمته كما قلنا سابقاً المنصات الحرة، وشاشاتنا الوطنية، إضافة إلى المنابر الرسمية من مثل المراكز الثقافية، ومؤسسات وزارة الثقافة بشكل عام. مما جعل المشهد يبدو مترهلاً بائساً يختلط فيه الحابل بالنابل، والصالح بالطالح، وهذا ما دفع عدداً لا بأس به من الشعراء الجادين إلى النأي بالنفس، أو الابتعاد نوعا ما عن كل ما يدور في أروقة تكريس الفقاعات.
ولست ألوم هنا من وجد في الكتابة متنفساً له، ففتح باباً أعجبته نسائم تدخل منه، لذلك لم يعد بإمكانه التخلي عنه وإغلاقه، إنما يقع العتب على المؤسسات الرسمية التي تقدم كل من يقدم لها نفسه، وبالصفة التي يختارها لنفسه، وكما يقال فلكل زمن دولة ورجال، ويبدو أننا في زمن الانحطاط على كافة الصعد والمستويات، فلا غرابة في يحدث على الساحة الشعرية إذ إنه يتبع ما يحدث في البلد بشكل عام. ما أرجوه هو أن تغربل الأيام ما علق بقمح الشعر من حبوب دخيلة، فليس من العدل بمكان أن ننقل هذه الصورة العشوائية للأجيال القادمة.
وصلنا شعر النثر مع حقائب الحداثة التي وصلت من الغرب، فتبنيناه شكلاً دون أن نتعمق في الأسس التي يبنى عليها مضمونه
- هل يعني لك الشكل وأنت من كتاب الشعر الموزون؟ كيف تصفين النثر اليوم والنصوص التي تقرئينها؟
– سأكذب لو قلت إن الشكل لا يعنيني، وإن الشاعرية وحدها الفيصل بالنسبة لي، فالوزن باعتقادي هو أحد أهم حوامل الشعر العربي، ولست هنا مع التقليد والكلاسيكية والنظم الفارغ طبعاً، إلا أن الحداثة والتجديد يمكن أن تكون في المضمون مع الحفاظ على الوعاء الموسيقي للشعر، فقد وصلنا شعر النثر مع حقائب الحداثة التي وصلت من الغرب، وادعاءات التخفف من قيود الوزن وقوالبه، فتبنيناه شكلاً دون أن نتعمق في الأسس التي يبنى عليها مضمونه، واستسهله البعض شكلاً ومضموناً رغم أنه -لو أردنا أن نكون موضوعيين- من أصعب الأشكال الشعرية كتابة، لكن ما وصل إليه هذا الشكل عندنا، بات يعتبر ظاهرة لا أدب فيها ولا شعر.

لقد وصلنا إلى مرحلة يصعب معها ضبط السيل الجارف من الشعراء الذين اعتمدوا هذا الشكل، ودافعوا عنه باعتباره تطوراً طبيعياً للشعر العربي بعد مرحلة التفعيلة أو الشعر الحر، ولو سلمنا بهذا جدلاً فما نقرؤه اليوم من قصيدة النثر في الصحف والمجلات والمنصات الإعلامية الإلكترونية، يجعل القارئ العليم في حالة غثيان حرفياً، وما أحلى النظم مقارنة بنصوص يصر أصحابها على تسميتها قصائد نثر، مما جعل الحكم بالمجمل على حالة هذا الشكل، تبدو صعبة للغاية، لأن الجيد منها باعتقادي، وحسب ما أطلع عليه لا يتجاوز الـ10% في أحسن الأحوال، والباقي مجرد صف للكلام وبناء عسير لجمل لا طائل منها ولا معنى. فهل تشكل هذه الـ 10% الجيدة، نواة يمكن التعويل عليها وآمالاً بتطور حقيقي، ربما وحدها حركة النقد الجاد تستطيع بلورة الإجابة هنا… فالحديث طويل.
مشوار واحد في أي سوق يكفي كي تعود إلى منزلك بمخزون من الحزن يكفيك طويلاً
- عن عبير خارج نصوصها، متى تفرح ومتى تحزن، عن علاقتها بالوسط الثقافي وخارجه، عن الأصدقاء والأمكنة. حدثيني عنك.
– نصوصي تشبهني، في الحزن والفرح… أخلص لفكرتي البكر في بناء أي نص أكتبه، تفرحني الأمور البسيطة كلقاءات الأصدقاء، أو مشاهدة فيلم جميل، أو الخروج مع ابنتي للتسوق، فسقف السعادة منخفض عادة لدى البسطاء -وأنا منهم- وربما أفرح بإطراء أشعر أنه من قلب قائله، أو كلمة لطيفة جاءت في وقتها المناسب. يفرحني أن أتقاضى أجر عمل قمت به، لكن ما يفرحني أكثر هو إنفاق ما أتقاضاه مباشرة، وهنا أنقل الفرح لعائلتي أيضاً، وهذا بحد ذاته أمر مفرح.

أما عن الحزن الذي أجلت الحديث عنه قليلاً، فهناك الكثير منه حولنا هذه الإيام، يقاسمنا أيامنا وخطواتنا، ويتربع في صدور مجالسنا، يشاركنا الطرقات والمكاتب والحدائق، يحتل جلّ أحاديثنا ويسكن أغانينا وقصائدنا. الحزن أصبح الراعي الرسمي للمرحلة… يكفي أن تمشي في أي شارع من شوارع الوطن، لتراه يطل من أعين الجميع، من أصواتهم وكلماتهم، مشوار واحد في أي سوق من الأسواق يكفي كي تعود إلى منزلك بمخزون من الحزن يكفيك طويلاً. بالنسب لي فإنني أهرب منه إلى عملي في التحرير الأدبي والتدقيق اللغوي، هذا العمل الذي أحبه حد أنه بدأ يسرقني من الشعر والكتابة، لكنني مدينة له فقد شكّل طوق نجاتي في هذه المرحلة.
وعن علاقتي بأصدقائي من الوسط الثقافي كما أشرتَ في السؤال، فهي أيضاً متنفس ينتشلني من العزلة التي فرضتها على نفسي مؤخراً دون أن أقصد أو أنتبه، نجتمع أسبوعياً في منزل أحد الأصدقاء، -غالباً في منزل الأستاذ الكبير فرحان بلبل- نسرق ساعتين خارج سجن الرتابة، نشرّق خلالهما ونغرّب، نستحضر الغائبين منا ونطمئن عن أحوال الحاضرين، وبالنسبة لي فمثل هذه الجلسات تجدد طاقتي وتمدني بالغذاء الروحي، فأعود وأنا أردد “لسا الدنيا بخير”.