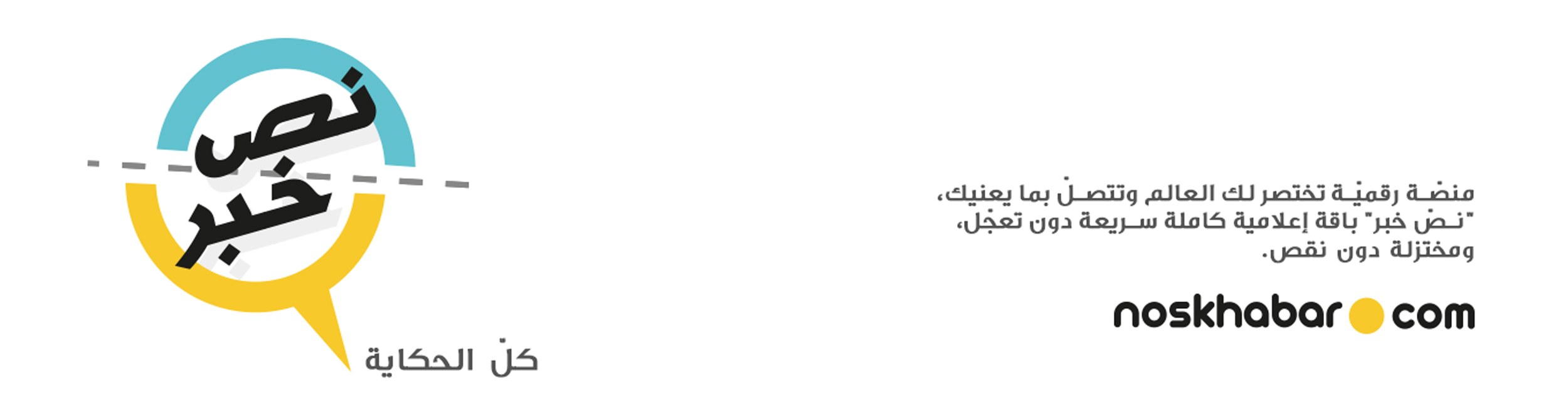29 يونيو 2023
حاوره: هاني نديم
محمد المتيم شاعر وصحافي مصري لا يمكن لأي محترفٍ بالكتابة أن يمرّ من جانب نصوصه مرور “اللئام”! إنه صاحب لغة مختلفة وفكر متوقد بالرموز والمعطيات الراسخة.
هذا التفرّد والصوت الأصيل داخل المتيم، جعلني أتابعه منذ أن تعرفت عليه، وكلما قرأت له أكثر كلما أحببته أكثر. ولأننا نتقاطع في التورط بمحبة المعجم الصوفي والصحافة الثقافية، حاورته أستطلع مع هذه اللغة الرفيعة الفرق بين جيلين، والمشهد الثقافي المصري والعربي وعن نفسه.
سألته:
- عن نَفَسِك الصوفيّ، عن لغتك ومعجمك، عن المنبَت الأول والمحطّ الأخير للكتابة أسألك.. حدثني عن هذا.
– أول ركعتين صلَّيْتُهما في محراب الشعر كان جسدي كله أُذُنًا. ففي قرية تقبع على الحد الفاصل بين محافظتيْ الأقصر وأسوان، كندبةٍ على خَدّ الخريطة، سمعتُ المدَّاح يترنَّم بغزالِه الفتَّان، ويشدو:
بوادي المنحنى وبأرضِ راما
مليحٌ في الحِمى نصَبَ الخياما
غزالٌ سارحٌ في أرض نجْدٍ
يصيدُ الأُسْدَ إذْ يُرخي اللثاما!
كصيادٍ محترفٍ ألقى المدّاح صنّارتَهُ -البيتين- وخرج بأذني التي راح يحشوها بموسيقاه ورموزه في عملية شعريَّة بالغة العذوبة. ورحتُ أسأل وأنا ابن سبع سنين -بالكاد يفكُّ الخط- عن أرض راما الساحرة تلك، وعن خيام العُشّاق الرُّحَّل، وعن الغزال الملثَّم، وعن المليح الذي يصرع الأسود بحُسْنِه، وانفتحت المخيّلة.
بجانب انفتاح المخيِّلة هذا، تضافَرَتْ حلاوة النغم -بحر الوافر- مع عذوبة الصوت وجمال الكلمات، وحملني كل هذا وألقى بي في البوادي، أبحث عن غزالي الملثَّم الخاصّ – الشعر!
حدث كل هذا لانتماء القصيدة الأولى التي صَحَوْتُ شعريًا عليها إلى ما نسمّيه “النص الشفاهي”. القصيدة الشعرية الكلاسيكية قصيدة شفاهية بالأساس، تتمتع في خصائصها الفنية بغنائية عالية، وخُلِقَت بالأساس لتُلقَى من الشاعر وتُسمَع من المتلقي، وعلى هذا الأساس دخلت إلى حرم الشعر عبر بوّابة الأذن، فكتبت في بواكير تجربتي الشعرية النصَّ الذي يتفق والبوابة التي دخلتُ منها، أعني النص الإيقاعي أو الخليلي.
أول ركعتين صلَّيْتُهما في محراب الشعر كان جسدي كله أُذُنًا، وبمرور الأيام أصبح الشعر عندي معادلًا للرؤية لا السمع، وتجربتي الشعرية، من القصيدة الخليلية إلى قصيدة النثر، هي السنتيمرات السبعة بين أذني وعيني
لكِنَّ “السنين تمرُّ والعربات تنأى” كما يقول شيخ الطريقة/ سعدي يوسف، والحياة المدنية تلعب لعبَتَها، فتتداخل الأصوات، ويشتعل التنافر بين المؤثرات الصوتية الزاعقة من حولك –ويلي من ميدان العتبة يا هاني!-، فتخبِّئ وردَتَكَ وتصمّ أذنيك، وتكتفي بالمشاهدة، إذْ انحسرت حساسية الأذن للوراء، لتتمدد مساحة العين في الرصد والاستكناه.
بعد قرابة ثماني سنوات من عبثك اللغوي فوق أمواج بحور مولانا الفراهيدي، آنَ لك أن تنصرف عن خرير الماء، لتتأمل الدوائر التي تتسع على صفحة النهر وتتلاشى إثر حجرٍ ألقاه صبيّ، آنَ لك أن تنصرف مبكرًا من حفل الربيع لترثي وردةً تذبل. وجدتني فجأةً أتجوَّل في الشوارع أستنطق التجاعيد في الجِباه، وضحكات الصبايا المكتومة على النكتة البذيئة. ما أقصده أنه بمرور الأيام أصبح الشعر عندي معادلًا للرؤية لا السمع، بصرف النظر عن عملية ضخِّه على الورق من عدمها.
هذا التحول قادني بسلاسة إلى قصيدة النثر، دون الوقوع في شَرَك استيراد جماليات شعرية مجافية لخصوصية الحالة العربية، ومع هذا فقد أفدتُ كثيرًا من خبراتي السابقة مع النصّ “الكلاسيكي”، فكما يقول طفل الأوليمب المدلَّل/ أدونيس: “أنت لا تستطيع كتابة الشعر بلغةٍ تجهل تاريخَها الجمالي”، فالذين يُرَوِّجون للقطيعة التامة مع النص الشعري التراثي وتجاهله بدعوى الحداثة الشعرية، هم أبعد الناس عن فهم مقتضيات الشعر والحداثة معًا.
أستطيع أن أقول إن تجربتي الشعرية، من القصيدة الخليلية إلى قصيدة النثر، هي السنتيمرات السبعة بين أذني وعيني، أي: المسافة التي قطعتُها من التلقّي بالأذن إلى التلقّي بالعين. تلك المسافة التي تبدو قصيرة جدًا احتجتُ لقطعها اثني عشر عامًا، ليصير الجسد كله عينًا.

الرواد أفادونا، لكنهم لم يكونوا دائمًا سليمي النوايا، بعضهم فتح لنا الباب، وعندما دخلنا، سدَّ علينا كل المنافذ لنظل أسرى رؤاه
- كيف ينظر جيلكم –إن جازت فكرة التجييل بالمطلق– إلى من سبقوهم؟ ديناصورات؟ يعطيهم العافية؟ أفادونا أم ماذا؟ كيف ترى أمر الأجيال؟
– من سبقونا ليسوا سوى مساكين يعملون في البحر، وللبحر شؤونه وللمساكين شؤونهم، وشأنهما المشترك هو الحظ.
يتوقف مصير المساكين في البحر على حظهم مع الريح، وحظهم في الصيد، وحظهم من بقاء الزاد، وحظهم مع ارتفاع وهبوط الموج، وخفقات المدّ والجزر. وهذا شأن الأجيال السابقة مع الحياة والمجتمع والدولة والمؤسسة، كل امرئ منهم غنِم وخسر بقدر حظه وقدر فهمه لاتجاه الريح والموج.
أستطيع أن أنظر إليهم كرجال هبطوا إلى الماء بلا خطّة، ربما رغبوا في “البلبطة” في ماء الحداثة، وبناء البيوت الرملية على الشواطئ، لكنهم –على كل حال- تورطوا في البحر، وكتبوا.
أراهم أحيانًا كالضباع، وتارةً كالأطفال، وأخرى كالدُّمى، لكن ذات تسامحٍ تجاه الكائنات لا يعدون في نظري سوى مساكين في البحر ألقت بهم يد المشيئة في محنة التعبير فعبّروا.. لينتهي المطاف بأحدهم درويشًا في زاوية أو متصابيًا على مقهى للطالبات، لا يهم، هذا ليس انفكاكًا عن حاله الأولى بل امتدادًا لها، ولا يعنينا هذا المسكين بأكثر من كونه ذات زمانٍ ساعدًا أو عضدًا دفعت القارب للأمام.
نعم أفادونا، لكنهم لم يكونوا دائمًا سليمي النوايا، بعضهم فتح لنا الباب، وعندما دخلنا، سدَّ علينا كل المنافذ لنظل أسرى رؤاه ومخيّلته ومفاهيمه، ما الحيلة؟! سنحطم الباب وندكّ سقف المعبد على رأس الكاهن الجديد.
ليس حلمي سالم بأقرب إليّ من نزيه أبو عفش، ولا جمال الغيطاني بأقرب إليّ من عبدالرحمن منيف
- هل أنتم جيل محظوظ أم مظلوم؟ ماذا يعني لأديب مصري جديد اليوم وهو يقف على هرم من الأسماء التي سبقته؟
– نعم، نحن جيل محظوظ، يستطيع أن يصدر صوتًا قبيحًا من أنفه ضد أي دورية أو مجلة ترفض قصيدته، ما دام يمتلك صفحته الشخصية لينشر عليها ما شاء، ولو ملابسه الداخلية.
محظوظون أيضًا باستغنائنا عن تكلفة الجلوس على المقاهي، ما دامت النميمة متاحة عبر الإنترنت، وبإمكانك ضبط الناقد “النصّاب” والشاعر المنتحل بضغطة زر على الكيبورد.
حظُّنا -كمساكين جدد- مدينون به لبحر التكنولوجيا.
أما ما يعنيه لي وقوفي على أكتاف الأسماء المصرية السابقة –وإن شئتَ على أطلالهم-، فليس حلمي سالم بأقرب إليّ من نزيه أبو عفش، ولا جمال الغيطاني بأقرب إلي من عبد الرحمن منيف. ومن حماقات بواكير الشباب ما كنا نخوضه -على سبيل المثال- من لغو مع أقراننا العراقيين من مفاضلة بين دنقل والسياب أو شوقي والجواهري، كان نزقًا جميلًا، لكن الحق أنه انقلبت قاطرةُ القُطرية والتحم الناس بالناس، منذ دشَّن السيد زوكربيرج سفينة المساكين الخاصة به، فأنا مدين للمجايل والأصغر سنًا، مصريًا أو عربيًا أو عالميًا، بقدر ما أنا كذلك تجاه الأقدمين.
- كيف تصف المشهد الأدبي المصري اليوم والعربي عمومًا، هل ما زالت الرواية هي الرواية والشعر هو الشعر؟
– يبدو لي المشهد المصري أحيانًا وكأن مصدر قوته هو مصدر هشاشته، وكلاهما أعني به: الوفرة، (يا داخل مصر فيه منك ألف)، هناك أدب عظيم وكثير في مصر، لكن هناك أيضًا وفرة مهولة في الغثاء التافه. الجيد في الأدب المصري -بلا شوفونية- أكثر منه في أي دولة أخرى، لكن التافه والغثاء في مصر كذلك أكثر منه في أي دولة أخرى… نكتة بليغة أن يرغب 110 مليون فم – ليس فقط في الأكل والشرب والتصفير للصبايا، بل وفي قول الشعر وحكي القصص أيضًا!
هذا ليس زمن الرواية، كما رغب في تدشينه السيد جابر عصفور، قبل عقدين تقريبًا، لكنه كذلك ليس زمن الشعر، ربما هو زمن النص.
هل تبدو كلمة “النص” كلمة مطاطة؟! ربما، لكن صدقني أشعر أن ٩٩٪ من الذين يكتبون في العالم العربي لا يعرفون ما الذي يريدون كتابته، غايتهم الكبرى – الكتابة كتجلّي وجود، والطفيليّون منهم غايتهم “اسمٌ على غلاف” بغض النظر عن نوع الحشو في الرغيف، ولا سامَحَ الله الأوكارَ المسماة “دُور نشر” التي غرَّرت بهم وسلبتهم “تحويشة” نهارات العمل!
دعك من الطفيليين، أما الذين لديهم رغبة في الكتابة ككتابة، يمكننا أن نرسل نيابةً عنهم برقية شكر للسيد زوكربيرج أنه أتاح حق التعبير عن الذات للجميع، وكفل للجميع نفس مساحة الضوء تحت المجهر، ولنرشّد عمليات الطباعة.. طن الورق وصل إلى 2000 دولار، ونحن مجتمعات مأزومة اقتصاديًا يا هاني.
لنرشّد عمليات الطباعة.. طن الورق وصل إلى 2000 دولار، ونحن مجتمعات مأزومة اقتصاديًا
- من هو محمد المتيم وماذا يأمل ولماذا يكتب؟
– مواطن مصري، يكتب الشعر، ويمتهن الصحافة الثقافية، ويعمل محررًا أدبيًا بعدد من دور النشر، يؤمن بقوة الزند والكتف، وما يشغله دائمًا محاولة ضبط التوازن بين علاقته كصعيدي بالشمس وعلاقته كشاعر بالقمر، وإذا نجح في ختام اليوم في ضبط وتحرير ثمانين ورقة فهو جدير بـ”صينية” السمك الطازجة التي طهتها زوجته.
لا آمُل في شيء سوى النجاة من الإصابة بمرض مهين ولو كانت النجاة تعني موتًا، وأن تعطش أمي فلا تسبقني يدٌ إلى فمها بالكوب.. هذه خلاصة آمالي في الحياة.
أما لماذا أكتب، فالمعاني هي السائل الخامس. أتصوَّر أن علامة الحيوية في الإنسان أن يفيض بسوائل أربعة، وفي إفرازها تجدُّدُها، وفي احتباسِها فسادُها، هي: الدم، الدمع، العرق، السائل المنوي، والمعاني المعتملة داخلك هي السائل الخامس الذي يُثبت أنك حيّ، وتراكمها في الجسد دون إفرازها في الكتابة يعني التسمُّم البطيء، ويعني الاحتقان المُفضي إلى الموت.. ربما أكتب لكيلا أموت محتقنًا باعتذارات مؤجَّلة.