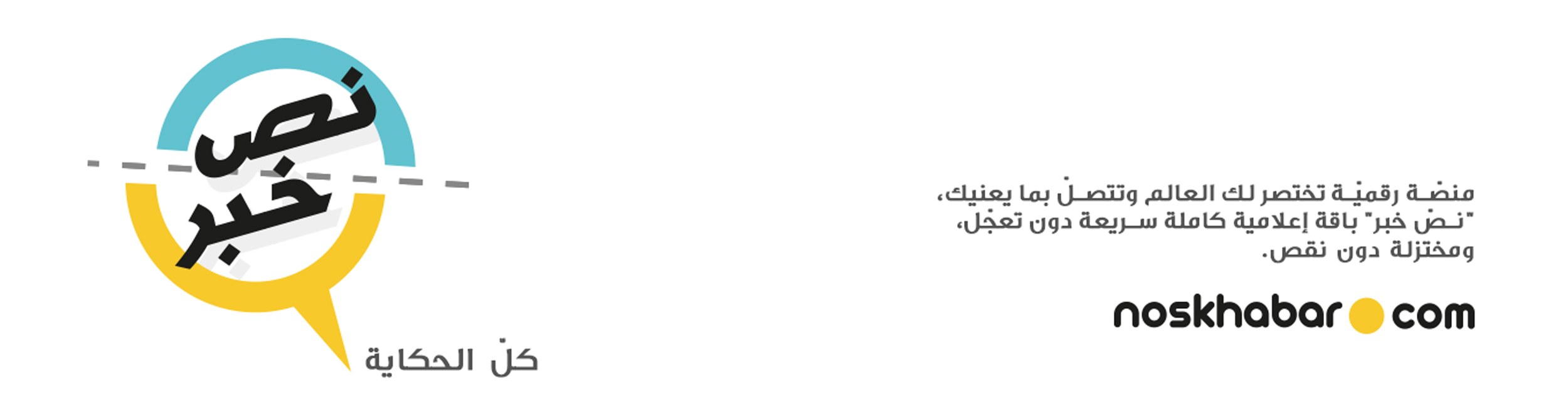14 يوليو

أمامة أحمد عكوش – كاتب وصحافي سوري
حالة استثنائية بكلِّ معاني الكَلِم، أخٌ للجميع، حبيبٌ للكلّ، صديقٌ لكلّ الأمكنة والشّخوص، صانع ضحكات السّوريين.. هو روح الفرح؛ من كان صوته يرنُّ على المسرح بإيقاعات لا حدود لها.. هو روح المسرح؛ من فتح كُوَّةً من نورٍ في جدار الصّمت على الفنِّ الذي عشقه بكلِّ تجلّياته، ليغدو العشق متبادلاً.. هو روح الفنّ؛ عشقَ الحياة فتعلَّمَ منها وأعطاها.. هو روح العطاء؛ الصَّارخ من حنجرة الغياب: “الحب هو الخلاص، الحب هو الحل يا أولاد أمّي، الحب هو الحلّ يا أبناء وطني”.. هو روح الحب؛ أسعد الطّيب .. تشارلي شابلن العرب .. ابن “أمّنا العظيمة سورية” الحاضر أبداً نضال سيجري.
ولادة .. بحر
في الثَّامن والعشرين من أيار/مايو عام 1965 كانت صرخة حياته الأولى، بالقرب من قلعة شيزر “محردة”، قرب السّاحل السّوري، إلَّا أنَّ جذور عائلته تعود إلى قرية سيجر في ريف إدلب الغربي. صرخته الأولى.. لأنّ حياته مليئة بالصَّرخات – حتَّى في لحظات صمته، كان كلّ ما به يصرخ – صديق البحر منذ الطّفولة، كاتم أسرار سنيِّ اكتشاف الفضاء الشّاسع ورفيق صباه، مدونة أحلامه الأولى عبر سطور أمواجه، “من البحر تعلّمت أوّل الدّروس السُّرانيَّة، وما زلت حتّى اليوم أؤمن بأهمية السّر” بهذه الكلمات تذكّر طفولته رفقة البحر .
“في بيتنا الصغير، مارسنا الديمقراطية دون أن نعرف اسمها، خمسة شباب وبنتين، نعبّر عن أنفسنا، لا سلطة لأحدنا على الآخر”.. وبهذه الكلمات عبر عن عائلته غير مَرَّة، واستحضر والده “الموظف الحكومي” الذي آمن بتجربته في الدّيمقراطية، وبطريقة تربيته لأخوته وله. ففي حضن أسرة متماسكة، متحابّة، ترعرع طفلاً عادياً. ترتيبه قبل آخر العنقود، أعفاه من الاهتمام المبالغ به، الذي يحظى به الأكبر والأصغر عادةً، شارك في المسرحيات المدرسية، وفي معسكرات الطّلائع، واستهواه لعب كرة القدم.
ينجح في مدرسته رغم شغبه “المشاغبة ممارسة للحرّية، لم أكُ مؤذياً بشغبي”.. يبتسم وهو يحكي عن مشاكسته. لم يكُ من بين الأوائل، ولم يهتمّ يوماً بهذا التّصنيف، وها هنا قال: “الحياة أجمل عندما تكون خارج التّصنيفات، لطالما شعرت بالشّفقة على هؤلاء الذين يصنّفون ضمن الأوائل، ليسوا أحراراً مثلي، بل مطاردين بسياط درجات التّفوق”.

حب الطّفولة
عرف الحبّ للمرّة الأولى حين أغرم بمعلّمته “طبعاً حب من طرف واحد” يقول عن ذلك مبتسماً، وأحبَّ عرِّيفة المدرسة، كانت طفلة جميلة في الصّف السّادس الابتدائي، بينما كان هو في الصّف الرّابع، اقتنع بأنَّها لن تلتفت إليه لصغر سنّه، “قلت لصديقي في الصّف.. أنا وأنت لو جُمِعنا نصبح في الصّف الثّامن، لنحبّها معاً، ذهبنا وأخبرناها، فأسعدها ذلك، وضحكت” هكذا قال في ذكر حبّه الأوّل. لكنّ الفتاة التي لم تغادر ذاكرته إطلاقاً، هي تلك التي كان بيتها فوق الفرن، إذ قال: “كنت أترقّب نفاد الخبز في بيتنا، كي أذهب لشرائه، على أمل رؤيتها، كانت تقف على النّافذة المطلّة على مدخل الفرن”.
سائق .. بحّار .. سَفَر
لو لم يكُ ممثّلاً.. لكان “سائق شاحنة، أو بحّاراً” قال ذلك، موضّحاً: “مهنتان لهما علاقة بالسّفر والمغامرة، والبحث عن حياة أخرى في أمكنة أخرى”. بعد إنهائه المرحلة الثّانوية، شدّ الرِّحال مع صديقه إلى دمشق. قدّم نضال أوراقه للسّفارة البلغارية، بغية الحصول على منحة لدراسة الهندسة، تلبيةً لرغبة الأهل، فيما قدّم صديقه أوراقه لامتحان القبول في المعهد العالي للفنون المسرحيّة. “عندما خرجت من باب السّفارة، صادفت أحد أساتذتي في الثّانوية، قال لي: سجّل في المعهد العالي للفنون المسرحية، لا تناسبك الهندسة، من الممكن أن تكون ممثّلاً جيّداً”.. بهذه الكلمات شرح نقطة البدء في الحيوات والعوالم التي كان لها، ليكتشف فيما بعد.. أنّها كانت له قبل أن يدرك ذلك؛ وجد نفسه يتقدّم إلى امتحان القبول في المعهد، من دون أن يخبر أهله، عاد إلى عروس المتوسط “اللاذقيّة”، ظهرت نتائج المعهد، قُبل نضال، ورُفِض صديقه _ كان ذلك عام 1986 _ .
هناك.. في المعهد، سيكتشف أنّه بحقّ ثمّة حيوات أخرى، وأنّه سيعيشها بفرحها وحزنها وتقلّباتها وشخوصها، وسيكون ما تمنّاه في صغره، بل وأكثر.. سيكون “بحّاراً، وسائقاً، وشخوص أخرى كثيرة”. عمل لتوفير مصروفه، وأجرة غرفته بداية في دمّر، ثم في حيّ باب توما التي لم يغادرها إلّا سنة 2005، منعه حبّه لغرفته تلك من الهجرة إلى كندا، لكنّه اضطرّ إلى فراقها بعدما تزوّج من الكاتبة سندس برهوم، وأنجبا (وليم، وآدم).
أثناء دراسته.. عمل نادلاً، وعامل بناء، وعاملاً في معمل شامبو، ثمّ بائع على بسطة “بصل وثوم” مع صديقه آندريه سكاف، يتذكّر ذلك ضاحكاً: “لكنّنا اكتشفنا، أندريه وأنا، أنّنا لا نصلح لنكون من أصحاب المشاريع التّجارية”.

الخشبة
تخرّج من المعهد العالي عام 1991، وأصبح عضواً في نقابة الفنانين في 17 أيلول/سبتمبر 1991. مقاعد المعهد.. سجّلت العديد من الذّكريات في حياته، إذ تعلّم من المسرحي المؤسّس فواز السَّاجر كيف يُغامر، ويجرّب، ويحلّل، ويفكّك، ويركّب.. ليقول حين رحل السَّاجر إلى السّماء: “رحيل السَّاجر، كان أصعب أيام حياتي، أدركت أنّي سأفتقد هذا الرّجل طوال عمري“، أمّا جهاد سعد، فعلّمه كيف يكون عاشقاً للمسرح في “جيسون وميديا” تأليف وإخراج جهاد سعد عام 1988، قال سيجري هنا: “كنت طالباً في المعهد، ومن غير المسموح لي العمل خارجه، لكن الأستاذ جهاد حصل لي على استثناء من وزارة الثّقافة”، لتتكرّر بعدها التّجارب المسرحية في “كاليغولا” و “أواكس” و”سفربرلك”، وليتشرّب قدسية العلاقة بين الممثّل والخشبة.
حبّه للمسرح ازداد يوماً بعد آخر، حتّى وصل حدّ اللاحد، حدّ التّماهي، حدّ ما يتجاوز العشق بعشق، كيف لا!.. وهو الذي قال مراراً في الخشبة التي كانت الحاضن الأوّل لموهبته: “إنْ أحضرتم لي سريراً، فسأنام هنا على الخشبة، إنّه بيتي، الرّحم الذي منه خرجت ممثلّاً، هنا أشعر بالحماية، وعدم الصدأ”. لينتج عن هذي الحالات من العشق خلال مسيرته 35 عملاً مسرحياً تمثيلاً وإخراجاً، منها (شو هالحكي، شوية وقت، الغول، تخاريف، سندريلا، النّورس، مات ثلاث مرات، هايدي والأمير المسحور)، و “حمام بغدادي” عام 2005 لجواد الأسدي، مع – أستاذ الأمس وزميل اليوم فايز قزق – ومن ثمّ مسرحية “نيغاتيف” عام 2010 من تأليفه وإخراجه، والتي افتتح عروضها في “اللاذقيّة”.
أُسْنِدَتْ إليه إدارة “المسرح القومي”، إلّا أنه لم ينظر إلى الأمر من باب المنصب والنّفوذ، وهو القائل حيال هذا الحدث: “جهزّت استقالتي من اليوم الأوّل لقبول العرض، كنت فعلاً أطمح إلى أنْ أنجز شيئاً مهماً، ولكن..”، بعد أقلّ من سنة، أخرج استقالته من الدّرج، مشى باتجاه سترته المعلّقة، ارتداها وخرج، أغلق الباب خلفه، وقال: “اكتشفت أن المنصب مجرد كرسي، لا أكثر ولا أقل”.

الشّاشة
في تلك الفترة.. رغم الأجور المرتفعة في الدّراما السوريّة، الكفيلة بتوفير دخل معيشي جيد لأغلب العاملين فيها، خاصّة إن كانوا نجوماً من طراز سيجري، إلّا أنّه كان من الممكن بالنسبة له، رفْض أي عمل تلفزيوني، يتعارض مع أحد أعماله المسرحيّة. هو الذي دخل باكراً إلى وسط فنّي يعاني أمراضاً وعقداً، لم تخدشه المهنة من جهة، ولم يسمح للشّهرة من أن تجعله ملكاً، لأنّه كذلك بدون الشّهرة، هو كذلك عَبْرَ بوابة لها فلسفتها الخاصّة في أعماقه، من خلال أنّه ظلّ على هامش الحياة يمشي، دون أن ينغمس بالمجانية أو السّطحية.
تَفَرُّدُهُ في التّمثيل، أهَّلَهُ سرقة عين الكاميرا في الدّراما، بالقدر ذاته الذي يسرق فيه منصّة المسرح – وهو أمر يندر حدوثه – فليس بالأمر السّهل أن يمتلك الممثّل البراعة ذاتها أمام الكاميرا وعلى الخشبة، إلّا أنّ نضال كان بحّاراً بارعاً عبر تفاصيل الحياة كما يؤكّد كلّ من عرفه، وكذلك مع عباب خشبات المسارح التي اعتلاها، وأيضاً.. عبر عدسة كاميرا أيّ دورٍ قام بأدائه، أيّ أنّه بكلّ عمق وبساطة في آن.. نجم صنع أدواره ولم تصنعه الأدوار.
“دور صغير .. ممثّل كبير”!..
“نجم صنع أدواره ولم تصنعه الأدوار”، إذ امتلك القدرة على أن يجعل من دور “كومبارس”، شخصية ًلا تُنسى، واضعاً نصب عينيه مقولة المعلّم الرّوسي ستانيسلافسكي: “ليس هناك دور صغير وآخر كبير، هناك ممثّل صغير وممثّل كبير”، إذ انتقى أعماله وشخصياته تحت عنوان واحد: “أحاول عبر كلّ دور، أن أكون قريباً من النّاس”، وهو ما دعا عديد النّقاد إلى التّأكيد على أنّه وصل إلى ما سعى إليه، إذ قالوا: “وصل عبر أدواره إلى النّاس بكل شرائحهم، كان قريباً من الجميع”.
قدّم على مدار نحو الثلاثة عقود، قرابة المئة مسلسلة تلفزيونية، من أشهرها (الشّريد، العبابيد، الفوارس، سيرة آل الجلالي، أبناء القهر، بقعة ضوء، قانون ولكن، غزلان في غابة الذئاب، مرسوم عائلي، زمن العار، شركاء يتقاسمون الخراب)؛ وقدّم خلال هذه الفترة عملين سينمائيين (زهرة الرّمان، التّرحال)، ومن ثمّ فيلم “خارج التغطية” عام 2008 مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد.
رائعة
إلّا أنّ أهمّ محطّات حياته الفنّية، كانت الرّائعة التّلفزيونية “ضيعة ضايعة”، رائعةٌ.. كان كلّ مَنْ بها مبدعاً بحسب النّقاد، والممثّلين العاملين فيها وغير العاملين، رائعةٌ.. حصدت جوائز عديدة، وتصدّرت خانة الأعمال الأكثر مشاهدة في العالم العربي، وكانت من أهمّ ما أُنتج في تاريخ الدّراما السّورية والعربية، رائعةٌ.. نظم حروفها وأبعاد إسقاطاتها الكاتب ممدوح حمادة، ونظم كاميراتها وهندس قوالبها المخرج الليث حجو، وكان بطلاها “نضال سيجري، وباسم ياخور”، رائعةٌ حملت جزأين في 2008 وفي 2010، كان فيهما سيجري.. أسعد خرشوف ذي القلب الأبيض، الذي يشبه قلبه فعلاً، الطّيب، المحبّ، الذي تُفرحه الحياة بأبسط التّفاصيل تارة، من بيض الدّجاجات، إلى محصول الأرض مهما كان قليلاً، إلى أنْ تكون بقرته حلوباً، وتارة أخرى.. بأن يكون السّوري الوحيد الذي يملك أكثر من كليتين، براعته بتجسيد هذه الحالات وغيرها الكثير.. كانت كفيلة بأن يحصل إثرها بجدارة على لقب تشارلي شابلن العرب.

الحنجرة
في غمرة نجاحاته على الخشبة والشّاشة، وتحديداً مع “ضيعة ضايعة” جاءه صوت الطّبيب حازماً: “انتبه يا نضال، هناك عدو شرسٌ يتربّص بك”. أدرك حينها تشارلي شابلن العرب خطورة مرضه، وما الذي يقبع في حنجرته – السّرطان – ، قرّر ألّا يستسلم له، ليؤكّد الطّبيب بعد العمل الجراحي الأوّل: “بإذن الله خير يا نضال، لكن لا تتكلّم كثيراً، وفّر صوتك لأدوار مهمّة تنتظرك”. وعاد الطّبيب بعدها بفترة وجيزة، وطلب منه مجدّداً ألّا يتكلّم إلّا بالحدّ الأدنى، ريثما تُرمّم الحنجرة ذاتها من آثار الأشعّة المحرقة، وعدم التّعرض للبرد، لاسيما أنّ الشّتاء كان قاسياً آنذاك، لكنّه ما لبث أنْ أعدّ العدّة لإكمال تصوير الجزء الثّاني من “ضيعة ضايعة”، متحلّياً بآداب المهنة والتزامه الأخلاقي تجاهها ولو كلّفه بقية حياته، كيف لا!.. وهو القائل لإحدى تلميذاته: “سطِّري طريقاً مورداً، وإن كان للشوك مكان، سِيري فالألم يجعلك أقوى وأبقى، وإن رحلتِ يوماً، بكَاكِ كلّ من في الأرض والسّماء”.
الصّراخ بصمت!
استحضر في أحد لقاءاته بعد مرضه، ما قاله له الطّبيب أوّل مرّة أخبره فيها بمرضه، بأنّ تلك اللحظات شهدت مرور حياته كاملة أمامه، وكأنّها شريط سينمائي “قلت في نفسي، فيلمي أنا بطله، وعليَّ أن أُنجزه على طريقتي، هناك كلمات يجب أن أقولها، وأشخاص ينتظروني لأتعرّف إليهم وأحبّهم، هناك أدوار لم أمثّلها بعد، الملك لِيْرْ ينتظرني حتى أنضج أكثر، وقبل كلّ ذلك.. طفلاي وليم وآدم، وأمّهما سندس رفيقة الدّرب”.
استؤصلت حنجرة نضال سيجري في مستشفى “أوتيل ديو” في بيروت منتصف حزيران 2011، استئصال الحنجرة، كفيل بأن تكون النّهاية الفنية لحياة أيّ فنان، إلّا أنّ نضال أبدى قدرة كبيرة على مقاومة الصّمت، و واءم حياته على أنْ يصرخ بصمت، ليكون له ما أراد، عبر مشاركته في أربعة أعمال تلفزيونية (الخربة، الأميمي، بنات العيلة، سنعود بعد قليل)، وجميعها كانت من طبيعة الشّخصيات التي تستهوي نضال حسبما أكّد، فلم يحدث فرقاً إن قدّم المسرحي القدير هذه الأدوار التّلفزيونية بصوت أو بدونه، إذ أنّ جميع أدواره فيها تعجّ بالأفعال والتّعابير “الشّكلانية والجوانية”، أكثر من كونها تجسّد حوارات أمام الكاميرا، كما أنّه في مسلسلة “الخربة” عام 2011، عمل إضافة إلى كونه ممثلاً، متعاوناً فنياً مع صديقه مخرج العمل الليث حجّو، كما تعاونا معاً في تجربة سيجري الإخراجية الوحيدة في مجال الشّاشة، إذ أخرج نضال فيلماً تلفزيونياً بعنوان “طعم الليمون” عام 2011 كتابة رافي وهبة وفكرة حاتم علي، ليحقّق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث قدّم حكاية جميلة عن لاجئين فلسطينيين ونازحين جولانيين في مخيم جرمانا، القصة المستلهمة من زيارة أنجلينا جولي وبراد بيت إلى دمشق عام 2009 لزيارة اللاجئين العراقيين؛ وحين كان يُسأل سيجري عن الفرح البادي في عينيه ووجنتيه، يكتب على ورقة: “الكيماوي يصنع منك رجلاً أجمل”.
وطنك في قلب الله
وكان قد أرسل من المستشفى عقب استئصال حنجرته، رسالة طويلة لجمعية “بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسّرطان”، عن حلم دار في رأسه وهو على سرير المرض، بتخيل حوارية تدور بين ملاك وشاب، قال في آخرها: “يأتي من صوب ضوء بعيد كأنّه الشّمس، يقترب الملاك ويسأل ما بك؟ لماذا أنت خائف؟ أهنئك، لقد نجوت هذه المرّة أيضاً، فبكى الشّاب الماكث هناك وقال: ما هي أخبار وطني؟ خذ حصّتي من النّجاة وأعطها لوطني، فابتسم الملاك، وقال للشّاب القابع أمامه: أوّلاً.. لا تعلّمنا ماذا علينا أن نفعل، لكنّ الأهمّ أريد منك ألّا تخاف يا صغيري، لأنّ وطنك في قلب الله”. وختمها بنداء إلى السّوريين، قال فيه: “افرح أيّها الحالم، افرح أيّها المواطن، وطنك في قلب الله، هذا ما قاله الملاك”.
لا تخونوا وطنكم
ها هو صديق الجميع الذي ردّد طيلة حياته بأنّ: “سورية أمنا العظيمة”، يستعدّ لتجربته الإخراجية الثّانية عبر فيلم قصير بعنوان “موت طائش”، إلّا أنّ الطّائش سبقه في ذلك.
كتب على صفحته قبل وفاته: “أيّها الموت .. حتّى أنت لم تكُ عادلاً.. لم تأت ِإلّا على الفقراء في وطني.. الذين استشهدوا في بلدي من عسكريين ومدنيين هم فقط من الفقراء.. الفقراء يقتلون في بلدي.. والأغنياء يتشاطرون بالعدّ والإحصاء والتّحريض”، كما صدحت حنجرته قبل رحيله بفترة قصيرة: “وطني موجوع وأنا أنزف .. بلعومي خانني فاقتلعته، أرجو ألا تخونوا وطنكم”.
ها هو مَنْ قال في آخر مشهد من “ضيعة ضايعة” أمام الكاميرا: “ماعاد فيه أسعد .. بح”، ليقول له فنانو سورية “نحن صوتك”، ها هو يخطّ قبل رحيله بهنيهة: “أين يكمن المهم؟ ما حدث؟ ما يحدث الآن؟ ما سيحدث؟ ومن هو الذي يقرّر أهمية اللحظة؟ تحيا أمنا العظيمة، ورؤوسنا كالأطفال في حضنها، هذا يفوق المهم”.
في الحادي عشر من تموز/يوليو 2013، رحل ابن الثّامنة والأربعين “نضال سيجري” في دمشق؛ حمل أسعد الطّيب ضيعته ومضى، ليوارى جثمانه الثّرى في اللاذقية بعد أن سُجِّيَ على خشبة المسرح القومي فيها حسب وصيته، حيث خطا أولى خطواته الفنية، ومن المسرح اختار آخرها.
بعد عقد على رحيلك “أسرة نص خبر” تقول لروحك: “وداعاً يا أيهاً الحاضر دوماً” .. “وداعاً يا صديقي، يا صديق الجميع”.