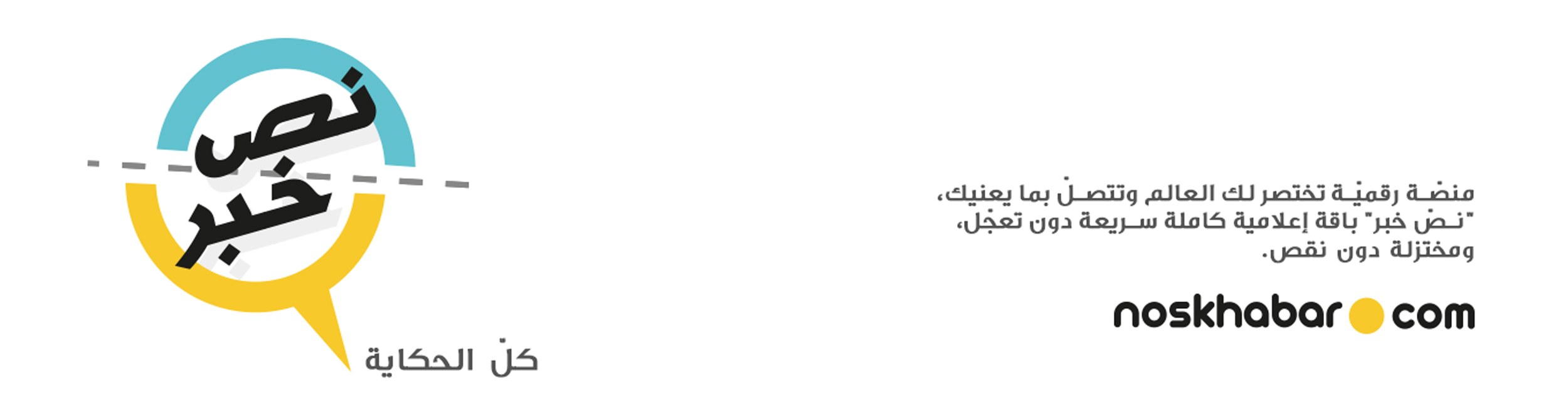12 يوليو 2023
حاوره – سامح محجوب
وائل فاروق ناقد وأكاديمي وشاعر ومترجم مصري يتمتع بصوت نقدي خاص ومختلف جعله يقف على مسافة واحدة من ثقافتين غارقتين فى غابة من المقولات والمفاهيم المتضاربة أقلها توصيف الإنجليزي “كيبلنج”
(الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا)
يعمل حاليًا أستاذًا للدراسات العربية في كلية العلوم اللغوية والآداب الأجنبية بالجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس في ميلانو (إيطاليا) قام بالتدريس في عدد من الجامعات الدولية مثل :
الجامعة الأمريكية بالقاهرة من 2005 إلى 2016 ، ومعهد ستراوس للدراسات المتقدمة في القانون والعدالة (جامعة نيويورك) 2011-2012. نشر العديد من الكتب باللغات العربية والإنجليزية والإيطالية .

•• تعمل وتعيش بين ثقافتين ولغتين لكل منهما مرجعياته التي قد تتوافق وقد تتصادم، فكيف تضبط المسافة بينهما دون أن تقع في فخ الانحياز والاختيار ؟
ينطلق سؤالك يا صديقي من فرضية التباين والتباعد بين الحضارتين التي تقتضي التوافق أو الصدام وتجعل من الانحياز ضرورة بينما يدفعني وعيي الذي تشكل قبل أن تطأ قدمي القارة العجوز وخبرتي الحياتية على ضفاف المتوسط شمالًا وجنوبًا إلى الجزم بلا واقعية هذه الفرضية. هكذا فعل طه حسين منذ مائة عام تقريبًا في كتابه الذي أكد فيه بحسم على الهوية المتوسطية لمصر ويقرر “ليست بين الشعوب التي نشأت حول بحر الروم وتأثرت به فروق عقلية وثقافية وإنما هي ظروف السياسة والاقتصاد” ، وكذلك فعل نجيب محفوظ الذي قال إن الحضارة الغربية ليست حضارة أجنبية وشبهها بشركة مساهمة لكل أمة سابقة أسهم فيها فهي ملك للجميع، وهناك من يرى أن التعددية ثقافية فقط، فالثقافات كروافد النهر التي تأتي من منابع شتى لتصب جميعها في مجرى واحد هو الحضارة الإنسانية، أما الاستعارة الأقرب إلى وعيًا وتجربة فهي للشاعر الإنجليزي روان ويليامز والذي صار لاحقًا رئيسا لأساقفة إنجلترا، الذي يرى أن التنوع الإنساني كالتنوع داخل فرقة الجاز الواحدة، يختلف العازفون وتختلف الآلات وقد يغلب الارتجال على اللحن الموحد ولكن يظل هناك دائمًا انسجام رغم تعدد الأنغام، هذا هو الفضاء الذي أعيش فيه، إيماني باختلافي واعتزازي به هو ما يضمن مكانا لي في فرقة الجاز التي أعتز بها أيضًا وأؤمن بما تبدعه من جمال، وليس الأمر مجرد استعارات أتغنى بها وأرى العالم من خلالها، ولكني عززت هذا بدراسات منشورة باللغات الثلاث التي أجيدها، منها بالعربية دراسة بعنوان “البحر المسكون بالسرد” نشرت في مجلة الجديد، أشير هنا فقط إلى التشابه الشديد في رد الفعل على الحداثة بين مجتمعات الحضارات القديمة على ضفاف المتوسط الشمالية والجنوبية.
إن فقدان الروابط الاجتماعية والأخلاقية القديمة أو التخلّي عنها، وما يترتّب على الرّغبة في المشاركة في النموّ المتسارع للاقتصاد، يقود قطاعات مهمّة من السكان إلى الالتزام بنطاق التغيير الحديث؛ لكن الخطر يكمن في انتشار الأمراض الاجتماعية الناتجة عن ذلك الاندماج القسري على نطاق عالمي. وفقًا لكاسانو، تمثل المافيا بطريقة رمزية ذلك “الهجين المنحرف للحداثة والتقاليد”، حيث يوجد التزام كامل بدائرة ونماذج الاقتصاد الدولي من ناحية، بينما تستمرّ من ناحية أخرى في الحفاظ على صيغ محلية قديمًة للسلطة الاجتماعية، والتي غالبًا ما تشير إلى “تقاليد” لا يمكن تحديدها، تمثل عملية التهجين حالة فريدة جدا تتحدى فكرة التاريخانية، لاسيما تلك التي ربطت بشكل لا ينفصم بين فكرة التقدم والتصور الغائي للتاريخ، فقد كانت منطقة البحر الأبيض المتوسط فضاء استثنائيا لنشر الجوانب المتناقضة للحداثة. في سياق يتّخذ فيه نضج الأفكار خصائص تتباعد باستمرار عن مكوّنات الهجين التقليدية والحداثية، لقد أعادت الحضارات القديمة تشكيل الحداثة بطريقتها الخاصة. فأصبح التهجين بين الحداثة والمحافظة السمة المسيطرة لحداثة هذه المنطقة، وهي حداثة قائمة على إمكانية التعايش بين المنطق والأسطورة، والتقليد والابتكار، والنظام السياسي والثورة. بشكل يجعل المنطق العقلاني الغربي يقف على الجانب الآخر من معقولية البحر الأبيض المتوسط.
هناك قرن كامل من التعايش بين المتناقضات ليس فقط في فضاء المجتمع، وإنما في داخل كل فرد من أفراده قمنا بتحنيطه في إطار الصور النمطية للعلاقة بين “الأنا والآخر” متغاضين عن الشروخ الظاهرة في الأنا، عن تعايش رغباتها المتناقضة داخلها، عن تصارع صورها عن ذاتها، وقد عمقت من هذه الشروخ الشخصيات الروائية التي عبرت البحر بين الضفتين سعيا للالتئام، وساهمت في تطور هذه الحالة من تعايش المتناقضات التي ما زالت تحكم رؤيتنا لذواتنا وللعالم، تمزّق الهوية الذي يعاني منه العربي المعاصر سببه الرئيس والأهم أنه غير فاعل في واقعه، إنّ الفاعلية المبدعة في العلاقة مع الواقع والآخر هي ما يشكل الهويَّة الإنسانية وهي ما يوفِّر الانسجام المفقود بين “الآن” وتاريخه وبين “هنا” ومحيطها، أزمة العقل العربي أنه لا يعيش انسجامًا في الزمان أو في المكان، لا يعيش انسجامًا بين الزمان والمكان، فالأصولي حارس الهويَّة يعيش في الـ”هنا” ويغترب في “الآن” حيث يقيم في الماضي المجيد وأنصار الحداثة يعيشون في “الآن” ويغتربون في “هنا” حيث تهاجر أفئدتهم إلى حيث تريد أن تنتمي هناك في الغرب، العقل العربي )التراثي والحداثي( يعمل إذن بنفس الآلية – مع اختلاف المرجعية – فهو يجعل من المنجز الفكري – تراثي أو حداثي – هويَّة له ينتمي إليها، بدلاً من أن تكون هذه المرجعيات موضوعًا لبحثه ومجالاً لعمله .
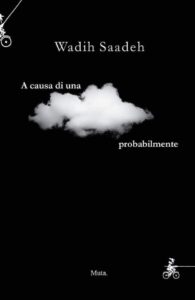
•• من آن لآخر يصحو العالم على حوادث طائفية خاصة ضد الإسلام فى أوروبا كحرق المصحف أو إهانة الرموز الإسلامية. كيف تقرأ هذه الحوادث من وجهة نظر إنثربولوچية ؟!
يهرب الأوروبيون من ماضيهم بشكل دائم، بينما يهرب المسلمون إلى ماضيهم بشكل دائم، فأي حاضر يمكن أن يجمعهم ؟
تركت حربان عالميتان جرحا غائرا في الوعي الأوروبي جعلته يرى في كل محاولة لتوليد أو تحديد معنى للحياة، للإنسان، للمجتمع، للتاريخ؛ استبعادا لما هو خارج هذا المعنى، وهو ما يؤدي إلى تهديد التعددية والسقوط في هوة جحيم الحرب والتدمير مرة أخرى، هكذا سقطت الحكايات الكبرى؛ سقط الدين، سقطت الأيديولوجيا، وأخيرا سقط العلم، خارج إطار الحكايات الكبرى أصبح على كل منا أن يصنع حكايته الصغيرة، ولكنها تولد ميتة لأنها لا تتسع – ولا ينبغي لها – لآخر، لأنها إذا ارتبطت بآخر ستفقد ما يكسبها شرعية وجودها وهي أنها زائلة عابرة، لا أثر لها إلا عدد أيقونات الإعجاب والضحك والحزن على الفيس بوك، فكل ما هو ” كيف إنساني” قد تشيَّأ وتحول إلى “كم” من العلامات لا تسمح للمعنى أن يحول حكايتنا الصغيرة إلى حكاية كبرى وإنما يبقيها أسيرة لنمط يتكرر إلى مالا نهاية .
على الجانب الآخر ترك الاستعمار وما تلاه من تبعية سياسية واقتصادية وثقافية جرحا غائرا في الوعي العربي ، جعله يرى في كل محاولة لتوليد معنى للحياة أو للإنسان أو للمجتمع ترسيخا للذل والمهانة وتهديدا لصفاء الأصل الذي أصبح الإمكانية الوحيدة لغسل عار محبة الجلاد والتشبه به، هكذا أصبح الأصل هو الحكاية الكبرى التي تلتهم الحكايات الصغرى وتحرمها من أي إمكانية لتوليد المعنى، وكيف نولد معنى وكل ما نمارسه ليس إلا تكرار أبدي لأصل مثالي فوق الواقع والتاريخ.
تبدو الحضارة الغربية اليوم كرجل اختار أن يخصي نفسه لأنه لا يريد أن ينجب طفلا شريرا، بينما تبدو الحضارة الإسلامية كرجل يقتل أبناءه الذين لا يشبهون أباه الذي لم يره.
يكذب الأول على نفسه بأنه ليس في حاجة إلى أبناء ولا يكترث للمستقبل ويكذب الثاني على نفسه بأن تشبُّه الأبناء بالأب الغائب سيعكس اتجاه الزمن، يكذب الأول على الآخرين حين يحاول أن يقنعهم أن قيمه النبيلة لا أصل لها ولا تاريخ، ويكذب الثاني على الآخرين حين يحاول أن يقنعهم أن قيمه النبيلة مازالت حية وأنها ليست مجرد قناع يخفي تفسخه الأخلاقي وانحداره الإنساني .
أزمة العقلانية والقيم الإنسانية لا تمسك بتلابيب العقل العربي وحده، العقل الأوروبي ومنذ عقود يعيش أيضًا أزمة حادة. في ثلاثينيات القرن الماضي قدس اليابانيون هيروهيتو الامبراطور الإله الذي قادهم إلى تحقيق نهضة اقتصادية وبناء قوة عسكرية مكنتهم من السيطرة على مساحات واسعة من العالم، بعد الهزيمة المخزية لليابان في الحرب احتفظ الإمبراطور بقداسته، إلا أنها كانت قد فقدت معناها ليس فقط لأن الإمبراطور قد تحول إلى مجرد ديكور ولكن لأن الإمبراطور الإله قد قاد شعبه إلى تدمير بلاد الآخرين قبل أن يدمر بلاده نفسها.

هكذا بدأ اليابانيون يطلقون عليه اللاشيء المقدس. اللاشيء المقدس هي أفضل عبارة نصف بها الآليات والشروط التي تمارس بها قيم الحضارة الغربية اليوم، حيث يتم تفريغ هذه القيم من معناها بالرغم من تقديس الجميع لها، مثل قيمة الحرية التي أصبحت لأوّل مرّة في التاريخ خبرة جماعيّة، حيث ينظر إلى الحرية اليوم على أنها انفتاح على المطلق، على المجهول، وهو ما يجعلها محاولة دؤوبة للانسلاخ من الواقع، لم يعد التحرر مجرد فعل يهدف التخلص من القيود الاجتماعية أو السياسية أو القانونية، وإنما سعي للانعتاق من كل روابط الماضي والحاضر، ليست الحرية إذن دفاعا عن معنى نؤمن به للحياة، أو هوية نراها محدِّدة لوجودنا، الحرية اليوم هي التخلص من هذه الأشياء التي ترسم حدودا للذات وتحد من الانفتاح على اللاشيء، على ذلك الذي لم نعرفه بعد، وبالتالي نحن عاجزون عن تسميته، ولماذا يجب أن ننشغل بالأسماء ونحن نعيش في عالم ما بعد الأسماء؛ مابعد الحداثة، ما بعد الصناعة، ما بعد الكولونيالية، مابعد التاريخ، وأخيرا ما بعد الحقيقة!
هذه النزعة نحو اللاشيء يغذّيها على السواء الجناح الفكري السياسيّ اليساريّ الذي يرفع شعار “أنا مشرِّعٌ لنفسي”؛ و كذلك الجناح الفكري السياسي اليمينيّ الذي يختصر دفاعه عن الحرية في شعار “تتّسع حرّية كلّ امريء بمقدار ما تتعدّد الخيارات المطروحة عليه” وبالطبع لا تتسع الخيارات دون التحرر من التحيزات التي يتسع مفهومها ليشمل كل مفردات الذات والواقع الذي نعيش فيه، ومرة أخرى نحن لا نتحدث هنا على المستوى النظري وإنما عن ممارسة يومية في حياة الأشخاص العاديين، فمثلا سألت أحد مدارس إقليم فينيتو وعاصمته مدينة فينسيا، أولياء أمور الطلاب إذا كانوا يوافقون على خضوع أبنائهم لاختبارات تساعدهم على التعرف على هويتهم الجنسية؛ وعندما سأل أحد أولياء الأمور عن ماذا يقصدون بكلمة هوية، قيل له: نحن نولد ذكور وإناث ولكننا نكون رجالا أو نساء حسب اختيارنا، كما تعرف “الرجل” و”المرأة” وغيرها ليست إلا مفاهيم ثقافية لدينا مطلق الحرية في قبولها أو رفضها. لست بصدد إصدار أي حكم أخلاقي هنا ولكنى أرصد فقط هذا الفهم للحرية بوصفها “انفصالا”، بوصفها حالة من الرفض الأوديبيّ ليس فقط للأب والتراث وإنما للواقع كذلك، ليصبح – في إطار هذه النزعة – الحديث عن تحقيق الذات مجرد انفتاح ساذج تجاه جديد مجهول، كثيرا ما ينحدر باتجاه السخيف والمُنافي للعقل. إنّ حريّة مطلقة – أي منفصلة عن كلّ شيء – تنتهي بهذا الشكل إلى ذلك “الهراء السامي” الذي يتحدث عنه إيزكس، أو تنتهي، في شكلها الأدنى، إلى الاكتفاء بملذّات صغيرة متسلسلة تحاول أن تُشبع ذاتيّة لا أساس لها.
التقدم الملحوظ في كل استحقاق انتخابي للأحزاب الشعبوية – المعادل السياسي لثقافة البوب – يؤكد سوء مآل نضالات ما بعد الحداثة، فقد ناضلت ما بعد الحداثة ضد ” إقصاء” الحداثة للآخر “المختلِف” بدعوى التفوق العرقي أو الثقافي ولكنها لم تجد طريقا لهذا إلا “إقصاء” الاختلاف، الذي غيب الثقافة بشكل عام، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية الجماعات والثقافات المهمشة كالمهاجرين، حيث تراجعت دعوات إخراجهم من الهامش أمام الدعوات الشعبوية لإخراجهم من المجتمع. ولعل هذا يفسر تلك الحوادث التي أشرت إليها في سؤالك والتي تسيء لأوروبا قبل أن تسيء لمعتقدات المهاجرين المهمشين.

•••تحدثت في أكثر من مناسبة عن الأدب العالمي والأدب المعولم، وهذا يستدعي أن أضبط معك هذه المصطلحات للاقتراب أكثر من معياريتها ؟! وكيف ترى حضور الأدب العربي عالميًا في ظل ما شهده العالم في العقد الأخير من ثورة هائلة في الاتصال والتواصل ؟!
تشير الأرقام إلى أن المساحة التي يشغلها الأدب العربي في العالم تتسع باضطراد ولكن هذا لا يعني أن الأدب العربي قد صار عالميًا، فالعالمية لها شروط أخرى تفصلها نادين جورديمر- الجنوب أفريقية الحائزة على نوبل 91 – في معرض دفاعها عن التهميش الذي يتعرض له محفوظ وشينوا أتشيبي وعاموس أوز، تقول : ” على الرغم من مواهبهم الاستثنائية، فالثلاثة من الرموز البارزة للأدب المعاصر في اللحظة الراهنة، وعلى الرغم من حصول محفوظ على نوبل، وعلى الرغم من أن أعمال أتشيبي تدرس في كل جامعات العالم، وعلى الرغم من أن أعمال عوز تقرأ بست وعشرين لغة مختلفة، فإن هؤلاء الكتاب الثلاثة لا يتم تناول أعمالهم أبدا من قبل الباحثين في الأدب خارج قاعات الدرس وأطروحات التخرج، ونادرا ما يتم ذكرهم بين أهم الأدباء في العالم اليوم، فهم لم يبثوا الروح في الظاهرة التي يبدو أنها العلامة التي لا تقبل النقاش في الغرب على الشهرة والقيمة الأدبية، وهي أن يكونوا موضع تقليد الكتاب الأصغر، هكذا ظل حضورهم في أوروبا محصورا في كونهم ممثلين لذلك العالم الذي يقع خارجها”. العالمية إذن ليست أن نشغل المساحة المخصصة لنا في العالم بوصفنا “الغرائبي” جغرافيا وعرقيا وثقافيا، العالمية هي أن نوسِّع مساحة العالم، وبقدر ما نزحزح حدوده الجمالية نكتسب وجودنا الأصيل فيه، لا نكون ضيوفا على الآخرين فيما ابتكروه ولكننا نفتح بابا جديدا للوعي بالذات والعالم، ليس انتشار الأدب العربي دليلا على عالميته، بوصفه خالقًا للعالم.
الأدب العربي معولم لأن انتشاره خاضع بشكل أساسي لقواعد السوق والاستهلاك السريع، وليس في كلامي هذا أي مبالغة فلحظة المد الثانية بعد فوز محفوظ بنوبل في انتشار الأدب العربي في الغرب كانت الحادي عشر من سبتمبر ولم يكن بطلها هذه المرة كاتبا وإنما إرهابيا هو أسامة بن لادن، يتم استدعاء الأدب العربي لإشباع فضول لحظة ” الحدث” الذي سرعان ما يفتر مع انشغال العالم بحدث في مكان آخر، ثم يعود الاهتمام مع عودة العالم العربي إلى صدارة نشرات الأخبار إليه مع حدث مثل الربيع العربي، لنظل رهن الاستدعاء، ليتقزم الأدب العربي وكاتبوه من منتجين للمعنى وللمعرفة الجمالية التي تدفع بالوعي الإنساني نحو قيم الخير والحرية والعدالة إلى مجرد شاهد عيان على واقع غرائبي يتبرأون منه.
لقد رأيت بنفسي أسماء كبيرة وصغيرة في عالم الكتابة تتطوع للقيام بدور المحلل السياسي والاجتماعي والنفسي لمجتمعاتهم الموبوءة بالدكتاتورية والتخلف الاجتماعي والتدني الإنساني، وعلى الرغم من أنهم قلة محدودة إلا أنهم احترفوا التجوال في أوروبا التي لم تعد بالنسبة لهم أفقًا جماليًا يتحاورون ويتفاعلون معه لإنجاز طرحهم الجمالي وإنما جمهور سوق علينا الانتباه إلى حاجته للتسلية بغرائبتنا السياسية حيث الكتابة عن عوالم الدكتاتورية، أو الحريم، أو المثلية الجنسية، أو غيرها مما يشيع الاهتمام به في وسائل الإعلام الغربية.
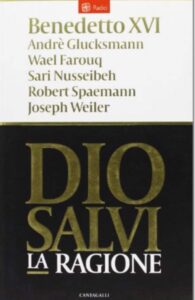
إن هذه الظاهرة بالطبع جزء من التوجه العولمي لتسليع الأدب في كل مكان، والذي يتجلى في ظواهر مثل الأكثر مبيعا التي تتسق مع مجتمع ما بعد الحقيقة، المجتمع الأفقي، حيث احتل الانتشار المكانة التي كانت محفوظة لوقت طويل للعمق في سلم القيم والمعايير، وعلى حين يوفر الجهد الأكاديمي والتنظير الجمالي نوعا من التوازن في السياقات الأخرى بين العمق والانتشار فإننا في حالة الأدب العربي نفتقد لهذا التوازن حيث دأب النقد العربي على اجترار المقولات النظرية للآخر دون إضافة حقيقية لها، كما دأب الأكاديميون الغربيون على إهمال ما هو جمالي في الأدب العربي، والتركيز عليه كمادة للبحث الأنثروبولوجي، يكفي أن نلقي نظرة سريعة على أطروحات الماجستير والدكتوراة في أرشيف أي وزارة للتعليم العالي في أوروبا لندرك ذلك، فنجد من يتحدث عن إرهاصات الربيع العربي في أعمال محفوظ، الحرية والثورة في رواية الكرنك، الجريمة في روايات نجيب محفوظ، وهي كلها دراسات تبحث في الأدب عن أي شيء إلا ما يجعله أدبا.
هكذا نرى اليوم أن المساحة التي غزاها الأدب العربي بعد نوبل محفوظ في الفضاء العام أصبحت رهينة ما يقع من أحداث ساخنة، أما المساحة التي غزاها في الجامعة فلم تعد تهتم به كأدب ولكن كمادة للبحث في سياق علوم أخرى، وأما الرهان الذي يعلقه الكثيرون على ثقافة ما بعد الحداثة، المعادية للمركزية والرافضة للتهميش، في صناعة هذا التوازن فإنه لا يبشر بالكثير، فالسعي ما بعد الحداثي للخروج من الهامش لا يتوقف عند تدمير المركز المسيطر وإنما يمتد لتدمير أي إمكانية لظهور مركز جديد، الغياب التام للمركز هو الضمانة الوحيدة لعدم العودة للهامش. نحن نبالغ كثيرا في الحماس لمابعد الحداثية عندما نعتقد أنها ستحرر العالم من المركزية الأوروبية وتضفي المشروعية على “جماليات” الثقافات المغايرة لها، حيث يمضي واقع ممارساتها الثقافية في الاتجاه المعاكس، فعدم السماح بظهور مركز جديد يرسخ في النهاية المركز القائم الذي يستمر في ممارسة سلطته غير المباشرة في ترسيخ صورة نمطية لما هو خارجه، فمازال نجاح الأدب العربي في المجتمعات مابعد الحداثية مرهونا بقدر ما يحتويه مضمونه من غرائبية ثقافية أو اجتماعية.
عادة ما يقدم الابداع نفسه بوصفه تجليًا لوعي مؤرق بأسئلة الجمالي في إطار اشتباكه مع الواقعي، وعي متمرد على كل الثوابت التي يمكن أن تحد من حريته في اكتشاف آفاق الذات وعالمها، وعي ثائر على كل الحكايات الأيديولوجية الكبرى التي يمكن أن تعرقل قدرته على الاستجابة لعالم يتغير بسرعة فائقة، ويخلق شروطا فيزيائية واقتصادية واجتماعية وسياسية تفرض علينا يوميا أن نعيد اكتشاف الإنسان والإنسانية؛ هل يجد هذا الإبداع وهذا الوعي مساحة كافية في إطار التلقي الغربي، أم أنه سيتعرض دائما للإقصاء كلما حاول التمرد على إطار الغرائبية التي يتم صبه في قالبها.
إن الانتشار الذي يعتقد الكثيرون أنه خروج من الهامش وانفتاح على العالم ليس إلا المظهر الأكبر – في إطار هذه الشروط – للتهميش.