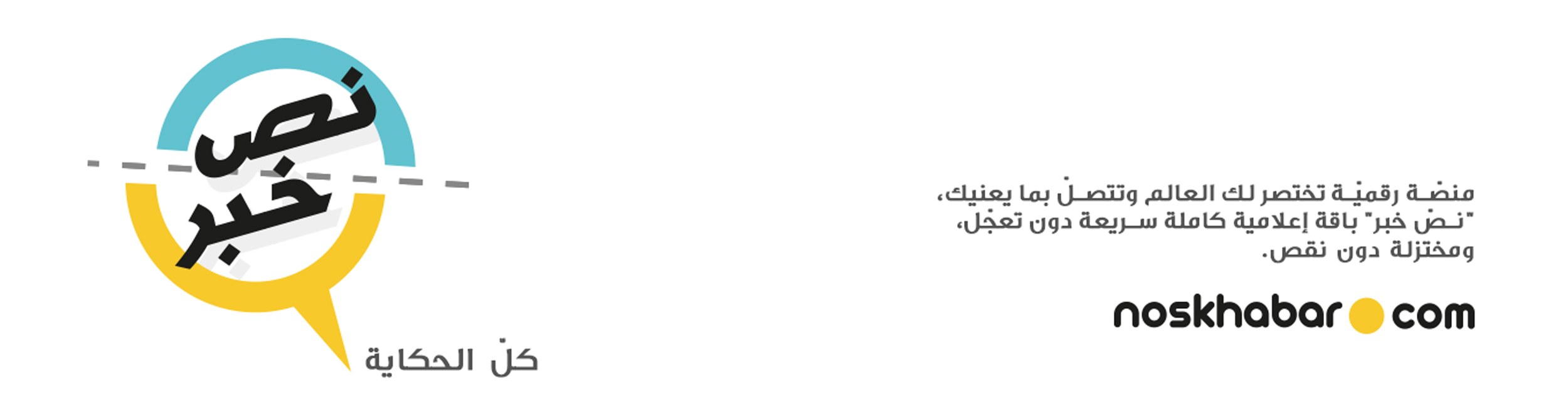“نص- خبر” متابعة
في خلال 5 سنوات فقط، من 2018 إلى 2023، وبحسب موقع “بودكاست إندكس” (Podcast Index)، تضاعفت أعداد البودكاست في العالم من 197 ألفا إلى نحو 4 ملايين بودكاست، مع شريحة جماهيرية تتجاوز 80 مليون مستمع أسبوعيا ليس في العالم كله، ولكن في الولايات المتحدة وحدها.
وبالانتقال إلى وطننا العربي، سنجد أن موقع البودكاست العربي يخبرنا أننا نمتلك نحو 1400 برنامج بودكاست، وهي إحصائية قابلة للتزايد الكبير. لكن مع هذه الإحصائية وغيرها، ومع اتساع جاذبية البودكاست لكل من المنتجين والمستقبلين، هل يمكننا أن نسأل عن حصيلة المعرفة التي تركها هذا الإنتاج؟ أو بالأحرى: هل يمكننا أن نرى مفارقة واضحة في عدد المستمعين إلى البودكاست الذي يُصدّر عادةً في ثوب المحتوى المعرفي الهادف، وعدد القارئين الجادّين؟
بحسب اليونسكو، فإن الطفل العربي يقرأ 7 دقائق في كل عام، بينما يقرأ المواطن العربي بوجه عام نحو ربع صفحة في السنة، وهو معدّل متناسق بعض الشيء مع تراجع الإنتاج العلمي في العالم العربي لنحو 1650 كتابًا سنويا[2]. بينما لو عدنا أدراجنا نحو البودكاست سنجد أن نسبة مستمعي البودكاست من منصة “سبوتفاي” ترواح بين 26% إلى 39% من إجمالي مستخدمي “سبوتفاي” العرب، بمعدّل زيادة بلغت في عام 202 فقط نحو 2870%، لكن الإحصائية الأكثر لفتًا للانتباه هي أن قرابة 40% من هؤلاء المستمعين كلهم ينتمون إلى الجيل زد[3] (المولودين بعد عام 1996) وهو ما يعني أننا أمام جيل بات يسمع أكثر مما يقرأ؛ لنجد أننا أمام مفارقة مذهلة بين إحصائيات القراءة وإحصائيات الاستماع تجعلنا نسأل: هل ستنحصر القراءة وينقرض الكتاب أمام من الورقة إلى الشاشة
وغي السياق نفسه ذكر موقع الجزيرة نت انه وفي بدايات القرن الماضي، أعلن الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين عن نظريته التي يعرفها الجميع: “النسبية”، ليخبرنا من خلالها عددًا من المعلومات الكونية، من بينها أنك لو اخترت توأمين، وأرسلت أحدهما إلى الفضاء وأبقيت الآخر على الأرض، فإن الأخ الفضائي عند عودته إلى الأرض سيجد أخاه الأرضي في عمر جدّه بينما هو لا يزال في طور الطفولة.
لنترك الآن أينشتاين جانبًا، ونستأذنه أن يترك لنا “نسبيته” وتوأميه لسياق آخر، سنطلق فيه على التوأم الأول “الأخ الورقي” بينما سنسمّي الآخر “الأخ الرقمي”، ونعود إلى الثمانينيات لنبدأ تجربتنا. في تلك الحقبة سنترك الأخ الورقي مكانه، بينما سنستقل آلة الزمن ونسافر بالأخ الرقمي 5 عقود إلى المستقبل.سمّاعات الأذن وشاشة الهاتف؟
في الثمانينيات، يجلس الأخ الورقي في غرفته أمام كتاب يقرأه، فتتدفق المعلومات نحوه في اتجاه واحد؛ من الكاتب إلى القارئ فقط. أما في زمننا الراهن فإن الأخ الرقمي يقرأ قراءة تفاعلية في اتجاهين، فبمجرد أن ينتهي من كتابه يذهب إلى موقع “غود ريدز” ليترك تعقيبه الخاص على الكتاب وعدد النجوم التي يقيّمه بها، وسيكتسب بالطبع زخمًا أكبر عند قراءة التقييمات الأخرى، أو يذهب إلى حساب الكاتب بموقع “فيسبوك” ويخبره بتعليقه مباشرةً ويتفاعل معه الكاتب في نقاش مثمر، أو ربما يصنع مقطعًا مصورًا على “يوتيوب” لتلخيص الكتاب للآخرين واستخلاص الفوائد وتسجيل الملاحظات. وتلك كلها حسنات تجعل كفّة الاستفادة للأخ الرقمي أثقل من أخيه الورقي.
لكن هل هذا هو ما يحدث على الحقيقة؟ أو بكلمات أدق: هل هذا ما يحدث دائمًا؟ هنا نعود إلى الكاتب الأميركي نيكولاس كار وكتابه “السطحيون.. ماذا فعل الإنترنت بأدمغتنا؟”؛ لنكتشف أن الواقع يختلف اختلافا كبيرا عن تلك الصورة الوردية للتقدم الرقمي.
فمن خلال كار سندرك أن الأخ الورقي كان يجلس في غرفته مع كتابه الكلاسيكي، وحيدين لا ثالث لهما، يقرأ ولا يفعل شيئًا إلا القراءة، حتى إذا انقضت الساعات المحددة لذلك أغلق الكتاب وذهب ليقضي شأنًا آخر. أما الأخ الرقمي فيجلس مع كتابه الإلكتروني على حاسوبه النقّال، لكن المفاجأة أن ساعات القراءة تلك لا تنتهي، ليس لشغف هذا الأخ بالقراءة، ولكن لأنه لا يقرأ من الأساس.
ففي عالم الأخ الرقمي تشبه عملية القراءة قطة شرودينجر الحية الميتة في الآن ذاته؛ فالأخ يقرأ ولا يقرأ لأنه يوزِّع وقته وانتباهه وتفاعله بين كتابه، وصندوق بريده الإلكتروني، وإشعارات حساباته على مواقع التواصل، ومدة التنزيل المتبقية للعبته المفضلة، والبحث عن فيلم مناسب للسهرة… إلخ. هو يمتلك قدرات تفاعلية أكبر من أخيه، ومن ثم فرصة أكبر لتحقيق استفادة أعظم، ولكنها قدرات نظرية معطّلة على عتبة الواقع الرقمي المُشتِّت.
ففي كتابه المذكور، يخبرنا كار -المولود في عام 1959- أنه في عام 2007، وبعد عقد كامل من الانخراط في عالم الإنترنت، وجد أن ما كان يظنه نعمة كبيرة لذكائه بات نقمةً لقدراته العقلية بشكل لا يصدق؛ فلم يعد قادرًا على الكتابة الطويلة أو الانخراط في عملية بحثية عميقة ومعقدة، وأنه بعد البحث والسؤال لم يكن الوحيد الذي يعاني من ذلك، وإنما وجد عددًا من بني جيله من الكتّاب والمدوّنين يعانون الأمر نفسه؛ لقد جعلهم الإنترنت أقل صبرًا على القراءة.
وفضلا عن ذلك، يتخوف الصحافي الباحث بجامعة هارفارد جون بوهانون من وجود تأثيرات “إنترنتية” وخيمة على عقولنا وإدراكنا للمعرفة؛ إلى درجة رأى فيها نفسه أنه من دون غوغل وويكيبيديا “غبي، وليس مجرد جاهل”[7]. وقد استندت مخاوف بوهانون تلك إلى تجارب الباحثة بيتسي سبارو ومعاونيها من جامعتي هارفارد وويسكنسون التي نُشرت عام 2012.
في تلك التجربة[8] أتى الباحثون بمجموعة من متصفحي الإنترنت، وطلبوا منهم قراءة بعض الجمل البسيطة مثل “عين النعامة أكبر من دماغها”، وطلبوا من الفريقين حفظ جملهم. لكن لمزيد من الإثارة أقنعوا الفريق الأول أن الجملة التي قرؤوها ستظل محفوظة على ملفات يمكن الرجوع إليها لاحقًا، أما الفريق الثاني فأخبروه أن تلك الجملة ستمحى إلى الأبد بمجرد قراءتهم لها، لتأتي النتيجة بما يمكنك أن تتوقعه: نسي الفريق الأول جملته، معتمدًا على سهولة استرجاعها -تمامًا كما نفعل مع الإنترنت- بينما أعاد الفريق الثاني تنشيط ذاكرته البشرية المعطّلة واستجمع انتباهه المتراخي ليحفظ جملته بحرفية شديدة.
وذلك يقودنا إلى استنتاج بحثي آخر لخبير النماء الدماغي براين كولب[9] الذي يقرّ بأن تغير الدماغ لا يكون فقط عن طريق الجينات، وإنما بفعل عمر كامل من الخبرات والتجارب التي تعمل على تغيير نشاط الدماغ السلوكي. ومن هنا، يمكننا أن نفهم شيئًا عن سبب تشتتنا عند المذاكرة أو القراءة الرقمية، وفقًا للعبارة الساخرة الدارجة -بأساليب مختلفة- على منصات التواصل الاجتماعي: “أمسكت هاتفي لأسمع تسجيلات المحاضرة فوجدتني أشارك الميمز وأنهي ساعات من مقاطع الريلز”.
لكن لأن الإنترنت والشبكات الاجتماعية أغرقانا في سيل عرم من المصادر والمراجع، والروابط المتشعبة، والفيديوهات المقترحة، والمنشورات المتشابهة، فإن هذا أغرقنا في بحر آخر من المحتوى الهش السريع الذي لا يحتاج إلا انتباه الإنترنت المشتت الخاطف.
مشاركة سابقة
المشاركة التالية