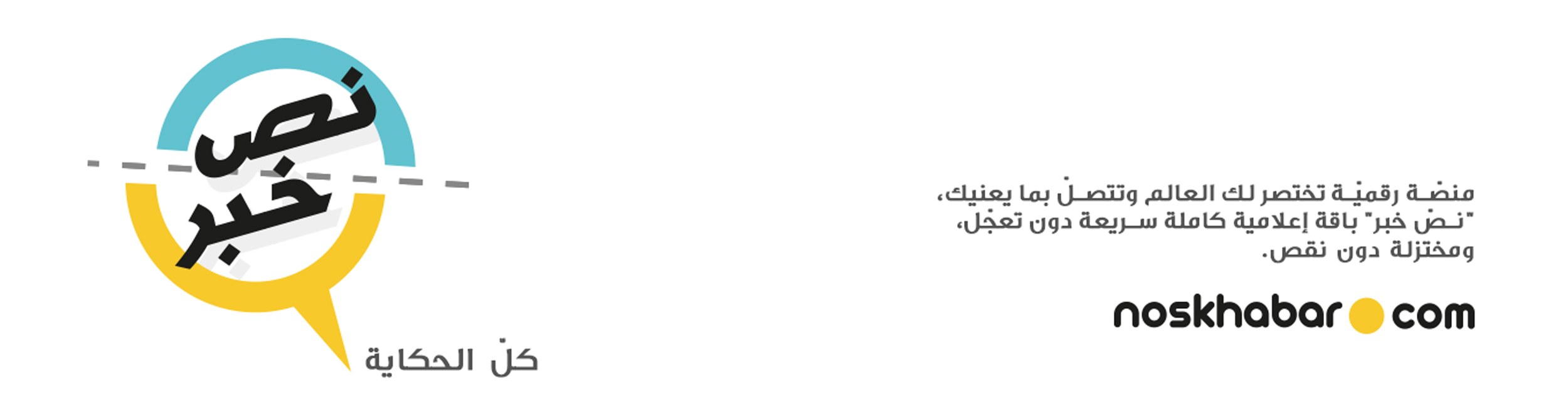جمال سامي عواد – كاتب وناقد موسيقي سوري
هل من الغريبِ حقاً أن يحسّ شخصٌ عربيٌّ لا يعرف الألمانيّة بما يقوله”هتلر” في أحدِ خطاباتِهِ الحماسيّة؟ أو يبتسم ابتسامةَ الرّضا لدى مشاهدتِهِ خطاباً “لهوغو تشافيز”، مع علمنا بأنّ معرفته باللاتينية معدومةً تماماً؟ أو يتعاطف مع “فيديل كاسترو” عندما يُشبِع الأثير بتلك الطّاقةِ الثّوريّة والانفعاليّة المحبّبة؟ واستطراداً، يمكننا أن نتساءل أيضاً عن سرّ إعجاب شخصٍ بأغنيةٍ أجنبيّة، بدون أن يكون ملمّاً بأبسط مبادئ لغةِ تلك الأغنية.
إذا اتّفقنا على أنّ سرّ الإعجاب في حالةِ الأغنية، يكمُنُ في اللحنِ والصّورةِ الصّوتية والإيقاع، أي في الموسيقا، فأين يكمُنُ السّرّ في الأمثلة التي قبلها؟
أزعم أنّ الموسيقا هي السّرّ هنا أيضاً، وأيّ تفسيرٍ آخر لهذه الحالة سيكونُ مبنيّاً على فهمٍ آخر للموسيقا، يعاني من اختزالها إلى مجرّدِ العزفِ والغناء بتعريفهما التّقليدي. فهل الغناء والموسيقا هي فقط تلك الأصوات التي تُصدرها حناجرُ البشرِ؟ أو الآلات الموسيقيّة بطريقةٍ مصنّفةٍ علميّاً؟
بدايةً يجبُ أن أوضّح أمراً مهمّاً قد لا يعرفهُ البعض، وهو الفرقُ بين شدّةِ الصّوت، وطبقةِ الصّوت، وكيفيّةِ أو تقنيّةِ إخراجِ الصّوت. فهذه أمور يعرفها الموسيقيين جيّداً، ولكن قد لا يعرفها البعض رغم ممارسته لها، وهذا أمرٌ غير مُعيب، وهو طبيعيٌّ جداً بقدر ما هو طبيعيٌّ عدم معرفة شخص لآليّة التّوازن المعقّدة أثناء المشي، رغم أنّه يقوم بفعلِ المشي.
قد يمارس البعض الموسيقى دون تمام المعرفة، تماماً كما نمارس المشي دون وعيٍ بآليته .
“شدّةُ الصّوتِ” صفةٌ تحدّد قدرة الصّوتِ على الوصول إلى مسافاتٍ أبعد، وقد يستطيع مكبّر الصّوت أن ينقل همساتٍ خفيضةٍ لمسافاتٍ كبيرةٍ عن طريقِ مضاعفةِ الطّاقة التي تحملُ تلك الهمسات.
أمّا “طبقةُ الصّوتِ” أو ما يُسمّى “تون” فهو التّردّد الذي تهتزّ به الأجزاء المختصّة بإصدارِ الأصوات، وهو أمرٌ معروفٌ فيزيائيّاً بأنّه يحدّد موقع الصّوت بين طبقةٍ دُنيا غليظة، وطبقةٍ عُليا حادّةٍ ورفيعةٍ، وصولاً إلى درجةِ الفوق صوتيّة، ولا شكّ في أنّه يُمكننا تغيير طبقة الصّوت بدون أن نضطر إلى تغيير شدّة الصّوت وفق ما تمّ شرحه أعلاه.
وفيما يخصّ “تقنية إخراج الصوت” فهو أمرٌ يضيف تنوّعاً مذهلاً إلى الظّاهرةِ الصّوتية، وقد يستخدمُ الميزتين المتعلّقتين بالشّدّةِ والطّبقةِ معاً أو بشكلٍ منفصلٍ، إضافةً إلى أمورٍ أُخرى، كأنْ نقول عبارةً واحدةً بأكثرِ من وضعيّةٍ للفكّين أو اللسان أو الشّفتين وأيِّ عنصرٍ من عناصرِ إصدار الصّوت .
بعد هذا التّوضيح، يمكننا أن نتّفق على تعريفٍ مبدئيٍّ للغناء بأنّه عمليّةٌ فنيّةٌ جماليّةٌ يتمّ من خلالِها إصدارُ الأصواتِ باستخدامِ العناصرِ الثّلاثة السّابقة، بما يخدم هدفاً فنيّاً جماليّاً مع مرافقةٍ صوتيّةٍ آليّةٍ (من الآلات الموسيقيّة) أو بدونها.
وهنا تبرزُ جملةٌ من الأسئلة :
هل ما فعله “هتلر” أو “شافيز” أو “كاسترو” في الأمثلةِ السّابقةِ هو غناء؟ وإلى أيّ حدٍّ تدخل تِقَنيّات الغناء المذكورة أعلاه في حياتِنا اليوميّة؟ وما هو دورها وأثرها في عمليّةِ التّفاعلِ الاجتماعي؟
أسئلةٌ مبرّرةٌ إلى حدٍّ كبيرٍ، وأجوبتها تطرح بقوّةٍ إشكاليّة تصنيف أحاديثنا وسلوكنا في فئة الفنّ الموسيقي الغنائي والمسرحي. فإحساسنا بما يقوله “هتلر” بدونِ أن نفهمَ ما يقوله، هو عمليّةٌ معقّدةٌ جداً! ولكن إذا أردنا تبسيطَها فيُمكننا القول أنّها تعتمدُ على بعضِ المعلومات عن هتلر وألمانيا في عهدِهِ، مضافاً إلى ذلك الطّريقة التي استخدمها ومثّل بها دوره على “المسرحِ الغنائيّ الواقعيّ”، وهي التي كان لها الدّور الأبرز في امتلاكِ إحساسِنا، لأنّها خاطبت نمطاً مشابهاً كامناً أو ظاهراً لدينا، ولكنّه بالتّأكيد يستندُ إلى تشابهِ البشرِ عموماً في الكثير من الأمور الأساسيّة .
فهل هناك من لم يلاحظ ويتأثّر بما يقوله هتلر على المنبر؟
الرّجل بكلّ بساطةٍ قال كلاماً بمضمونٍ معيّنٍ، غيّر طبقةَ صوتِهِ في مواقعٍ محددة، ونوّع من شدّةِ الصّوتِ لديه في مواقعٍ أُخرى أيضاً، كما أنّه استخدم تِقَنيّاتٍ مختلفةٍ لإخراجِ الصّوتِ تتناسب مع المضمون، هذا إذا أهملنا عناصراً موسيقيّةَ ومسرحيّةَ أُخرى مثل الحركات، والضّرب على الطّاولة، والإيقاع الواضح في بعضِ مقاطع الكلام، وأصوات الجمهور، واللباس والتّسريحة وشكل الشّارب، والموسيقا المُرافقة في بعضِ الحالات النّادرة .
والعناصر ذاتها، توافرت في ما فعله الرّجلان في المثالين الآخرين، حيث لا يمكن لأحدٍ تجاهل الطّريقة المؤثّرة لدى “تشافيز” أو “كاسترو”، والطّريقة التي يُخرِجُ بها هذين الشّخصين أصواتَ لغتهما المميّزة أساساً بصورتها الصّوتيّة. .
نتأثر بخطاب هتلر دون أن نفهمه!
لا شكّ أنّ هؤلاء كانوا مغنّين وممثّلين بارعين جداً في “المسرح الغنائيّ الواقعيّ”. ولا بدّ أن نضيف إلى هذهِ الباقة من الفنّانين أُولَئِكَ المعلّمين الذين طالما اجتذبوا طلّابهم بطريقةِ حديثهم التي جمعَتْ بين التّغييرِ بالطّبقةِ والشّدّةِ وتقنيّة إخراج الصّوت، وزاوجَتْ بين هذه العناصر وبين الإشارةِ أيضاً والتّعبير بالوجهِ ولغةِ الجسد بما يتناسب مع مضمون الكلام. ولن ننسى أيضاً جيشاً من الخُطباءِ والمفوَّهين الذين تأْسُرُنا طريقتهم بالحديثِ، بغضِّ النّظر عن المضمون، كما لا يُمكن نسيان الكثير من الشّعراءِ الذين لا تقلّ طريقتهم في الأداءِ أهميّةً عن غناءِ الكثير من المطربين، حتّى أنّ بعضهم ينزلق بدون انتباهٍ إلى الغنائيّةِ في الإلقاء، كما يحدث مع مظفّر النّواب مثلاً. يبقى بعد ذلك أن يعجبنا “غناء” هؤلاء أو لا يعجبنا، فهذا أمرٌ آخر يكون البحث فيهِ أكثر تعقيداً من بحثِ عمليةِ إنتاجِ الموسيقا، لأنّ عوامله تتعقّد بطريقةٍ مستحيلةِ الضّبطِ والتّصنيف. .
شِئْنا أم أبينا فنحنُ مضطرون للغناء! لأنّنا ببساطةٍ شديدةٍ لا يمكن مثلاً أن نقول لشخصٍ يُعِيقُ سيرنا: “هل تسمح لي بالمرورِ من فضلك؟” بدونِ أن نرفع من طبقةِ الصّوت (الطّبقة وليس شدّة الصّوت) في آخر الجملة، حتّى نوحي له بصيغةِ الاستفهام، لأنّ فعل العكس (أي جعل نهاية الجملة منخفضةً بالطّبقةِ عن طبقةِ ما يسبقها من كلمات) سيفعل أثراً معاكساً تماماً لرغبتنا بالتزام اللياقة والأدب، في التّحدّث مع الآخرين وطلب الأشياء منهم، لأنّ سؤال شخصٍ بأن يفعل لنا شيئاً، بدون رفع الطّبقة في آخرِ الجملة يوحي بصيغةِ الأمر، وقد يُفهَم بأنّه سُخريَة تستخدم كلاماً لطيفاً بنبرةٍ آمرةٍ. كما لا يُمكننا أن نعبِّر بصدقٍ عن خبرٍ حزينٍ جداً بنغمةٍ صاعدةٍ ومصطنعةٍ تقنيّاً، فالكلام الحزين سيخرج من حنجرةٍ امتلكَتْ بالكادِ طاقةً لإخراجِ الصّوت، وبالتّالي فالكلام حتماً سيكون منخفضَ الصّوت نسبيّاً، مع عجزٍ مُتَوَقَّعٍ عن إخراجِ الصّوتِ بشكلٍ صافٍ، ممّا يجعله متهدّجاً أو متقطّعاً، وقد يصلُ الأمر إلى العجزِ تماماً عن الحديث، بما لذلك من طاقةٍ تعبيريّةٍ شديدةٍ جداً، وهو أمرٌ يحدث في الغناءِ أيضاً.
ولمزيدٍ من التّأكيد، لا يُمكننا أيضاً تخيّل خطابٍ غاضبٍ يستخدمُ صوتاً خفيف الشّدّة وبطبقةٍ منخفضةٍ، وبدونِ الضّغطِ على مخارجِ حروفٍ معيّنةٍ أو التّشديد على كلماتٍ محدّدةٍ في الحديث! وعجزنا عن تخيّل ذلك يشبهُ إلى حدٍّ بعيدٍ تخيّل شخصٍ يتحدّث عن الصّعودِ إلى الأعلى، بينما يُشير بسبّابتِهِ إلى الأسفل، وهذا خطأ يقعُ فيه الكثير من الملحّنين الهُواة، حيث يختارون جملاً موسيقيّةً تُخالف في دلالاتها الحالة العاطفيّة والمنطقيّة للنّص، فيخرج اللحن مقيّداً بسلسلةٍ حديديّةٍ تمنعُ هروبه من رفقة الكلمات. .
قالت العرب قديماً: “إنّ الحديث من القِرى”، وهذا القِرى يجب أن يعبّر عن كرَمِ المُضيف وجمال روحه وطيب أصله. ولذلك عاهدْتُ نفسي أن أغنّي ما أُريدُ قوله كلّما أمكنني ذلك، لأنّنا وببساطةٍ قاهرة: “محكومون بالغناء”.