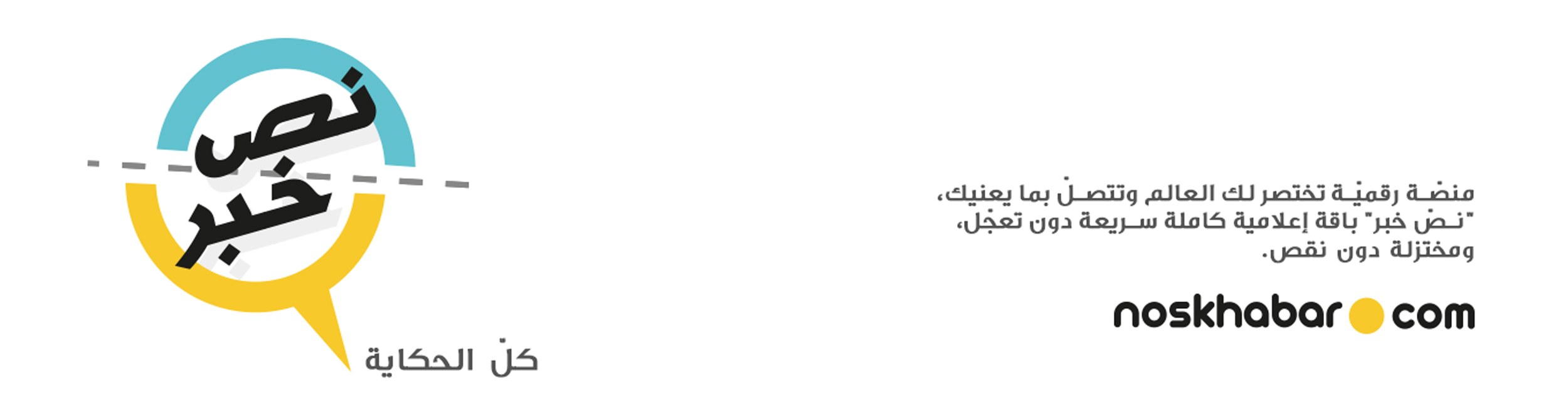نورما صبيرة – كاتبة سورية

عاشت الدراما السورية مرحلة ازدهار وانتشار في بداية التسعينيات وبلغت ذروتها في الفترة بين العامين 2000 و2007. كثرت العوامل التي أدت إلى ازدهارها كجودة النص والإخراج والأداء التمثيلي العالي، ولكن يمكننا إضافة سبب مهم آخر وهو غياب منافس حقيقي في فترة عانت فيها الدراما المصرية من مشاكل عدة.
في تلك الفترة عملت الدراما السورية على حلّ بعض من مشكلات الدراما المصرية في أعمالها، فخرجت من عباءة البطل الواحد وطرحت فكرة البطولة المشتركة واتجهت نصوصها إلى الواقعية التي أصبحت سمتها لاحقاً.
ولكن سرعان ما بدّد هذا الألق وهذه الحالة من الرفاهية الفكرية السورية ما حصل لها من أزمة سياسية وعسكرية والأهم الأزمة الاقتصادية التي عاشتها وتعيشها البلاد، وهو ما انعكس على الدراما التي باتت تجسّد حالات الشتات واليأس والحزن الذي عمّ المكان فجأة.
يكاد لا يختلف اثنان على تدني المستوى التي بدأت تعاني منه الدراما السورية بعد سنوات قليلة على اندلاع الأحداث في سوريا، ويكاد يتفق أي اثنين على المبررات المحقة لهذا التدني، فالحرب ثقيلة ولابد أن تلقي بوزها على جميع أبنائها.

بالرغم من ذلك لم أتوقف يوماً عن متابعتها، حتى تمكنت أخيراً من تكوين هذه النظرة العامة عن بعض مشكلات الدراما السورية الحالية، وتركز هذه النظرة على لب الحكاية: القصة والسيناريو.
قد يكون لأزمة النص التي تعيشها الدراما السورية عدة جوانب، وأعرض بعضها من وجهة نظري:
- أولاً، جمود المخيلة واتباع القوالب:
إن اتباع منهج الواقعية في الدراما السورية حدّ من أفق الكاتب وقيد مخيلته وأعطى نوعاً من النمطية في نماذجه المطروحة لأنه خشي ألا يتسم بالواقعية. حاول الكاتب السوري أن يخرج من هذه المشكلة لكنه رأى أن هناك قوالب معينة فرضها السوق (أو غيره) تقف في طريقه، ولم يكن هناك حل أمامه سوى العودة إلى الماضي، من خلال المسلسلات التاريخية.
أعني هنا بالمسلسلات التاريخية، ليس فقط المسلسلات التي تحكي عن تاريخ العرب في العصور الأموية والعباسية وغيرها، بل أي مسلسل يحكي في طياته قصة حدثت في حقبة ما ليست معاصرة. وأعني بالقوالب على سبيل المثال إعادة إحياء القصص الشعبية أو مسلسلات البيئة الشامية التي لاقت رواجاً ملفتاً في المنطقة العربية.
- ثانياً، افتقاد عنصر الترفيه:
هذه المشكلة أيضاً يمكن عزوها إلى التشبث بالواقعية، فقد كانت هذه السمة جيدة وساهمت في نجاح الدراما السورية سابقاً لأنها ركزت على التجارب الوجدانية، وعلينا ألا ننكر أنه في حينها كان الواقع بشكله العام جميلاً، وكان الخوض في مشكلاته رفاهية لم يعد الشارع السوري يمتلكها الآن. ففي الماضي كنا نشاهد ما نظنه يحدث على الشاشة فقط وكانت الدراما السورية صرخة في وجه ما كان قابعاً في النفوس.
اليوم وقد أصبح الواقع مراً وبعد أحداث توالت وتتوالى على سوريا منذ 12 عاماً -لم نتفق حتى على تسميتها فأصبحنا نشير إليها بـ “الأزمة السورية”- أصبح من غير الممتع تصوير الأزمة الحقيقية وهي “الأزمة الأخلاقية” التي تعصف بالبلاد على الشاشات.
- ثالثاً، عدم القدرة على مواكبة التطور:
منذ بداية “الأزمة السورية” يبدو وكأن الزمن توقف عند السوريين، فقد عصي عليهم حتى الآن استيعاب ما جرى ويجري في بلادهم. يمكنني القول إن سوريا أصبحت دولةً خارج الزمان، ففي الوقت الذي غيرت فيه جائحة كورونا وجه وشكل الأعمال عالمياً (وخاصة الترفيهية)، إلا أنها مرت مرور الكرام على سوريا وعلى الدراما السورية أيضاً على ما يبدو.
هناك تغيرات هائلة حدثت بعد كورونا في سوق الأعمال التلفزيونية، فقد نما هذا السوق نتيجة طلب هائل يزداد يوماً بعد يوم. والأهم أن طرق البث تغيرت واستفادت من الانترنت وتكنولوجياته وأمنت وصولاً سهلاً للغاية للمحتوى التلفزيوني، ولكن ليس أي وصول، بل إنه وصول مدروس وبقاعدة معلومات عريضة عن المشاهدين (فئاتهم العمرية وتفضيلاتهم) وهذا ما لم تستطع شاشات التلفاز التقليدية تقديمه، وقد أدى ذلك إلى طرح نمط جديد من المسلسلات ركزت على عنصر الترفيه وتحررت من قوالب عدة كعدد الحلقات والنوعية (فمثلاً لم يعد الرعب حكراً على الأفلام).
هذه المتغيرات لم تنعكس بعد في الدراما السورية، فمازال السوريين يتشبثون بمسلسل الثلاثين حلقة ويشطّون ويمطّون في قصصهم ليحققوا هذا المعيار الذي انهار في صناعات صديقة ومنافسة كالدراما المصرية. ونشهد بوضوح انهيار هذا المعيار في الدراما المصرية في رمضان 2023، فطرحت ببساطة شديدة مسلسلات الـ 15 حلقة الموزعة على نصفي رمضان.
- رابعاً، تراجع جودة النصوص حتى في الدراما الواقعية:
في محاولتها للحفاظ على سمتها، وقعت الدراما السورية في عدة مطبات لم تتمكن بسببها من الحفاظ على جودتها السابقة. أهمها محاولة النص التلفزيوني طرح عدة قضايا ملحة في مسلسل واحد، فقد كثرت خيوط الحكاية ولم ينجح الكاتب دائماً في جعلها مترابطة كفاية، وهذا بدوره أدى إلى مشكلتين رئيسيتين.
الأولى: فقدان الطرح لوزنه، أو لنقل لم تتساو الطروحات من حيث وزنها رغم تساويها في أهميتها أحياناً.
فمن غير المجدي طرح قضايا ملحة جداً في مجتمعاتنا العربية كالتطرف الديني مثلاً وما يتضمنه من مشكلات فكرية واجتماعية (كتعدد الزوجات وزواج القاصرات وجرائم الشرف…) كخطوط فرعية (أو بوزن ثانوي) في أحداث مسلسل ما.
المشكلة الثانية أن هذا الأسلوب من المعالجة الدرامية المكثفة لعدة قضايا ملحة لا يفقد القضية وزنها فحسب، بل يفقد الشخصيات ثقلها وعمقها ويحولها إلى شخصيات يصلح أن نسميها “كاركتورية” ذات بعد واحد. وأعتقد أن هذا قد يشكل معاناةً بالنسبة إلى الممثلين المحترفين الذين يتوقون إلى تقديم شخصيات مركبة.
وبالحديث هنا عن الممثلين المحترفين، دعونا لا ننسى أنه وبالرغم من المشكلات التي ذكرتها، إلا أن الدراما السورية لا زالت تحمل جوانب مضيئة عديدة، أهمها أن سوريا تمتلك قاعدة عريضة جداً من الممثلين المحترفين والموهوبين على صعيد الوطن العربي، وأن هناك معهد عالي للفنون المسرحية لم يتوقف يوماً عن تخريج دفعات شابة حافظت على ميزة الممثل السوري التنافسية وهي “الاحترافية”.
وهنا سأسمح لنفسي أن أتحدث بلسانهم، فإنني أرى أن أغلبهم يعانون بصمت، يعانون من شخصيات هزيلة لا توظف موهبتهم أو الأدوات التي اكتسبوها خلال دراستهم في العاصمة دمشق، عاصمة أبو خليل القباني ونواة المسرح العربي. أراهم يحولون هذه المعاناة الصامتة إلى أداءات استثنائية لشخصيات أعتقد أنها لا ترضي طموحاتهم، فيصنعون شيئاً من لا شيء. أود لو أنني أستطيع أن أصرخ نيابة عنهم: “أريد أبي كليب حيا”.
في الختام؛ يبدو أن الواقع التراجيدي للبلاد نجح في تحويل الدراما السورية إلى تراجيديا سورية، أخشى أن تتحول لاحقاً إلى تراجيديا ملحمية إن لم يسارع أحدهم إلى طرح حلول حقيقية لأسباب ومسببات أزمة النص الحالية والتي بدأت معاناة المنتجين منها تظهر بوضوح،
ففي رمضان 2023 طرحت شركة الصباح 3 مسلسلات سورية لبنانية اثنين منهما من سيناريو وحوار “ورشة الصباح للكتابة”.