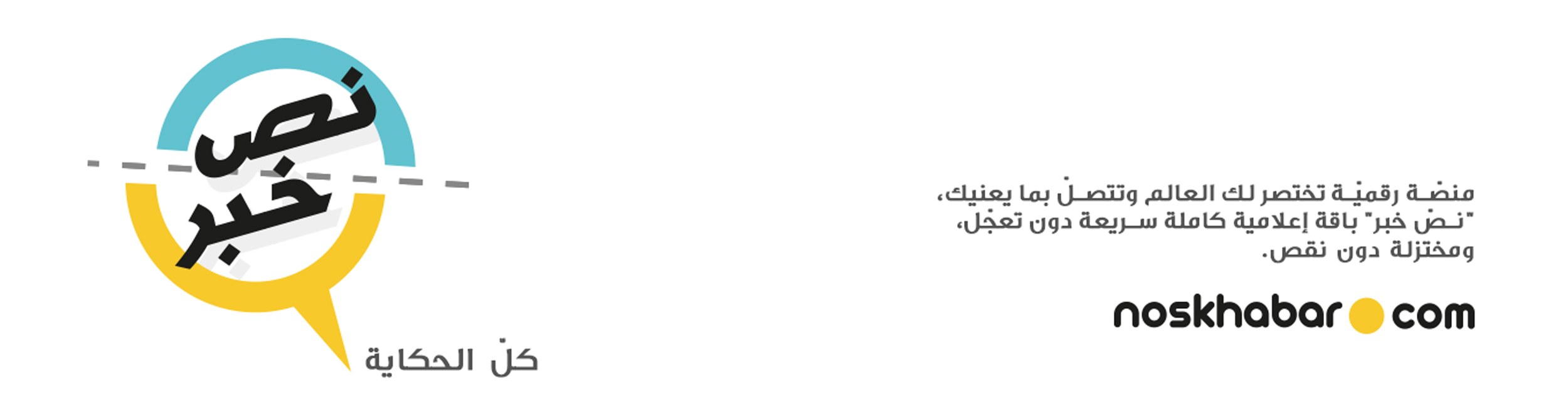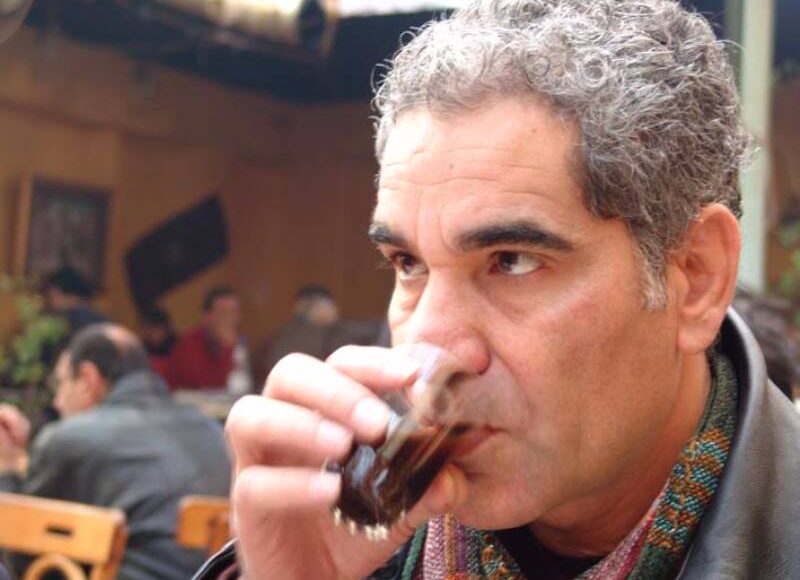بما يشبه الارتطام بزجاج باب غير مرئي، اصبتُ بدوخة طارئة، لحظة وقعتُ على قصة “المسجّلة” بتوقيع دينو بوزاتي، هذا الكائن المدهش الذي سبق أن نصبَ لي فخاً محكماً في روايته “صحراء التتار”.
أقول لنفسي: يا إلهي كيف بإمكان أحدهم أن يكتب قصة من 242 كلمة فقط، بمثل هذه الفتنة؟
سأجازف وأستعيد القصة كاملةً هنا، كي لا أفسدها بالشرح والتأويل: “قال لها بصوت منخفض جداً، توسّل إليها: أرجوك أن تصمتي، فالمسجلة تسجّل من المذياع، لا تحدثي ضجة فأنت تعلمين أني حريص على ذلك. كان يسجّل مقطوعة الملك / آرتورو / لبرسيل الرائعة الصافية، لكنها كانت تغدو و تروح كجيفة مزعجة لا مبالية مطقطقة بكعبي حذائها القاسيين لتستمتع فقط بإخراجه عن طوره، ومن ثم راحت ترفع صوتها ثم سعلت عن عمد، وبعدها صارت تضحك وحدها و تشعل عود ثقاب بشكل تحدث معه أكبر ضجة ممكنة. وبعدها أيضاً صارت تروح و تجيء بخطى رنّانة، وأثناء ذلك كان برسيل و موزار و باخ و بالسترينا الأنقياء الإلهيون يعزفون سدى. برغوثاً بائساً, قملة, قلق الحياة. ولم يكن بالإمكان الاستمرار على هذا النحو .
و الآن، وبعد انقضاء زمن طويل، ها هو يدير شريط التسجيل القديم المؤلم، وها هو المعلم يعود، برسيل، وباخ، ومـوزار، وبالسترينا. أما هي فلم تعد هنا، لقد رحلت, تخلت عنه، آثرت أن تتركه وهو لا يعرف ولو بشكل غامض إلى أين انتهت.
وما زال برسيــل وبــاخ وموزار وبالسترينا يعزفون و يعزفون، أولئك البلهاء الرجيمون الذين يثيرون الغثيان.
وتلك الطقطقة التي تــروح و تجــيء، وهذان الكعبان، و تلك الضحكـات القصيــــــرة، لا سيما الثانية، وبحة الحلق تلك، والسعال، أجل، إن كل هذا لهو موسيقى إلهية.
إنه يصغي. جالساً تحت ضوء المصباح يصغي. متحجراً في مقعده القديم المحطّم. يصغي دون أن يحرك أي طرف من أطرافه. يجلس منصتاً إلى تلك الضجة, إلى إيقاعات تلك الخطى, وذلك السعال، وتلك الأصوات المعبودة التي لا نظير لها والتي لم يعد لها وجود, ولن تكون هنا ثانية بعد الآن”.
بالفتنة نفسها، سأعيش مع سرديات أخرى مشابهة تخلو من الدهون الضارة، فعدا “صحراء التتار”، الرواية التي تفصح بعمق عن معنى حراسة الوهم في حصنٍ مهجور، ومراقبة مجيء البرابرة، من دون أي إشارة تؤكد ذلك، طوال أربعين عاماً من الانتظار. سنقع على روايات مشابهة راهنت على الكثافة لا البدانة، وباتت مرجعية سردية ملهمة مثل” البطء” لميلان كونديرا، و”الحمامة” لباتريك زوسكند، و”ليس لدى العقيد من يكاتبه” لغابرييل غارسيا ماركيز، و”بيت الحسناوات النائمات” لياسوناري كاوباتا، و “ساعي بريد نيرودا” لانطونيو سكارميتا، و”حرير” لأليساندرو باريكو، و”رجال في الشمس” لغسان كنفاني، و”صيادون في شارعٍ ضيّق” لجبرا إبراهيم جبرا، و”تلك الرائحة” لصنع الله إبراهيم ، و”الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل” لإميل حبيبي، إذ أخضعها مؤلفوها لأقصى حالات الاقتصاد اللغوي، باستثمار فضيلة الكتابة الشذرية التي اشتغل عليها موريس بلانشو نقدياً في كتابه” كتابة الفاجعة” باعتبارها مبضعاً حاداً لتشريح” التفسّخ و التفكّك، والاختلاف”،
بالإضافة إلى التحلّل من قواعد النسق لمصلحة الكثافة السردية كقوة تخريبية تنهض على التفلّت من المقاييس والقواعد الصارمة. يكمن التحدي إذاً، بالنسبة لروايات من هذا الطراز، في عمق التحديق إلى الداخل، وتأثيث المكان المغلق أو المعزول أو المهجور بمحاكمة طبقات الذات القلقة، وتعرية ما هو محتجب ومستتر قبلاً، بمكاشفات تطيح الاستقرار الداخلي للشخصية باهتزازات عنيفة تجاه الوحدة والألم والفقدان واللاطمأنينة.