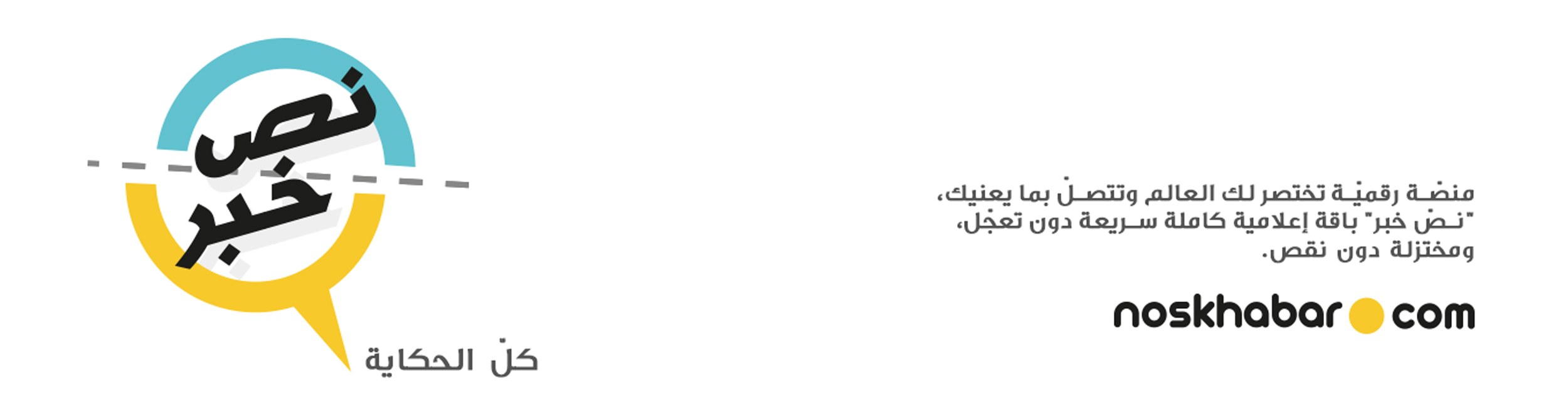27 مايو 2023
حاوره: هاني نديم
عرفته في البدايات حين كان ينمو “زغبي” الأدبي بينما كان هو يطير بجناحي نسر. علّمني وأنار لي فوانيس الطريق، صرنا أصدقاء طيلة إقامتي في سلطنة عمان، سنوات ونحن نلتقي يومياً وأنهل من شاعرية فريدة وعلم لغوي خاص، إلى جانب نقاشاتنا في شؤون الصحافة الشاسعة. إنه الشاعر العماني/العراقي/العربي، عبد الرزاق الربيعي بأكثر من 40 كتاباً وما لا يحصى من الجوائز والمقالات والبحوث.
سألته:
- *في الغربات منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، هل صبغ ذلك كتاباتك وهل الاغتراب شبهة تلاحق أصالة المنتج؟ كيف ترى الأمر؟
- الندم على ماذا؟ الخروج؟
- تقصد الأوطان؟
قصيدة النثر انفتاح على التاريخ العام والشخصي، والصيغ البلاغيةالجديدة، والالتفات للموسيقى الداخلية، وتجنّب التراكيب المستهلكة المستلة من الذاكرة الشعرية
- اخترت قصيدة النثر بم تفسر انحيازك لهذا الشكل، وما رأيك بقصائد النثر التي نقرأها اليوم؟
- فكرة الأجيال، هل تؤمن بها أدبيا؟
- هل تغير عليك بوصفك كاتبا مخضرما بين ثمانينات القرن وما بعد 2003؟
- ما قبل السوشال ميديا واليوم، كيف ترى تحولات المشهد؟
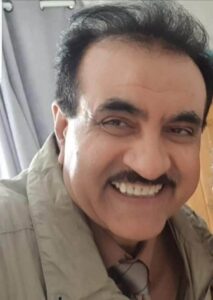
- لو أهدى لك أحدهم رواية كتبها الذكاء الإصطناعي، فهل تقرأها؟
- ماذا عن شعره؟
- لك صداقات ثقافية معمّرة، كيف حافظت على استمرارها؟
– أحتكم دائما في المسائل الكبرى للزمن، فهو غربال كبير، يصفّي ما يشكل عليّ، وكثيرا ما ابتلع الزمن صداقات طويلة، فبناء العلاقات الإنسانية يحتاج إلى وقت طويل، ومن يبني علاقة كمن ينثر بذورا بأرض محروثة، بعضها لايجد ظروف إنبات صالحة، فيموت وبعضها يستمر، والبعض الآخر يكبر ويثمر، وكثيرا ما يكون رهاني على الأخير، وبين حين وآخر، أقوم بمراجعات، فاطوي صفحات وأرمّم أخرى، وافتح صفحات جديدة، مهتديا بقول ابن الجوزي “رأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر، وإخوة مباطنين، فقلت: لا تصلح مقاطعتهم؛ إنما ينبغي أن تنقلهم من ديوان الأخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة، فإن لم يصلحوا لها، نقلتهم إلى جملة المعارف، وعاملتهم معاملة المعارف. وقلّة قليلة تبقى في خانة الأخوة، وهذه القلة تكفيني، فالعبرة ليست في الكثرة، بل في اليد الحانية التي تمتدّ إليك وسط هذه العتمة الوجودية المطبقة.
- وهل وجدتَ هذه اليد؟
– كثيرا، وآخرها يد الحبيبة والزوجة جمانة الطراونة التي أهديت لها ديواني الأخير” ننام ويحرسنا ليل أمس”الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين.