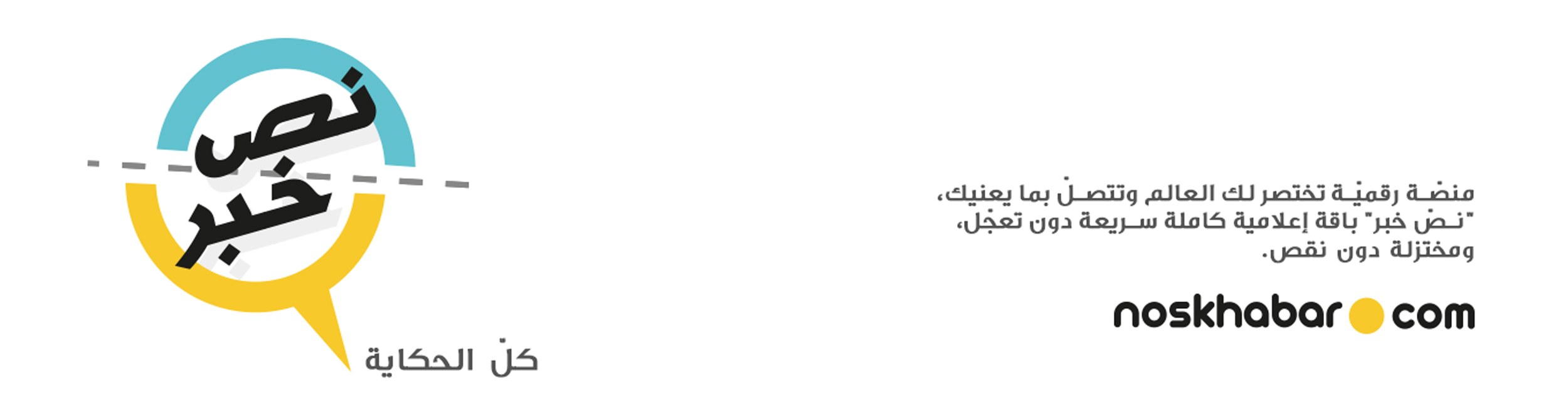9 يونيو 2023
شاعر تونسي مسكون بقلقٍ عاتٍ يكاد يعصف به قبل أن يعصف بالآخرين أو بالكتابة
ينقسم على نفسه وينقلب عليها ويلعنها آلاف المرات
لا ينفصل كثيرًا عن قصيدته كأنه تجسيد حي لها
له مجموعتان شعريتان: “مياه مؤجلة”
وقد حاز بها جائزة بيت الشعر التونسي سنة 2015 “لاشيء خارج الصفر” منشورة سنة 2020
كان معه هذا الحوار
أنور اليزيدي :تنتمي لجيل نما على انقاض مركزيات ضخمة من المقولات والتكتلات، كيف انعكس ذلك على المنتج الثقافي والإبداعي والمعرفي ؟! بأي طريقة يطرح الشاعر نفسه ونصه وسط غياب معياريات واضحة لتقييمه ؟!
هل مازال العالم يحتفي بالشاعر ويعتبره صرخة ضميره وعنوان شغفه للحق والخير والجمال !
الشاعر أنور اليزيدي كيف ترى هذه التساؤلات :
أنتمي إلى جيلٍ نشأ فوق سطوح ناطحات سحاب من الأوهام، أوهام شيّدها الجيل السابق وصدّقها بل وصدّرها إلينا عبر كتاباته الإبداعية والفكرية… حتى كاد يقتلنا بأوهامه، وهي ليست من طبيعة الأوهام النيتشوية المضادة للحقيقة القاتلة، وإنما هي أوهام سليلة المشاريع السياسية التي أثبت راهننا فشلها ، حتى معارضو تلك المشاريع لم ينجوا من خندق الوهم لأن أفكارهم انبنت لمحاربة ذلك الوهم فكان مبدعو الجيل السابق ومثقفوه دونكيشوتيين بامتياز .. ما يمكن اعتباره أملا أنّ في هذا الجيل الذي أنتمي إليه.
هنالك مَن استفاد على نحو صحي من المنتج الثقافي الموروث وذلك بالقطع مع السياسي والايديولوجي والغوص أكثر في الواقعي. ولعلّ اليوميّ في الأدب من أبرز ظلال هذا الغوص. ولعلّ عبقرية نجيب محفوظ وكذلك البشير خريف تكمن في كونهما قد سبقانا إلى الواقع كما سبقا جيلهما طبعا، فكانت كتابتهما ابنة شرعية للشارع فحوّلا اليوميّ إلى تراجيدي وصار أبطالهما على واقعيتهم وبساطتهم شخصيات أسطورية أيقونية.
أما الشعر فإن عباقرته في عصر الوهم لذلك ظلوا على الهامش، حتى الأسماء المكرسة، أعمالهم الأدبية التي “نزلوا” فيها إلى اليومي (وهو في الحقيقة صعود جمالي) ظلت مهمشة.
إننا سليلو الوهم، أبناء الدونكيشوتيين، لكننا زورباويون. أعتقد أننا خلعنا عنّا الوهم، ونحن الآن وجها لوجه مع اليأس العاري. ما توارثناه من أوهام خلّف في المشهد الثقافي التونسي والعربي عمومًا عللًا كثيرة وجراحا نسيانها أسهل من شفائها. ولعل أخطرها هو عدم اكتفاء الشاعر بنصه. واسمح لي هنا أن أشرح لأن للمعنى دلالتين على الأقل. إبداعيا، ألاّ يكتفي الشاعر بنصه فهذه حال صحية طبعا. الاطمئنان لما نكتب والاستكانة والرضا هي صفات الواصلين، والوصول في الكتابة انتهاء وموت. لكن، انطولوجيا، يعاني الشاعر من مفارقة غريبة، فهو يجد هويته في الكتابة لكنه لا يجدها بالكتابة. يحتاج الشاعر، أو هذا ما يفرضه الواقع المعلول، إلى أشياء اخرى من خارج النص، يمكن تكثيفها بالقول إنه مجبر على هوية متعدّية، هويّة غير قائمة بذاتها وإنما تشعر بالافتقار الى الآخر دوما، الآخر رئيس تحرير المجلة، الاخر الناشر، الاخر مدير المهرجان، الآخر المترجم، الآخر ابن خالة سائق وزير الثقافة، الآخر الناقد، الآخر الأكاديمي، الآخر الشاعر ذي الاسم الكبير…
بالنسبة إلي ليس لي ما أخسر سوى ما لم أقرأه بعد وما لم أكتبه الى الآن، لذلك لست مشغولا بتقديم نفسي ولا بالتسويق لنصي. وبالمنطق نفسه، من لم يقرأ لي فهو الخاسر. وبما أن كل المعايير قد امّحت، وأولها المعايير الجمالية، فإن المسألة قد باتت فردية بامتياز.
الشعر مسؤولية، وأنا أحاول أن أؤدّي واجب هذه المسؤولية على أجمل وجه، دون انتظارات تُذكر. ما الذي يمكن أن أنتظره من الشعر أكثر من أنه كانني فصرته. الشعر جعلني في غنى عن كل شيء، حتى عن الكلمات، إلا عن المال طبعا..
– لم يتوقف العالم للحظة عن احتياجه إلى الشعر، لكن دون أن يدرك ذلك. تصوّر، العالم واع بأن ضميره ولا شيء آخر هو الكفيل بإنقاذه، الغريب أنه لا يعرف من يكون هذا الضمير. لذلك لن تكفّ القصائد عن النباح، حتى يفهم العالم أن كلبه الوفي، صديقَه وحارسَه، دالَّه على الخير متشمما الحق والجمال، هو الشعر .