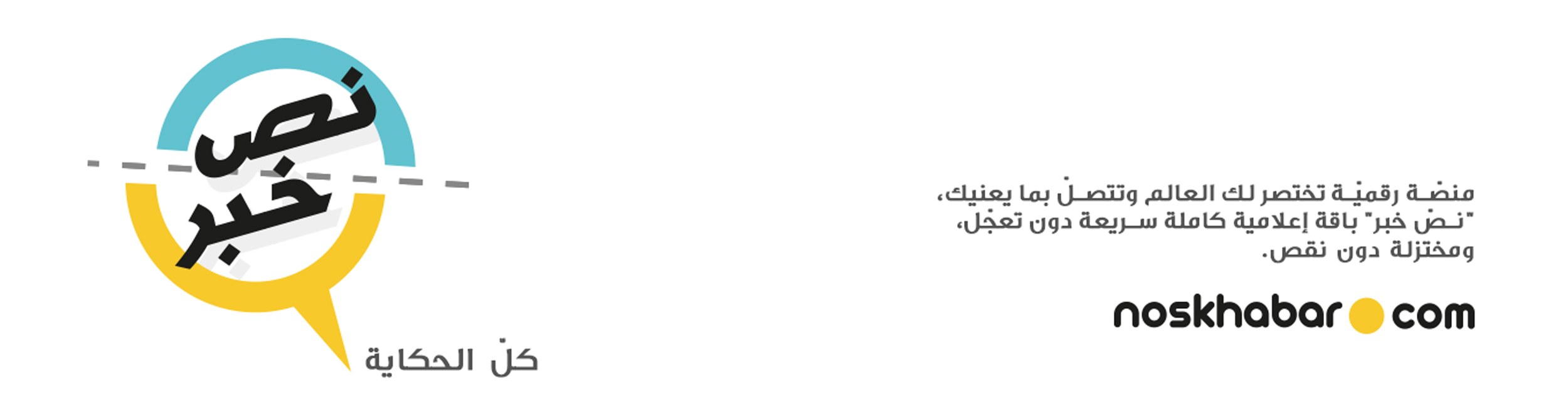19 يوليو 2023
حاوره: هاني نديم
ماجد موجد شاعرٌ عراقي يعيش في إيرلندا، مكان ما لقي الحفاوة منذ أول قصيدة ترجمت له، حاز على أكثر من جائزة ولفت نظر إعلام ومثقفي البلاد. كتبت عنه ذات يوم: “يأتي ماجد موجد من منطقة ضبابية إلى قصيدته، يدلف إليها بكل هدوء وتؤدة، لا يخلع الأبواب ولا يحدث جلبة، وهذا مقلق ومحفز وينبئ بعواصف لقرّاء الشعر القلقين كالعادة. يدخل بهدوء ثم سرعان ما يملأ كل التفاصيل والزوايا والهوامش ويدلك على أغراضك الضائعة في المنزل. يصبح رب المنزل”.
دردشت معه حول الهجرات والمنافي والحروب والخذلانات.. سألته:
- هاجرت باكراً، ما الذي وهبه لك المهجر وماذا أخذ منك؟ أتكلم أدبياً وإنسانيا وعلى كل الأصعدة؟
– دعني أقف عند الجملة الأولى هاجرت باكراً، في الواقع يا صديقي انها مرارة تملأ الحلق، فلم أهاجر إلا بعد أن استنفدت كل الأفكار التي يمكنها جعل الإنسان في داخلي يدرك حقيقة وجوده وقيمة هذا الوجود، هاجرت بعد شعور طاغ ويقين هو أنني لست بقادر على تقديم أي شيء آخر هناك يمكنه إسعاف (أمل حياتي) الذي تحطمت أطرافه ولم يعد قادراً على التنفس.
هذه وجه نظر من قضى أكثر من أربعين عاما في وطن الحرب، حرب تطحن ثم تلتهم، حرب على الحدود، وأخرى على الحرية الى حرب الجوع إلى حرب الشوارع إلى حرب الهوية، حرب.. حرب، يا إلهي ما أضعف هذه الكلمات التي أكتبها الآن وما أقلَّ جذوتها، حسنا كيف يمكن لي الآن في هذه المساحة أن أشرح الأسباب والدوافع التي تجعل شاعرا يترك وطنه وأهله وأصحابه سنوات طوال؟ أقول لك شيئا، يمكنك شطب هذه المقدمة ولنجعل الإجابة على الشطر الرئيس من سؤالك وهو ما الذي وهبه لي المهجر..؟ حسناً، أنا غادرت العراق مطلع العام 2010 أولاً الى مصر، مكثت في عاصمتها خمس سنوات فاتنات، حقيقة أقولها كانت أجمل السنوات وأكثرها حيوية وانغماساً في مناخ إنساني ثقافي أزاح عن كاهلي بعضاً من رعب القتال الطائفي الذي ملأ ذاكرتي بأقسى جرائمه وأكثرها بشاعة.
على الرغم من كل ما حققته هنا إلا أنني وبالحق كله أقول – بلادي وإن جارت…- نادم على قرار الهجرة.
لمصر جمال استثنائي ساحر رغم أنني شهدت بعض اضطراباتها، لكنها منحتني مرة أخرى وجهة نظر مبهجة في الحياة، أهدتني زهرة الحب ورمت في سلال الروح فاكهة، (ناضجة، حلوة وباردة). صحبة رائعة وعمل ثقافي استثنائي في مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، أصدرت هناك ديوانين من الشعر، ومع الأصدقاء أقمنا أكثر من مهرجان وملتقى شعري، بالفعل استطعت اصطحاب الأمل إلى فترة نقاهة حقيقية جعلتني أتنفّس فيها بعمق.
ثم وبقدرة قادر انتقلت إلى العيش في ايرلندا، وها أنا هنا منذ ثمان سنوات، ترى ما الذي يفعله الشاعر وهو يتلمّس بكل مشاعره بلداً مختلفا في كل شيء، أول الجمال هو الحرية، توقفت طويلاً أتأمل زهو الحرية برفقة الناس، إنها -الحرية- مشرقة ودافئة وقوية، غبار الشمس الذي يلهث على صدور الفتيات وبطونهن دون أن يعكر بريقه أحد، الهواء النقي الذي تنفخه أفئدة الأشجار وزجاج النوافذ الراقصة في ليالي الشغف وهياج الحانات.
أول ثلاث سنوات كنت فقط أسرحُ وأمرح، ثم سرعان ما قدمت جائحة كورونا وأوقفت غواية كل شيء وهناك عدت إلى التلفّت أمام الذات ومواجهتها، بدأت تدبُّ فكرة الهوية والانتماء وصخب الأسف على الغياب الطويل عن البلد، وها هي روح مقاومة عنف اليأس مرة أخرى تشدني للبحث عن منفذ آخر وها أنا أحاول أن أجده وكلما قلت هذا هو قالت نفسي لا أريده. على الرغم من كل ما حققته هنا إلا أنني وبالحق كله أقول – بلادي وإن جارت…- نادم على قرار الهجرة.

- مع وفرة الأسماء واضطراب المشهد الثقافي العربي، ما الحل لتنظيمه برأيكم وأنت على مسافة بعيدة عن الوطن؟
– وفرة الأسماء واضطراب المشهد الثقافي العربي ربما تكون عافية فيه وليست مشكلة لنجد لها حلا، وهذا الحال كما تعرف متواتر عن تاريخ الثقافة الإنسانية في كل مكان، لكن هل المقصود ان هناك مستوياتٍ ضعيفة للغاية من النتاج الأدبي تغزو سوق الثقافة؟ في المطلق لا أحد اليوم لديه القدرة على الوقوف بالضد من هذا السوق الذي صار يفتح أبوابه علينا بلا مواعيد أو خيارات متاحة، إنه في كل زاوية من الحياة حتى ونحن ننعم بدفء على أسرّتنا يمكن من خلال شاشة الهاتف أن تغرينا أبواب الدكاكين المشرعة بكل ما لا يخطر على البال والذائقة، حتى أتفه محتوى يمكن رؤيته، حتى أسوأ نص لا ننفك من أن نجرب قراءته دون فهم الدافع، لا أعرف ان كان في المستقبل من سيسعى إلى توفير آليات جديدة أكثر تنظيما يمكنها الفرز وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من معايير الجمال، أم أن الأمر سيزداد سوء وتطرفاً في محو كلِّ المعايير، ويغدو الحديث عن الغثِّ والسمين -حتى عن نصٍّ شعري- حديثا عنصريّاً نعاقب عليه.

- هل يقرأنا الأوروبي؟ هل هو مهتم حقاً بأدب عربي وشاعر عربي؟ كيف تصف العلاقة بيننا ثقافيا؟
-لا يمكنني أن أعطي وصفاً دقيقاً للعلاقة بين الأدب العربي والقارئ الأوربي، هذا موضوع واسع ومنافذه لا تعد، أنا أقول ذلك من موقع اقامتي في بلد منعزل مثل جزيرة ايرلندا، يمكن أن يفعل ذلك مثقف عربي عاش بشكل فعال وقار في المانيا أو فرنسا مثلا، ذلك أنَّ المناخ الثقافي هنا بسيط للغاية ولا يمكن من خلال فعاليات متناثرة وغير منتظمة أن أتعرف بشكل واضح ومقبول عن المستوى الثقافي الحالي لهذا البلد ومدى عمقه – لا أعني تأريخه الثقافي- وتأثره وتفاعله مع الثقافات الأخرى ومنها الثقافة العربية.
كنت أكتب الشعر في ظل كل الخراب والجوع والعنف والخوف
لكني رغم ذلك استطعت الفوز بجائزتين في الشعر وصدر لي ديوان باللغة الإنجليزية والعربية، وحصلت على اهتمام إعلامي لافت، من خلال بعض الأنشطة الثقافية التي أقيمت لي منحني فرصة في فهم القليل من حيثيات الثقافة الأيرلندية وتفاعلها مع الثقافة العربية – هذا ليس حكما عاما- مثلا في جلسة شعرية لي – بوصفي شاعراً عربيا- ذكر المقدم في ورقته اسم أدونيس بوصفه شاعراً عربياً معروفا لديهم وأما اسم محمود درويش فقد سمعته أكثر من مرة وفي عديدِ مناسبات، -وهذا متأتٍّ ربما من أن ايرلندا -شعبياً ورسمياً- لها موقف واضح ومساند للقضية الفلسطينية، بينما في جلسة أخرى التي قدمتني فيها إحدى الشاعرات -بوصفي شاعراً عراقياً – لم تجد في ذاكرتها عن ثقافة العراق ومنجزهِ الأدبي سوى حكايات ألف ليلة وليلة وملحمة جلجامش، تصور..!

- عن البدايات التي أحب أن أسأل عنها دوماً، ما الذي اختلف في هذه الرحلة الطويلة، ماذا سقط منك وماذا اكتسبت؟
– ما إنْ صرت انتبه الى لذّة الجمال وأنا في التاسعة من عمرى حتى بدأت الحرب الإيرانية العراقية وشطبت معها أيَّ مسار مرهف ومبهج في الحياة، عاش الناس من حولي ثمان سنوات من الفزع والدم واليتم وتصدع أي يقين في الخلاص، كتبت حينذاك قصائد شعبية ركيكة عن الله والجنود ومصاطب غسل الموتى، وفي ليلة استطعت أن أبكي من الحب وأنا في سنتي الخامس عشرة، وفي هذا السن تحديدا كتبت قصيدة غزل فصيحة موزونة ونشرت في جريدة اسمها الراصد، انتهت الحرب في العام 1988 وخلال سنتين من السلام المضطرب استطعت أن أتواصل مع بعض أدباء كربلاء، المدينة التي احتضنت طفولتي وصباي ووجهتي الثقافية، نشرت بعض القصائد في الصحف العراقية والعربية بمساعدة الشاعر الراحل هادي الربيعي كان هو الأستاذ والموجّه، لكن سرعان ما بدأت جهنم ثانية، حرب الخليج،- تحرير الكويت- هذه الحرب كانت الأعنف حينها لأنَّ جبهتها لم تكن على الحدود بل في كل شارع ومنزل، كل معلم صناعي أو طبي أو خدمي مسته نارها، في الريف أو على مقهى وسط المدينة، خرجنا مدججين بالخراب كله لتبدأ انتفاضة شعبية ضد النظام وأشارك فيها وأفقد عيني وأهرب خائفاً متخفياً بين المدن لمدة خمس سنوات، ثم بعدها أعلن النظام العفو ونجوت لأكتب الشعر واستمر خراب حياتي الحقيقي مثل كل العراقيين في حصار أممي جائر ومذل منذ العام 1990 حتى سقط نظام صدام 2003.

في ظل كل الخراب والجوع والعنف والخوف كنت أكتب الشعر وصدرت لي ما بين العام 1997 والعام 1999 ثلاثة دواوين حصل فيها ديواني الثاني (ما تساقط بل أوشك للشمس) في سنة صدوره على متابعة ودراسة من قبل عشرات من النقاد والكتاب قل نظيرها لديوان شعر مثله بين ذلك الجيل. إنه الشعر يمكنه أن يمشي متوهجاً برفقة الجزع والجوع، يتنفس عطرَ الحياة من أية فجوة رعب ويمكن لوردته أن تنبجس فوق هوة من الفقدان.