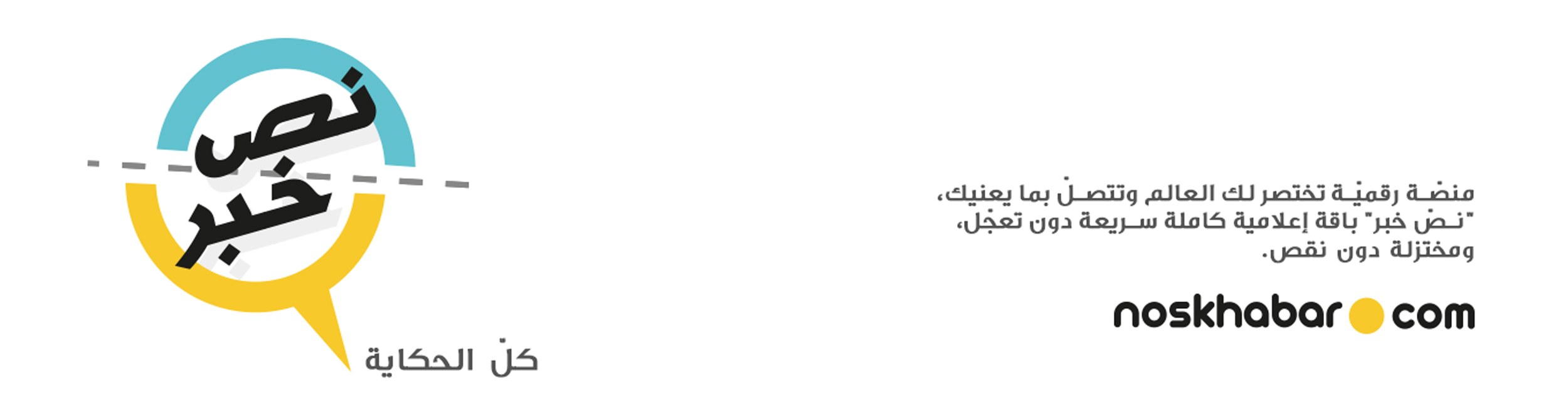22 يوليو 2023

ريم يونس – كاتبة سورية
يغريني الصمت، فأتبعه بحواسي، اترك لعيني مهمة تلمس المشهد.
أما لأذني فأترك تذوق الكلمات على مهلها، تنتقيان منها ما يصلح سماعه. اترك لهما مهمة فرز نفايات الحديث، وكلما كانت جودة كلمات المتحدث أقل زاد معها صمتي أمامه.
هذا الصمت الذي يركض أمامي كطفل أخذ لعبتي، فألحقه لأستردها؛ ولعبتي هي الكلمات! تلك التي أنتقي فساتينها بعناية، لا أقبل لكلماتي أن ترتدي إلا ثوباً محتشمًا طويلاً، لكن أطرافه مطرزة بالدانتيل، فيلامس الثوب الطويل أرض الحديث بخفة دون أن يُرهقها بثقله.
أركض من جديد وراء الصمت لأستعيد الكلمات، لكنني بعد كل ركضٍ أجدني أتمهّل أكثر لأخسر لعبتي عن قصد ويفوز صمتي علي. يأخذني الصمت إلى مساحة فارغة في كل لقاء مع شخص جديد أتعرف عليه للمرة الأولى. فأبقى ساكنةً استمع وأراقب.
رغم فتنتة الصمت قررتُ طرده
منذ أيام لم أدعه يسرق كلماتي ويهرب كعادته. وإنّما طردته على الفور ولم أنتظر سماع كل حديث المتكلم. دعيتُ إلى ورشة عمل ثقافية جمعت أشخاصاً من جنسيات متنوعة، إحدى المدعوات -بالخطأ- كانت ممن يُطلقون على أنفسهم ب” المؤثرين”، وأريدُ أن أُطلق عليهم اسم ” المؤثرين التجاريين” حتى لا نظلم المؤثرين أصحاب المحتوى القيم.
عرّفت تلك -المؤثرة- عن نفسها بجملة “يتابعني أكثر من خمس وعشرين ألف متابع على الانستغرام” حسناً؛ هل أصبح عدد المتابعين بديلاً عن التجربة التراكمية للشخص؟ بديلاً عن النجاح والفشل والنحت في صخر الحياة؟ هل بات رقم المتابعين معياراً لإحساس الإنسان أنه موجود؟ عندي عدد هائل من المتابعين إذن أنا موجود! أربع او خمس جُمل تحدثت بها، التقطت خلال عشر دقائق عشرات السيلفي وباستخدام كل أنواع الفلاتر، تلك التي تُظهر الشفاه والخدود منفوخة، وتُخفي التجاعيد لدرجة تختفي معها ملامح الوجه ولا يظل غير وجه أملس وأبله.
يقول الفيلسوف بيونغ شول هان عن صور السيلفي واستنساخ الفراغ: ” يشير التقاط صور السيلفي إلى الفراغ الداخلي للأنا. تحاول الأنا أن تبحث عن هوية مستقرة قوية في عصر لا يدوم فيه شيء. زعزعة استقرار الأنا والقلق المفرط وتشتت الذات ينتج عنه إدمان صور السيلفي، حيث تحاول الذات عبثاً إعادة إنتاج نفسها في كل مرة يتم فيها التقاط صورة جديدة.”.
المؤثر الذي يلعب دور صحفي عصري مُسبق الصنع!
لم أستطع أن أمنع فضولي من سؤال شخص يجلس بجانبي عنها وعن المحتوى الذي تقدمه، مع أنَّ ” المكتوب مبين من عنوانه” كما يقولون! صور وفيديوهات تعرض فيها جسدها وثيابها، ماذا أكلت وشربت، من أين تشتري فراشي التجميل التي تزيد أنواعها وأسماؤها عن الخمسين. تفتح اللايف يومياً لتصوير مغامراتها، تفاصيل خصوصيات حياتها وخصوصية الأماكن التي تتواجد فيها.
خطر لي أن أعتذر وأغادر المكان على الفور! لكني بقيت، “لن أدع الصمت يسرق لعبتي هذه المرة” قلتُ بنفسي. كان عليَّ أن أتكلم وأجعلها تتوقف عن التقاط صور المكان وفتح اللايف لعشرات الآلاف من المتابعين. لم أسمح لها بانتهاك خصوصية المكان وخصوصية وجودي فيه دون أخذ الإذن. إنه الدور الذي يحاول أن يظهر فيه المؤثر التجاري كمراسل أو كصحافي.
صحافي عصري مُسبق الصنع، تمَّ تصنيعه وتعليبه من محتوى منحرف وعدد هائل من المتابعين، بدون أساس معرفي أو تجارب حقيقية، بدون أدنى مستويات الذوق العام واللباقة. كيف سينجح المؤثرون التجاريون في بناء منظومة ثقافية أو حتى اجتماعية أو سياسية وهم يفتقرون إلى المهنية والاختصاص ولا يضعون لأنفسهم معايير مهنية تفرضها أساسيات ومبادئ العمل الصحفي؟
حاولتْ أن تدور على الحضور وتطرح عليهم أتفه الأسئلة التي لا علاقة لها بالحدث الثقافي الذي أتينا لأجله لا من قريب ولا من بعيد. بعد أقل من ساعة أعربت عن انزعاجها من عدم تجاوبنا معها لنقل هذا الحدث عبر فيديو لايف مباشر.
تحدثت بكلمات سوقية عن تخلّف بعض الحاضرين وعدم مواكبتهم لوسائل عصرية في نقل الأحداث وعدم إدراكنا لأهمية وجودها معنا. “حسناً، غادري وأغلقي باب التفاهة وراءك.” هكذا قال لها أحد الحاضرين.
ألم يحن الوقت لنقل لكل هذه العاهات “اصمتوا!”
أن نقول كفى لنعيق الغربان التي باتت تقدّم للصغير والكبير نصائح عن الحياة وهم لا يمتلكون الحد الأدنى من القيم الإنسانية. يفتحون لايف منابرهم ليتشدّقوا عن مبادئ الاتيكيت البرجوازية وهم لا يملكون الحد الأدنى من اللباقة والتهذيب.
أولئك الذين أصبحوا كُثر، تسلّقوا على أكتاف الشهرة من خلال فضيحة أو صور مبتذلة، من خلال تصوير مشهد ضحية أو من خلال عرض دورهم البطولي في حالة إنسانية خاصة.
لم يصلوا لهذا العدد من المتابعين من خلال إنجاز على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي، لم يقدموا أي إضافة علمية أو ينجزوا ولو سلوكاً إنسانيًا مبهرًا. المُنجز كان باختصار عبارة عن استغلال ظرف شخصي أو عام لخدمة غرض التسلق ثم الكسب بدون عمل حقيقي.
ونتساءل كيف وصلنا إلى زمن تلويث الذوق العام وسمحنا لهذه الفئة بسحب عقول الصغار والكبار؟
هناك منظومة متكاملة تقف وراء هذه الفوضى وهذا الضجيج، منظومة رأس المال الذي ينهش ثقافات الشعوب، تاريخها وهوياتها الأصيلة، إنهم بحاجة إلى شعوب لا تفكر، شعوب مسلوبة القرار مُفرّغة من الهوية والانتماء. المؤثر يقرر عن متابعينه ماذا يأكلون ويلبسون وبأي الألفاظ يتحدثون وأي المواضيع عليها أن تشغل بالهم.
منظومة تريد قطعاناً بلهاء أمام شاشات الموبايل، أمام صور وفيديوهات مُغرقة بالخصوصية، ولا أبالغ إذا قلت أن حسابات كثير من المؤثرين/ات التجاريين تصلح لتكون معرض صور بورنو. اللعب على غرائز المتابعين، أولئك الذين يشكل المراهقون منهم أكثر من النصف، كل ذلك يخدم تسويق منتجات الشركات الرأسمالية التي تتجه لنشر ثقافة الاستهلاك وتدمير منظومة القيم، ونشر ثقافة “اشتر ولا تفكر، نحن نقرر عنك” لأن غير ذلك لن يضمن ديمومتها وعدم انهيارها.
هذه الفوضى ليست إلا شكلًا من أشكال إقصاء القامات العلمية والثقافية والوطنية من المشهد العام، فتح الباب ومنح المنابر لمؤثر يفتح اللايف ليبث نفايات الكلام وشذوذ الأفكار.
في كل مرة نضغط فيها على زر متابعة هؤلاء المؤثرين السطحيين، في كل مرة نكتب تعليقًا على صورهم وفيديوهاتهم ونشاركها على صفحاتنا، نصبح شركاء أساسيين لهذه الفوضى
ألا يعتبر الصمت عن كل هذا الهرج الصدىء مشاركة علنية بالتفاهة؟
أليس واجبنا الأخلاقي الآن قتل صمتنا أمام غول موجة التفاهة، وإسكات أفواه الوقاحة؟ في كل مرة نضغط فيها على زر متابعة هؤلاء المؤثرين السطحيين، في كل مرة نكتب تعليقًا على صورهم وفيديوهاتهم ونشاركها على صفحاتنا، نصبح شركاء أساسيين لهذه الفوضى. ما يثير العجب قيام كثير من المنصات الإعلامية المحلية منها والعالمية بالترويج لأخبار المؤثرين التجاريين، بتنا نجد أخبارهم تتصدر الصحف والمواقع الالكترونية. ألا تساهم هذه القنوات – وكثير منها لها تاريخ طويل في الصحافة- بتعويم ثقافة التفاهة واستخدامها لإلهاء الناس عن القضايا الكبرى؟ عن حرف الناس عن همومها اليومية من جوع ومرض وإهانة يومية لكرامة الناس في أوطانها؟ والنتيجة التي تحققها هي سحب مستوى تفكير الشباب إلى مزيد من التشتت والضياع، فتضيع الأوطان حبة زيادة!
أعتقد أن كثير من المنصات والصحف باتت لا تختلف عن ثرثرة جارات الحي عندما تنقل أخبار المؤثرين التجاريين.
في عصر المعايير المغلوطة، واجبنا الأخلاقي أن نحارب الصمت!
أن نقف ونصرخ بصوت عال ونمنع كل هذا الضجيج الصدىء بكلام يبني ما تهدم من منظومة القيم.
أن نحكي ونكتب ونعبر ولا نسمح لهذا الدوّ المرعب من التفاهات بالانتشار،
أن نسحب الميكروفونات من أمامهم ونعيد تشكيل المنابر ونُنزل من عليها من اعتلاها بشذوذه وانحطاطه.
الصمت الذي طالما فتنني، الذي طالما كان فعلاً عفويًا أمام الجمال، الذي كان زينة الكلام، أصبح الآن أمام ما نشهد بروازاً للوحة القباحة!